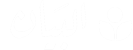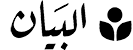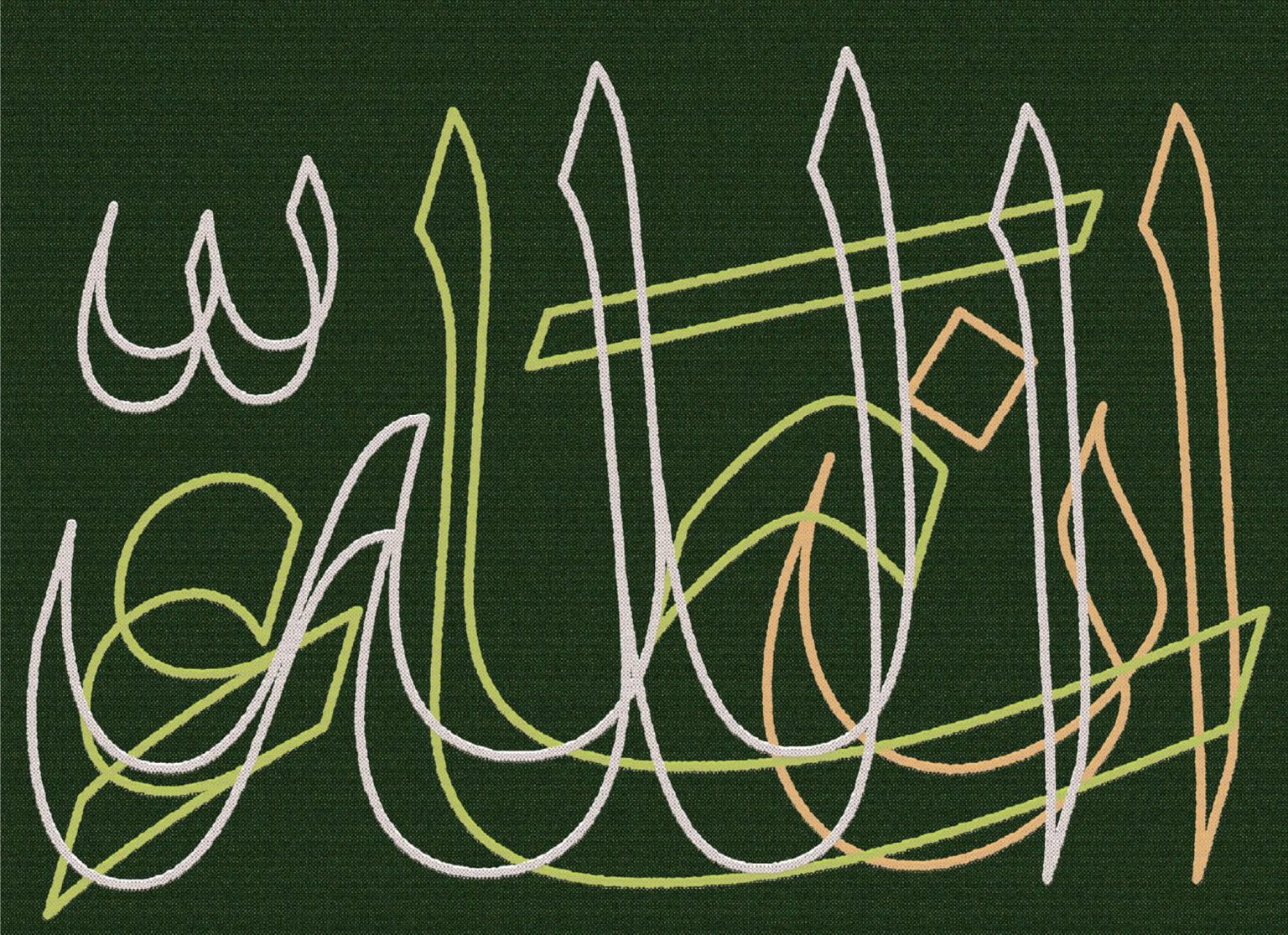إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد: فقد عانت الأمة الإسلامية بعد سقوط الدولة العثمانية من تسلُّط أنظمة مستبدَّةٍ صادرت حقوق الشعوب في اختيار حكامها والرقابة عليهم، وحاولت طمس هويتها باستجلاب أنظمة حكم من الشرق والغرب، فقُطعت الأمة عن تاريخها، واتُهمت في صلاحية دينها في مجاراة تطور العصر وإيجاد الحلول لمشكلاته. فظهرت -نتيجة لذلك- حركةٌ علميةٌ في دراسات السياسة الشرعية؛ تهدف إلى إيجاد حلول للواقع الذي تعيشه الأمة، انطلاقًا من الأصول الراسخة لهذا العلم، وتطبيقاته الحادثة القابلة للاجتهاد والنظر، كما اقتحمت العديد من المؤسسات والجماعات غمار المعترك السياسي، على اختلاف اجتهاداتها ونتائجها.
في مقابل ذلك، برزت جماعات الغلو رافعةً شعار استرجاع الحكم الإسلامي عبر عشرات التجارب، ابتدأت بأفكار متناثرة، وانتهت بمناهج شذَّت بها عن طريقة أهل العلم في شتى مسائل الفكر، والعقيدة، والفقه، والسياسة الشرعية، وغَلت في أحكام التكفير والتبديع، وانطلقت منها في أعمال القتل والتفجير التي لم تقتصر على الحكومات التي قامت هذه الجماعات بالأساس لإسقاطها حسب ادعائها، بل امتدت إلى عموم الجماعات الإسلامية والشعوب بذرائع شتى، وتهم متنوعة. فما أفكار هذه الجماعات في مشروع إقامتها للدولة الإسلامية؟ وما تطبيقاتها العملية لتحقيق ذلك؟ وهل كانت تصوراتها نابعةً من أصولٍ ثابتة وقواعد محكمة في العقيدة والسياسة الشرعية؟
في هذا البحث: إسهام في تقديم إجابات عن هذه الأسئلة من خلال تسليط الضوء على أفكار هذه الجماعات في مشروعها لإقامة الدولة الإسلامية، وما يتعلق به من أحكام وتطبيقات عقدية وفقهية متنوعة. وقد جاء هذا البحث في ثلاثة مباحث:
التمهيد: أسس إقامة الدولة في الإسلام.
المبحث الأول: أسس إقامة الدولة عند الغلاة.
المبحث الثاني: مبررات العنف المرتبطة بإقامة الدولة عند الغلاة.
المبحث الثالث: نقد مبررات العنف عند الغلاة المرتبطة بإقامة الدولة.
وقد اتبعت فيه المنهجية التالية:
1- الاقتصار على ذكر رؤوس المسائل دون تفريعاتها وتفاصيل اختلاف جماعات الغلاة في تأصيلها وتطبيقها.
2- توثيق ما أورده من مصادر هذه الجماعات، مع الاقتصار على عددٍ من النماذج للاختصار.
3- التعريف بالشخصيات غير المشهورة قدر المستطاع؛ لما يغلب على رموزها من الغموض والجهالة؛ نظرًا لما تتبعه تلك الجماعات من السرية.
4- تخصيص الإشارة للواقع السوري كونه التجربة القائمة حاليًا، واطلاع الباحث على حيثياتها عن قرب، مع محاولة التنويع في ضرب الأمثلة من التجارب الأخرى ما أمكن.
ولأنَّ الحديث عن الغلو في العصر الحديث متشعب؛ لذا لا بد من هذه التوضيحات بين يدي البحث:
أولًا: من المسلَّم به أنَّ جماعات الغلو المعاصرة تختلف فيما بينها في الأفكار والمعتقدات وكيفية تطبيقها، وقد يصل الاختلاف إلى التكفير، والقتال، ومع ذلك فإنَّ الأصول الفكرية لهذه الجماعات واحدة، والاختلافات التي تقع بينها منشؤها اختلاف وجهات النظر ضمن هذه المبادئ، وهو راجعٌ إلى طبيعة فكر الغلو وما يحمله في طياته من التشظِّي وكثرة الاختلاف وادعاء احتكار الحق، ووهي سنة الغلاة منذ القدم.
لذا فإنَّ البحث سيكون عن هذه الأصول العامة، دون الخوض في تفاصيل الأفكار والتطبيقات، ويخص منها مشروع القاعدة؛ لأنَّ غالبية الجماعات الأخرى قد ذابت في التنظيم أو اندمجت معه أو حملت مشروعه من خلال التأثُّر والتأثير المتبادل، وبيعة العديد من زعامات التنظيمات الأخرى للقاعدة، كالظواهري أمير “تنظيم الجهاد”، ورفاعي سرور أمير “الجماعة الإسلامية”، وأبو الليث الليبي زعيم “الجماعة الليبية المقاتلة”.
كما سيكون هناك توضيح لمشروع “إدارة التوحش” الذي استقر عليه مشروع القاعدة حاليًا، دون الإشارة لما يتعلق بإعلان تنظيم (الدولة) للخلافة لكثرة ما صدر حولها من ردود وتوضيحات؛ (1) ولأنه مع مخالفة تنظيم (الدولة) تنظيم القاعدة في الخطوة النهائية في المشروع إلا أنها لا تخرج عن أصولها الفكرية والشرعية كما سيأتي توضيحه في ثنايا البحث.
ثانيًا: قد توجد خلافات بين شخصيات الغلاة في الأفكار أو المعتقدات حتى داخل الجماعة الواحدة، وكل هذا لا تأثير له في الحكم على المنهج العام.
ففي حين ينكر البعض نسبة مواقف وأفكار شخصيات لتنظيم القاعدة استدلالًا ببعض تصريحات زعمائها، كنفي عطية الله الليبي أن يكون عصام البرقاوي (أبو محمد المقدسي) من منظري الفكر (الجهادي) أو قادته، (2) نجد أنَّ زعيم القاعدة الحالي أيمن الظواهري قد قرَّر إمامة كل من البرقاوي وعمر محمود (أبو قتادة الفلسطيني)، (3) كما زكَّتهما مختلف فروع القاعدة وشهدت بإمامتهما وقيادتهما الشرعية، وسيتضح في ثنايا البحث مدى اتساق منهجهما مع منهج بقية منظري جماعات الغلو، مما يدل على أنهم يغرفون من المستنقع نفسه.
ثالثًا: اعتادت جماعات الغلاة المعاصرة إعادة تشكيل تنظيماتها تحت أسماء مختلفة بغية التمويه في معتقداتها ومرجعيتها، والتخلص من تاريخها، وإيهام الآخرين بتطورها؛ مما يجعلها تُقدِّم نفسها على أنها الأكبر حجمًا، وبالتالي فهي الأولى بانضمام الآخرين لها ومبايعتها، وقد ظهر هذا جليًا في تجربتي القاعدة في العراق وسورية. ففي العراق: ظهر تنظيم التوحيد والجهاد، والذي تغير إلى تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، ثم مجلس شورى المجاهدين، ثم دولة العراق الإسلامية، انتهاء بالدولة الإسلامية وإعلان الخلافة. (4) وفي سورية: ظهر تنظيم جبهة النصرة، ثم استعلنت بانتمائها للقاعدة وأصبح اسمها: جبهة النصرة-تنظيم القاعدة في بلاد الشام، ثم دخلت في تحالف “جيش الفتح”، و”جيش الفسطاط”، ثم تغيرت إلى جبهة فتح الشام، ثم هيئة تحرير الشام. ولا تعدو أن تكون هذه التغييرات شكلية؛ لذا فإنَّ البحث سيشير إليها جميعًا بحقيقتها الصلبة وهي “تنظيم القاعدة”.
وفي الختام أتقدم بالشكر للقائمين على هذا المشروع البحثي (5) على إتاحة الفرصة لتقديم هذا البحث ومناقشته ضمن (مشروع مواجهة الغلو وخطر الحرب على الإرهاب في شمال أفريقيا وغرب آسيا والساحل) الذي رعته، والشكر لسائر الأساتذة والمشايخ المشاركين في جلسات النقاش على ما أبدوه من مقترحات وملحوظات أسهمت في إنضاج البحث وعمقه، وشكر خاص للدكتور عبد الفتاح ماضي المشرف على المشروع على ما بذله من جهود لإنجاح المشروع وإخراج الأبحاث بشكلها النهائي. أسأله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، والحمد لله رب العالمين.
التمهيد: أسس إقامة الدولة عند الغلاة
تختلف أسس إقامة الدولة عند الغلاة عما هو مستقر في الشريعة وكلام أهل العلم، ابتداءً ممن يعهد له إقامة الدولة، مرورًا بأسس إقامة الدولة، وانتهاءً بخطوات مشروع إقامة الدولة، كما سيأتي بيانه.
أولًا: مكانة الدولة من الدين عند الغلاة:
تحتل مسألة (إقامة الدولة الإسلامية) مكانة كبيرة في فكر جماعات الغلو، مما أدى إلى جعلها مشروعهم الأهم، وثمرة عملهم المنتظر، يسعون إليها في جميع كياناتهم؛ حماية لـ “ثمرة جهادهم” (6) من الضياع أو السرقة؛ لذا فإنَّهم يعدون إقامتها جزءًا من الدين الذي يجوز التفريط فيه. قال محمد عبد السلام فرج: “أجمع المسلمون على فرضية إقامة الخلافة الإسلامية وإعلان الخلافة يعتمد على وجود النواة وهي الدولة الإسلامية”. (7) وخصَّص سيد إمام مبحثًا كاملًا في كتابه “العمدة” بعنوان: الإمارة واجبة، وساق فيه الأدلة على ذلك. وقال محارب الجبوري المتحدث الرسمي باسم قاعدة العراق (دولة العراق الإسلامية): “أصبح من واجبات المرحلة أن يعلن إخوانكم في مجلس شورى دولة العراق الإسلامية عن تشكيلة وزارية لأول حكومة إسلامية تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله وتجاهد في سبيله لتُحكّم شرعه بعد عشرات السنين من سقوط خلافة الإسلام وضياعها”. (8) ثم أصبح هذا الهاجس مولِّدًا للعديد من أفكار هذه الجماعات وحاكمًا على تصرفاتها، ومن ذلك:
1- إقامة إمارات ودويلاتٍ ناقصة، وتحت جناح الاحتلال:
فعندما أرادت جماعات الغلو إقامة دولتها اصطدمت بوجود دولٍ قائمة، فعمدت إلى تغيير مفهوم الدولة ليتناسب مع واقعها، مما يمكنها من إعلان دولتها، فلم يشترط الغلاة لإقامة الدولة إلا مجرد وجود جماعتهم في مكان ما على الأرض، ولو كان هذا المكان بقعة صغيرة من الأرض كمسجد، أو غرفة في بناء، أو زاويةً في سجن، (9) وسواء كان ذلك في بلدٍ محتلٍ كالعراق، أو لم يكتمل تحريره كما في سورية. وقد جمعت الكلمة الطويلة لأبي حمزة المهاجر عن (الدولة النبوية) خلاصة هذه الأفكار، ومما ورد فيها:
– وصف الدولة النبوية بالاضطراب الأمني، وأنه يشابه حال المناطق التي أعلنوا فيها إقامة دولتهم.
– جعل مساحة المدينة النبوية وعدد بيوتها وسكانها وجيشها مقياسًا لإقامة الدول والإمارات، والاستدلال به على إمكانية إطلاق اسم الدولة أو الإمارة على مجموعة مبان أو مناطق محدودة بمجرد الاستيلاء عليها.
وللظواهري كلام قريب من هذا دفاعًا عن إعلان (دولة العراق الإسلامية). (10) وفي هذا يقول عمر محمود (أبو قتادة الفلسطيني): “لا يمكن أن يجاب عن شكل الدولة الإسلامية إلا بعد أن نلغي مفهوم الدولة في حسنا النفسي … الدولة الإسلامية في ظل مفهوم الدولة المعاصرة مستحيلة جدًا، إذًا، ماذا نفعل؟ … ننشئ دارًا ليست صلبة واضحة يمكن للخصم كسرها … يعني أشبه بحال قادتها ورجالها: مجاهدون، تتحرك ظهورًا وخفاء بحسب المتغيرات، يمكن أن نحكم ليلًا ونختفي نهارًا”. (11)
2- تسخير الجهود لإقامة دولتها وأخذ البيعات لها:
لما كانت غاية هذه الجماعات إقامة الدولة؛ فقد سخّرت جهدها وإمكانياتها لجمع البيعات، وحوت مراجعها الشرعية وفتاواها على حديث كثير عن حكم البيعات ونقضها، والحث عليها. ففي العراق: انصب جهد تنظيم القاعدة على دعوة الجماعات الأخرى لبيعة كياناته المختلفة، فطلب أبو حمزة المهاجر من المجاهدين مباركة دولة العراق الإسلامية ومبايعة أميرها. (12) وتباهى أبو عمر البغدادي ببيعة عشرات الكتائب وآلاف المقاتلين من سائر الكتائب لدولته. (13) وفي سورية: كان من أوائل ما قام به الجولاني حين دخوله إلى سورية: مطالبة القائدين زهران علوش وعبد الله الحموي ببيعته، كونه الأصلح للقيادة لانتمائه لتنظيم القاعدة! وجاء في بيان تأسيس (هيئة تحرير الشام) آخر تشكيلاتهم في سورية: “إننا ندعو جميع الفصائل العاملة في الساحة لإتمام هذا العقد والالتحاق بهذا الكيان جمعًا للكلمة وحفظًا لمكتسبات الثورة والجهاد”.
وقد رافق هذه الدعوة الإيهام أنهم الأكثر عددًا وتمثيلًا، وأن مشروعهم مشروع أمة واحدة، اجتمعت عليه قلوب الملايين، وتخندق في خندقه من يبغي الخير لأهله وبلده، وأن الهيئة تشكل ثلثي الطاقة العسكرية في الهجوم والدفاع تقريبًا، وأنها ترابط على أبرز النقاط الساخنة مع النظام النصيري والميليشيات الطائفية. وهذا خلاف الواقع، وقد ظهر زيفه وبطلانه.
3- قتال الجماعات الأخرى التي رفضت الدخول تحت حكمها تحت دعاوى مختلفة:
تنظر هذه الجماعات لنفسها على أنها الجماعة الحق الواجبة الاتباع، فكل من رفض بيعتها والدخول تحت حكمها فقد تخلى عن البيعة الواجبة عليه، ونكص عن إقامة دولة الإسلام، وبالتالي فهو عميلٌ لمشاريع أجنبية معادية للدين، وحكمه بين الفساد والردَّة، ومصيره القتال بعد التدرج بدعوته إلى البيعة، ثم تحذيره من الوقوع في المشاريع الخيانية، ثم اتهامه بالردة والخيانة. والمتتبع لبيانات قادة القاعدة في العراق يدرك حجم التخوين والتكفير لجميع المخالفين من الجماعات والعلماء والدعاة، إلى أن وصل الحال بأبي عمر البغدادي أن يصف ما وصل إليه حال سائر المخالفين له بأنه ردة جماعية، وأن قتل المرتد منهم أحبُّ إليه من مئة رأس صليبية. (14) وجاء في بيان القاعدة في سورية توضيحًا لما قامت به من اعتداءات على الفصائل قبيل إعلان تشكيلها الجديد “هيئة تحرير الشام”؛ أن هدفها هو إفشال ما سموه “مشاريع المصالحة والهدن” التي تحاول حرف مسار الثورة نحو المصالحة مع النظام المجرم وتسليمه البلاد. ومثله أيضًا ما وقع من (حركة الشباب المجاهدين) في الصومال: حيث إنَّها كفَّرت “المحاكم الإسلامية” التي انشقت عنها، وأعملت في زعمائها وأعضائها القتل والاغتيال. (15)
ثانيًا: مَنْ يعهد له إقامة الدولة عند الغلاة:
تنطلق جماعات الغلاة من الطعن في عامة الشعوب المسلمة، فتراها جاهلة ضالة، ساقطة العدالة، لا تملك الأهلية لإقامة الدولة أو اختيار الحاكم، فضًلا عن حمل المشروع الإسلامي، وقد كانت بدايات هذه الجماعات ما بين مُكفرٍ للشعوب أو متوقف فيها. (16) ومع تراجع التكفير العام -لشذوذه ووضوح انحرافه- إلا أنَّ التجهيل والتضليل بقي هو السائد في أفكار هذه الجماعات، فلا يرون في الشعوب إلا مخزونًا بشريًا يرفد مشروعهم بالكوادر اللازمة، ثم يكون الأرضية التي تُطبق عليها مشاريعهم وأحكامهم.
قال عمر محمود (أبو قتادة الفلسطيني): “مَن قال إن الأمة ليست ضالة؟! يعني، الذي يظن أن الأمة على الخير والبركة، فهذا خبيث النفس، أو أنه عميلٌ مأجور”. (17) وقال أبو بكر ناجي: “عندما نقول إن الشعوب هي الرقم الصعب ليس معناه أننا نعوِّل عليها حركتنا، فنحن نعلم أنه لا يُعوَّل عليها في الجملة بسبب ما أحدث الطواغيت في بنيتها، وأنه لا صلاح للعامة إلا بعد الفتح! ومن لا يستجيب من العوام ومتوقع أن يكونوا هم الكثرة، فدور السياسة الإعلامية الحصول على تعاطفهم، أو تحييدهم على الأقل”. (18)
إذا من الذي يقيم الدولة؟ تقوم عقيدة جماعات الغلو على حصر الحق في جماعتهم، مع إسباغ صفات (الطائفة المنصورة، والناجية، والسليمة من الانحراف، وأهل الحق، والمهتدية)، وأنه في عهدهم سيخرج المهدي، وتُعاد الخلافة، وتقع فتوحات آخر الزمان، لذلك هم الأحق بقيادة الأمة، وفيهم ينحصر أهل الحل والعقد. لذا فإن التأكيد على وجود (جماعة الحق) داخل المجتمع وصناعتها والحفاظ على صفائها ونقائها من الاختلاط بغيرها يأخذ حيزًا كبيرًا من عمل هذه الجماعات، وتقعيدها شرعيًا. قال سيد إمام: “فطريق الجهاد يبدأ بتكوين جماعة من المؤمنين بوجوب الجهاد، يدعون غيرهم للقيام بهذا الواجب… ويُعِدُّونَ للأمر عُدَّته على خير وجهٍ مستطاع”. (19، 20) بل إنهم قد عينوا هذه الجماعة بالاسم: قال أبو بكر ناجي بعد أن ذم جميع التيارات والجماعات الإسلامية: “أما تيار (السلفية الجهادية) فهو التيار الذي أحسبه وضع منهجًا ومشروعًا شاملًا السنن الشرعية والسنن الكونية”. (21) وقال عمر محمود (أبو قتادة الفلسطيني): ” أما الجماعات المجاهدة فهي أهدى سبيلًا وأقوم قيلًا”. (22) ثم أنزل هذه المواصفات والأحكام على تنظيم القاعدة فقال: “هذه الجماعة هي الأقدر في هذا الظرف على حمل أمانة الجهاد دون غيرها… جهادًا يحرر المسلم كل المسلم، من الطاغوت كل الطاغوت”. (23) وهذا ما فعله البرقاوي (أبو محمد المقدسي) في تسمية القاعدة بـ (أهل الجهاد) والحث على بيعتهم والطعن بكل من خالفهم في مختلف بياناته وفتاواه.
وفي شأن الخلافة والمهدي، فقد بشَّر بذلك سيد إمام في كتاباته، (24) وادعى شكري مصطفى أمير (جماعة المسلمين) أنه المهدي المنتظر، (25) كما ادعى ذلك جهيمان في قريبه محمد بن عبد الله في حادثة الحرم المكي المشهورة. وجزم أبو عمر البغدادي في رمضان 1427هـ بأنَّ المهدي سيظهر في أقل من عام، وأمر بأن يصنع له منبر ليرتقيه في المسجد الأقصى. (26) وقال الجولاني لجنوده في شريطه المسرَّب: “نسعى لإقامة إمارة إسلامية شرعية على منهاج النبوة… هناك جيش سيدخل إلى الأقصى ويقاتل اليهود… فاسألوا الله عز وجل أن تكونوا من ضمن هذا الجيش”. (27)
وبناءً على ذلك فهم المرجعية الوحيدة الشرعية في الساحة:
– فيرون أنَّ التحاكم للشرع يتم عبر محاكمهم حصرًا: فقد أعلن أبو عمر البغدادي حصر التحاكم إلى الشرع بمحاكم (دولة العراق الإسلامية)، (28) مع أنَّ العراق حينها كان يعج بالهيئات الشرعية التابعة للفصائل الأخرى. وفي سورية: قال الجولاني في شريطه المسرب: “ستقام محاكم شرعية في بعض المناطق المحررة، ويجب أن تكونوا جميعًا لها سمعًا وطاعة”، مع أنَّ المحاكم الشرعية موجودة في طول البلاد وعرضها وتقوم بعملها، وكانت القاعدة قد دخلت فيها بدايةً ثم انسحبت بحجة وجود الفساد. (29) وعلى الرغم من قيام القاعدة في سورية بعشرات الاعتداءات على فصائل وناشطين وغيرهم إلا أنَّها لم تقبل المثول أمام محكمة واحدة للنظر في الشكاوى ضدها.
– ويعتقدون أنَّ تصرفاتهم هي الصحيحة وكل تصرف دونها فهو باطل: قال أبو عمر البغدادي: “كل جماعة أو شخص يعقد اتفاقية مع المحتل الغازي فإنها لا تلزمنا في شيء، بل هي باطلة مردودة، وعليه نحذر المحتل من عقد أي اتفاقات سرية أو علنية بغير إذن دولة الإسلام”. (30) وفي سورية: رفضت القاعدة أي مشروع جامع يضم الفصائل كما في مشروع (ميثاق الشرف الثوري)، وأصدرت بيانًا في الطعن به وإسقاطه، ثم أعلنت مشروعها (هيئة تحرير الشام) واعتبرته مشروع الساحة الذي يجب على الجميع الدخول فيه. كما رفضت أي هدنة تقوم بها الفصائل للتهدئة والتخفيف من الحرب الدائرة واعتبرتها هدن خيانة وانبطاح أمام العدو، (31) بينما أبرمت العديد من الهدن مع مختلف الأنظمة، كهدنتها المستمرة مع إيران منذ سنوات، والهدنة التي عقدها لؤي السقا “أبو الربيع” المسؤول الأمني لتنظيم القاعدة في سورية مع آصف شوكت لتنسيق العمل الجهادي في العراق، وبقيت الاتفاقية سرية إلى أن كشفتها أمريكا فتخلى عنها النظام. (32) وكذلك الهدن التي تعقدها مع النظام في الغوطة على تخوم دمشق كبرزة والقابون، وأخيرًا اتفاقية (المدن الأربعة) التي اتفق فيها ممثل القاعدة مع ممثل إيران على عملية كبيرة ما زالت تثير ردود أفعال رافضة.
والشاهد من ذلك: أن ما ترفضه القاعدة لغيرها تفعله بنفسها وتبرره بمثل ما كان يقولوه خصومها حين تطعن فيهم وتنتقدهم، وما ذلك إلا لاعتقادها أنَّها الجهة الشرعية الوحيدة التي يحق لها أن تتصرف هذه التصرفات، وأن تنوب عن الأمة فيها. لذا يكثر في أدبياتهم إطلاق أوصاف التمجيد والتعظيم المبالغ به على جنودهم وجماعتهم: قال أبو عمر البغدادي: “فلسنا نشك والحمد لله طرفة عين أنكم الطائفة التي تقاتل على أمر الله في هذه البلاد”. (33) وقال الجولاني: “فأنتم من أثبت للعالم كله أنكم جنود الله عز وجل الأوفياء.. أنتم من عجزت أمريكا أن تجد حلًا لكم لاجتثاثكم… أنتم من بدأتم من أضعف ما يملك الإنسان، فاليوم ملككم الله عز وجلّ قلوب العباد وأرضها أيضًا”. (34)
المبحث الأول: أسس إقامة الدولة عند الغلاة
تقوم فكرة إقامة الدولة عند الغلاة على مجموعة مترابطة من الأفكار والمعتقدات، ومن أهمها:
1- الخروج بالسلاح
فهو منهجهم الوحيد للإصلاح، وهو موجّه ضد الحكومات وكافة مؤسسات الدولة، وضد كل من تتهمه بالعمالة أو الإعانة لهذه الحكومات من جماعات وشخصيات. فقد صرّح الظواهري بأنه يسعى “السعي الجاد لتغيير هذه الأنظمة الفاسدة وإقامة النظام الإسلامي”. (35)
أهمية فكرة حمل السلاح لبناء الدولة عند الغلاة: بما أنَّه لا يمكن إقامة الدولة وإسقاط الدول الحالية إلا بالقتال، فأصبح حمل السلاح واجبًا من جهتين: أنه جهاد الأعداء (المرتدين) لتحقيق التوحيد من جهة، ووسيلة لإقامة الدولة المنشودة من جهة أخرى. وسبقت طائفة من أقوال المنظرين لهذا الفكر. ويرون أنَّ أي عملٍ غير هذا فهو من العبث، بل خيانة الدين. قال سيد إمام: “نرى أن شَغْل المسلمين بأي أمر سوى الجهاد في سبيل الله… هو خيانة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وخيانة لهذا الدين وتضييع له”. (36) وقال القيادي في القاعدة أبو الليث الليبي: “كل عمل خلاف القتال والسعي له مباشرة دون تردد؛ فإنما هو إضلال وإغواء وتيه، وإن زُيّنت مسالكه، وتجملت نتائجه، وكل دعوة لغير نضح الدم لا ينظر إليها ولا يهتم بها”. (37)
2- خطة الغلاة في التغيير:
بعد عشرات التجارب التي خاضها الغلاة ضد الدول في العالم الإسلامي والتي انتهت جميعها بالفشل، رأوا أنَّ الدعم الدولي لهذه الأنظمة هو سبب فشلهم؛ لذا لا بد من ضرب الدول العالمية لإزالتها حتى يستطيعوا إقامة الدولة الإسلامية، وتبلورت لديها خطة عُرفت باسم (إدارة التوحش). (38) حيث قسَّموا العالم إلى قسمين: دول (مركز) وهي دول الكفر، وتتمثل قيادتها حاليًا في أمريكا، ودول تدور في فلكها كدول العالم الإسلامي. وعلى مبدأ أن (قتال المرتدين مقدَّم على قتال الكفار الأصليين)، (39) فإن خطتهم تقوم على إيجاد موطئ قدم في هذه الدول التابعة، ثم زعزعة أمنها لإنهاكها، ما يؤدي إلى ضعفها ودخولها في حالة من التوحش (الاضطراب)، فتتولى الجماعات (الجهادية) إدارتها لإكمال إسقاط هذه الأنظمة، ثم تعمل على حشد الشعوب -بخطط عسكرية ودعوية وإعلامية- لإسقاط النظام العالمي (المركز)، ثم إقامة الدولة الإسلامية. (40)
تكمن أهمية هذا المشروع عند القاعدة في أنه لا يمكن إقامة الدولة الإسلامية إلا من خلاله. قال أبو بكر ناجي: “إدارة التوحش هي المرحلة القادمة التي ستمر بها الأمة، وتُعد أخطر مرحلة فإذا نجحنا في إدارة هذا التوحش ستكون تلك المرحلة -بإذن الله- هي المعبر لدولة الإسلام المنتظرة منذ سقوط الخلافة”. (41) إن إسقاط مقومات الدولة ضرورة لإقامة إمارة في ظل التوحش، ففكرة إدارة التوحش تقوم على هدم جميع مكونات إقامة الدولة تبعًا لطبيعة جماعات الغلو وتحركها، فكيَّفت مفهوم الدولة على ظروفها في ظل هذه الفوضى، وقد سبق بيان ذلك. (42)
3- خطوات القيام بمشروع إدارة التوحش:
حددت جماعات الغلو الخطوات العامة للقيام بمشروع التوحش، ويمكن الإشارة لأهم نقاطها التي تتعلق بمشروع إقامة الدولة:
أ/ استغلال أوضاع البلدان الإسلامية وشعوبها لإطلاق مشروعها الخاص وحمله
يمتاز فكر هذه الجماعات أنَّها لا تستطيع إقامة مشروعها بنفسها، وأنه غير قابل للوجود في المجتمعات المستقرة؛ لذا فإنها تتطفل على مشاريع وظروف غيرها لتنشأ في كنفها ثم تنقلب عليها. فتبحث عن المجتمعات التي توجد فيها أعمال جهادية وحركات ثورية للدخول فيها، ولما يسود تلك المجتمعات من ظروف حرب وعدم استقرار فإنها تستغل ظروفها لإقامة مشروعها.
وقد حدد أبو بكر ناجي مواصفات البلاد المرشحة لتطبيق مشروع (إدارة التوحش)، وهي أن تكون مناسبة من حيث التضاريس، ويكون النظام الحاكم فيها ضعيفًا، ويوجد فيها مدّ “جهادي”، إضافة انتشار السلاح بأيدي الناس. (43) وهذا ما حدث في كل من أفغانستان والعراق والصومال، وفي سورية دخلت القاعدة مستغلة اندلاع الثورة، قال الجولاني: “الشّام لم تكن مهيأة لدخولها لولا الثورة السورية… هذه الثورة دفعت أو أزالت الكثيرَ مِن العوائق التي مهّدت لنا الطريقَ في الدّخول والوصول إلى هذه الأرض المباركة”. (44) ومما يسهل مهمتها: انخداع الناس بشعاراتهم، وما يقدمونه لهم من خدمات لكسب تأييدهم، كما سيأتي بيانه.
ب/ العمل على إقامة وحدات إدارية منفصلة داخل الدول الإسلامية المستهدفة بالعمليات العسكرية، ثم الربط بينها للتنسيق الإداري والعسكري
قال أبو بكر ناجي: “الترقي بالمجموعات الإدارية للوصول لشوكة التمكين والتهيؤ لقطف الثمرة وإقامة الدولة… إنشاء شبكة دعم لوجستي لمناطق التوحش -المُدارة بواسطتنا- المجاورة والبعيدة”. (45) وهو ما سار عليه الجولاني في كيفية ربط (الإمارات) بعضها ببعض وصولًا إلى التنسيق الأخير بينها حيث قال في شريطه المسرَّب: “سيتم تقسيم الجيوش إلى كتائب وسرايا، سيكون هناك جيش في حلب، سيكون هناك أيضًا جيش في إدلب … وإخوانكم في درعا سيلتحقون بكم أيضًا سينشؤون جيشًا وإمارة أيضًا هناك، وكذلك بإذن الله أيضًا في الغوطة المحاصرة. ثم سنضع استراتيجية لجمع هذه الإمارات في إمارة واحدة”. (46)
ج/ الحرص على جلب (المهاجرين) لصفوفهم، وتسليمهم زمام الأمور الدعوية والقتالية والقيادية
حيث تمثل ما يسمى (الهجرة) إحدى أهم ركائز جماعات الغلو المعاصر، فمن أهم أسباب اعتمادهم على (المهاجرين): اعتقادهم أنهم أصح عقيدة من أبناء المجتمعات الإسلامية التي يظهرون فيها، واعتبارهم أكثر إخلاصًا وتفانيًا للمشروع، وأن وجودهم سيجهض أي مشروع لقيام دولة على أساس الحدود والجنسيات الحالية. ولا تخلو منتجات هذه الجماعات غالبًا من الدعوة إلى النفير إلى مناطقهم والحث عليها بكافة السبل، فقد أفرد سيد إمام في كتابه عدة مواضع للحديث عن الهجرة. (47) وقال أبو بكر ناجي عن (الهجرة): “الخطة الإعلامية عندما تواكب مرحلة إدارة التوحش… هو أن يطير جموع الشعوب إلى المناطق التي نديرها، خاصة الشباب”. (48)
د/ إقناع الشعوب بالمشروع وتجنيدهم فيه عن طريق إغرائهم بتوفير الحاجيات المعيشية اليومية لهم التي يفتقدونها بسبب ظروف هذه المناطق، لتكوين بيئة حاضنة تحمل المشروع
وقد فصَّل أبو بكر ناجي وسائل هذا الاستقطاب بأمور منها: التعليم الديني على منهجهم، والتأليف بالمال. (49) وقال الجولاني: “نحن نقدم لهم الكهرباء، نقدم لهم الماء، نقدم لهم الحنطة، نقدم لهم الطحين، نقدم لهم القضاء، نقدم لهم الأمن، نقدم لهم الحماية، نقدم لهم الشرطة، نقدم لهم تسيير معاملاتهم التجارية”. (50)
ه/ ممارسة سياسية إعلامية احترافية تجاه الشعوب لإغرائها بالانضمام للمشروع والدفاع عنه
فالإعلام لهذه الجماعات قد يُقدَّم على العمل العسكري في الكثير من الأحيان، وتبذل فيه الكثير من الجهود والأموال، وأبرز أهدافه: إبهار الجمهور المتابع، وإقناعهم بالمشروع؛ لتجنيدهم، وجذب أفراد الجماعات الأخرى. وقد عوَّل أبو بكر ناجي على العمل الإعلامي في مواضع عديدة من كتابه، ومما ذكره من الاستراتيجيات: استراتيجية إعلامية تستهدف الشعوب لضمها وكسب تعاطفها، وتستهدف جنود العدو لضمهم أو تحييدهم، واستراتيجية إعلامية تستهدف في كل هذه المراحل تبريرًا عقليًا وشرعيًا للعمليات. (51) ولم تكن القاعدة في سورية بمعزل عن هذا الاهتمام، ومن سياستها في ذلك: الاهتمام الشديد بنشر وتوثيق مشاركاتها العسكرية إعلاميًا مهما كانت قليلة، وإخراج إنتاجها الإعلامي باحترافية عالية؛ مما يجعلها مبهرة وآسرة، وتعطي انطباعًا بالقوة والعظمة والسيطرة، ونشر منتجاتها عبر عدة منابر مختلفة، بالإضافة لعشرات المواقع والصفحات والقنوات على وسائل التواصل. (52)
و/ الدعوة والتربية على المنهج لاجتذاب الأتباع وتجنيد المناصرين للمشروع
يتميز فكر هذه الجماعات أنَّه غريب عن المجتمعات الإسلامية؛ لذا فإنَّ من أولى أولوياتها تدريس مناهجها وتقديم مرجعياتها الشرعية، وعمدت مؤخرًا إلى ترجمتها لعدة لغات ونشرها عبر شبكة الانترنت. قال الظواهري: “لتسعوا لأن تعودوا بالأمة التي طالت غربتها عن شريعتها … بعيدًا عن انحرافات المنحرفين، وأكاذيب تجار الدين الدجالين، ومناهج الانهزام والاستجداء، وفلسفات التراجع والانحناء، وفقه المتسولين، وفتاوى علماء المارينز، ومساومات قادة الحركات الذين يجرون الأمة للعلمانية بعيدًا عن حاكمية الشريعة، وللعصبية للمواطنة بعيدًا عن أخوة الإسلام، وللرضوخ لسايكس بيكو بدلًا من دولة الخلافة”. (53) وقال أبو بكر ناجي: “إن دور الدعوة في مرحلة البدايات هي جذب القلة الممتازة، أما استجابة الناس فبعد التمكين وبعد نصر الله والفتح!” (54)
وقد ظهر هذا جليًا في سورية، ففي الشريط المسرب قال الجولاني: “فيما بعد سنبدأ بتجنيد إخوة لكم جدد قد يكونوا دونكم (!) في المستوى، فيجب عليكم أن تصبروا عليهم، وأن تعطفوا عليهم، وأن تغرقوهم بالدعوة لله عز وجل”. (55)
لذا عمدت القاعدة إلى الاهتمام بإنشاء معاهد للتعليم الشرعي تستهدف عامة الناس، والمجاهدين، ومما يدرس فيها كتب ومؤلفات تنظيم القاعدة ومرجعياته، ورؤوس الغلو من أصحاب المناهج المنحرفة كالبرقاوي والفلسطيني وغيرهم، كما نشرت منتجاتهم عبر الدروس والمجلات وغيرها. (56)
ز/ جرّ الشعوب وتوريطهم بالمعركة رغمًا عن إرادتهم، ليكونوا وقودها وضحاياها
مع كل الجهود المبذولة فإن أعداد المنضمين لهذه الجماعات يبقى منخفضًا لطبيعة أفكارها، مما يهدد مشروعهم بعدم الاكتمال، فكانت خطتهم جرِّ الشعوب وتوريطها لإكراهها على المشاركة في المشروع. قال أبو بكر ناجي متحدثًا عن فكرة الاستقطاب: “أروع الأهداف… هي جعلنا لا نخشى من عواقب أن يبلغ الاستقطاب في الأمة أقصى مدى له… نقصد بالاستقطاب هنا هو جر الشعوب إلى المعركة… جر الشعوب إلى المعركة يتطلب مزيدًا من الأعمال التي تشعل المواجهة، والتي تجعل الناس تدخل المعركة شاءت أم أبت… هذه المعركة وحدها بهذه الحدة وهذه المفاصلة هي التي نستطيع فيها استقطاب أكبر قدر من الأفراد لصفنا بحيث لا نأسى بعدهـا على من يهلك في الصف الآخر، ونفرح لمن يصطفيه الله في صفوف أهل الإيمان بالشهادة”. (57)
ح/ في حال فشل المشروع
لم تضع حركات في التعامل مع الدولة والحكم إلا تصورًا وحيدًا وهو تطبيق كل ما تعتقده دفعة واحدة كاملًا، ثم إذا فشلت (التجربة الجهادية) فالحل في الانتقال إلى بلدٍ آخر، والبحث عن مشروعٍ آخر، وترك الشعوب لمصيرها الذي يجب عليها أن تتحمله لإقامة دين الله. وبالنظر إلى تجارب هذه الجماعات –مع كثرتها وطول زمنها- فإنها لم تستطع البقاء في المناطق التي ظهرت فيها فضلًا عن إدارتها، بل تركت آثارًا مدمرة؛ لغياب خطط الإعمار والبناء لديها؛ فمشروعها الحقيقي إثارة الفوضى وإداراته مؤقتًا حتى يأتي الفتح وتتحقق النبوءات بدخول عامة الناس في الدين وقيام دولة الخلافة!
ففي التجربة الأفغانية: نتج عن أحداث 11 أيلول-سبتمبر تدمير أفغانستان، وإسقاط حكومة طالبان، وما تبعها من مآسٍ لا توصف، ثم انسحبت القاعدة منها إلى إيران والعراق.
وفي العراق: دُمر العمل الجهادي، ومناطق أهل السنة، وزاد نفوذ الرافضة، ثم تخلت القاعدة عن تنظيم (الدولة) لما فقدت السيطرة عليه.
وفي الدول الخليجية: قامت بالعديد من العمليات التي ترتب عليها كوارث كبيرة ثم انسحبت عند فشلها.
أما في سورية: فبعد كل تصريحات الجولاني عن الإمارة على منهاج النبوة، وعدم القبول بأي حل إلا ما يراه ويعتقده قال عبر معرف أبو عمار الشامي بتغريدة بتاريخ 11/1/2016م معبرًا عن سهولة التخلي عن هذه التجربة: “لا يعيب الثبات على الدين أن يكون المنتهى الجبال والأودية”! (58)
المبحث الثاني: مبررات العنف المرتبطة بإقامة الدولة عند الغلاة
تبنَّت جماعات الغلاة عددًا من الأحكام التي تُشرع العنف بالقتل والاستهداف ضد كل من يخالف مشروعهم، تحت عناوين عامة تتلخص في التكفير، والتخوين، كما سيأتي تفصيله.
أولًا: تكفير الحكومات وأجهزتها وحمل السلاح ضدها
يمثل تكفير الدول في العالم الإسلامي الركن الأساس في فكر جماعات الغلو، ومنه تنبع بقية معتقداتها وأحكامها، وأسباب تكفير هذه الحكومات لا يخرج عن التالي: (59)
1- الحكم بغير ما أنزل الله، وتشريع القوانين الوضعية الشركية، مما يجعلها أنظمة أنظمة شرك وردة.
2- الدخول في مؤسسات الكفر العالمية، ومواثيقها واتفاقياتها الشركية، والرضا بالكفر الذي تحويه.
3- موالاة الغرب الكافر، ومناصرته ضد المسلمين والمجاهدين.
4- عدم تكفير الكفار الأصليين والمرتدين، فمن لم يكفر الكافر فهو كافر.
كما يدخل في الحكم بالكفر والردة البلاد الإسلامية التي يعتبرونها ديار كفر، وتكفير الوزراء والمديرين وكبار الموظفين في هذه الدول، كالسفراء وغيرهم؛ لأنهم من طائفة الردة، وموالون للمرتدين ومناصرون لهم، ومشاركون في الحكم بالطاغوت.
قال سيد إمام: “إنه يجب على كل مسلم معرفة حال الحاكم… ومن هذه الأحكام:
أ – أن حكام هذه البلاد كفار كفرًا أكبر خارجون من ملة الإسلام.
ب – أن قضاة هذه البلاد كفار كفرًا أكبر، وهذا يعني تحريم العمل بهذه المهنة”. (60)
وقرر عصام البرقاوي (أبو محمد المقدسي) أنَّ الوزراء والعساكر كفار، ولا بد لتوبتهم من بيان براءتهم من الكفر الذي كانوا عليه. (61)
ثانيًا: تكفير نواب البرلمانات
فبدخولهم البرلمانات أصبحوا طواغيت يشرعون من دون الله تعالى، ويمتد الأمر لكل من يدعو إلى هذه الانتخابات ويُشجع علها، بل ويشارك في انتخابهم من عموم الشعب. قال سيد إمام: “أعضاء الهيئات التشريعية بهذه البلاد -كالبرلمان ومجلس الأمة ونحوه- كفار كفرًا أكبر… الذين ينتخبون أعضاء هذه البرلمانات هم كفار كفرًا أكبر… ويكفر أيضا كل من دعا إلى هذه الانتخابات أو شجع الناس على المشاركة فيها”. (62)
ثالثًا: تكفير المنتمين للأجهزة الأمنية والعسكرية
درج أتباع تنظيمات الغلو على تكفير أفراد الأجهزة الأمنية بمختلف قطاعاتها، وتسميتهم بـ (عساكر الشرك) أو (عساكر القوانين)، وتتلخص أسباب تكفيرهم في:
1- عدم الكفر بطاغوت الحكام وقوانينهم.
2- حراسة ومناصرة وموالاة الحكام الكفرة.
3- أنهم مع الحكام طائفة ممتنعة.
قال سيد إمام: “أن الجنود المدافعين عن هذه الأوضاع الكافرة هم كفار كفرًا أكبر”. (63) وقال البرقاوي (المقدسي): “فما دام هؤلاء العساكر أو غيرهم غير كافرين بالطاغوت بل هم حرّاسه وأنصاره وجنده وأركانه وحفظته، فهم ليسوا بمسلمين ولا مؤمنين ولا متمسِّكين بالعروة الوثقى بل هم من الهالكين إن ماتوا على شركهم”. (64) وقد خصص عدد كبير من شرعيي هذه الجماعات مؤلفات خاصة تُشرع قتل أفراد المؤسسات العسكرية، (65) وتشهد الأعمال الميدانية والإصدارات المرافقة لها على هذا المنهج كما هي أحداث التفجيرات في عدد من الدول الإسلامية. ومن لم يكفر أعيان أفراد هذه الأجهزة فقد أجاز قتلهم وقتالهم لأنهم في صف الحاكم، ولا يمكن التمييز بينهم وبين من وقع في الكفر، والمسلم منهم يبعث على نيته. (66)
رابعًا: الحكم على البلاد الإسلامية أنَّها ديار كفر
ترتَّب على تكفير الحكومات والعاملين فيها الحكمُ على جميع البلاد والديار أنها ديار كفر وردة؛ لأن أحكام الكفر والردة عن الشرع هي الظاهرة والحاكم عليها بزعمهم. قال سيد إمام: “ومنه تعلم أن البلاد التي أكثر أهلها من المسلمين ولكن يحكمها حكام مرتدون بأحكام الكفار بالقوانين الوضعية هي اليوم ديار كفر”. (67) ورتبوا على ذلك أحكامًا عديدة من أهمها:
1- إعلان الحرب على جميع بلاد المسلمين باعتبارها ديارَ كفرٍ وردّة، مع تكفير حكوماتها، وجيوشها.
2- فرض الهجرة من جميع البلاد إلى مناطق سيطرتهم.
3- زعمهم أنّ مِن أوجب الواجبات إقامةَ إمارةٍ إسلامية على أيِّ جزءٍ مِن الأرض لتشكّل دارَ الإسلام المفقودة اليوم؛ لتطبّقَ فيها الشّريعة، ومنها تخرج الجيوش وتفتح الأرض.
4- استباحة دماء عامة المسلمين بحجّة التترّس تارةً، ولمصلحة الجهاد تارةً أخرى.
5- استباحة دماء المعاهدين مِن الذّمّيين والمستأمنين بحجّة عدمِ صحّة عقد الذمّة أو الأمان مِن الحكومات؛ لأنها كفرية طاغوتية بزعمهم.
خامسًا: تكفير وتخوين عامة علماء الأمة الإسلامية واستباحة دمائهم
وقف علماء الأمة ضد انحراف هذه الجماعات، وردوا عليها، وأوضحوا عوارها وأخطاءها؛ فكانوا –بإذن الله تعالى- الصخرة التي تحطمت عليها شُبه هؤلاء، وحمى الله بهم أجيالًا من الشباب، مما أوغر صدور الغلاة عليهم، واعتبروهم أخطر ما يواجههم في ترسيخ مشروعهم، فكان لهم النصيب الأكبر من حملة الإسقاط والتخوين، بل والتكفير. وتتلخص أسباب تخوينهم لأهل العلم بل وتكفيرهم في:
1- عدم الكفر بطاغوت الحكام وقوانينهم وتكفيرهم.
2- مناصرة وموالاة الحكام الكفرة.
قال سيد إمام: “فهؤلاء المشايخ وأمثالهم لا شك في كفرهم”. (68) ووضع عمر محمود (أبو قتادة الفلسطيني) مؤلفًا ساق فيه نقولات تدل على تكفير العلماء الذين دخلوا مع الحكومات المرتدة، وخطبوا لها على المنابر، ودعوا لها بالتوفيق، وأنهم يقتلون دون استتابة، وتحرم عليهم زوجتهم، ولا يرثون ولا يورثون، ومالهم فيء للمسلمين. (69)
أما من لم يُكفر أعيان هؤلاء المشايخ فقد جعل تكفيرهم من باب الاجتهاد الذي لا يُنكر على صاحبه، ولا يُعد قائله من الغلاة. فقد قال البرقاوي عن تكفير البعض للعلماء والمشايخ: ” كما جرى معي في باكستان، فقد كانت موجة تكفير ابن باز وأضرابه من علماء الحكومات على أشدها، وكانت مجموعة من غلاة المكفرة يمتحنون الناس بهذه المسألة، فمن كفر ابن باز تركوه ومن لم يكفره كفروه وكفروا من لم يكفره وهكذا. وقد سألوني عن ذلك فقلت: إنني أترك الخوض في كفر أعيان هؤلاء من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: (دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه)!، والناس اليوم بالكاد يستسيغون تكفير الطواغيت وعساكرهم وجيوشهم، ولنا في ذلك شغل عن الالتفات إلى هؤلاء المشايخ المحسوبين على الدعوة والدين، فأرى عدم الانشغال بهم في هذه المرحلة، ويكفيني تحذير الشباب من كتاباتهم وفتاويهم الضالة في أبواب السياسة والبيعة والإمارة والطواغيت وجيوشهم وأوليائهم”. (70) فجعل تكفير هؤلاء العلماء مسألة ممكنة، واعتقادها راجع للاجتهاد والتحسين الشخصي، وأنَّ الغلو هو في الامتحان على هذا التكفير.
ومن لم يُكفِّر أعيانهم فقد أجاز قتلهم من باب مصلحة الجماعة والحفاظ على مشروعها، قال عمر محمود (الفلسطيني) في تشريع قتل الجماعة الإسلامية المسلحة الجزائرية (الجيا) للشيخين محمد سعيد الوناس، وعبد الرزاق رجَّام: “نعم! يجوز للأمير … أن يقتل المبتدعة إذا حاولوا الوصول إلى القيادة وتغيير منهجها؛ لأن حالهم حينئذ أشد من حالة الداعي إلى بدعته، فالمبتدعة هنا دعاة وزيادة”. (71) ودعا فارس آل شويل إلى قتل العلماء والدعاة بطريقة بشعة: “ليحد أحدكم شفرته وليعذب الطواغيت في سلخه ونحره”. (72) وقد شهد العراق قتل مئات العلماء والمشايخ والدعاة بالاغتيالات والتفجيرات حتى داخل المساجد على يد القاعدة (دولة العراق الإسلامية) بتهم شق الصف، أو رفض البيعة، أو العمالة (للمرتدين من أهل السنة في الحكومة الرافضية)، أو الانتماء لجماعات كفرية، ونحو ذلك.
سادسًا: الموقف من الجماعات الإسلامية الأخرى
يعتمد مشروع الغلاة على حصر الحق في جماعتهم، وأنَّ مشروع دولة الإسلام ينبغي أن يكون بقيادتهم، فكان الحل الذي قدموه لبقية الجماعات:
1- مطالبتها بالبيعة؛ لأنها الأصلح والأفضل منهجًا.
2- محاولة اختراق تلك الجماعات للسيطرة عليها.
3- قتال من لم يقبل بيعتها.
قال سيد إمام: “الواجب على كل مسلم أن يعمل مع أقدم جماعة من المشتغلين بالجهاد وبيعة أي جماعة أحدث هي باطلة وإن جهلت بوجود الجماعة الأقدم”. (73) لذا فقد كان جهد القاعدة في العراق منصبًا على إرغام الجماعات الأخرى على بيعة كيانهم الجديد (دولة العراق الإسلامية)، وقد اعتبر أبو عمر البغدادي من لم يبايعه من الجماعات الأخرى عاصيًا. (74) وهكذا كانت سنتهم في سورية في جميع التشكيلات التي أعلنوا عنها حتى جاء في بيان تأسيس (هيئة تحرير الشام): “إننا ندعو جميع الفصائل العاملة في الساحة لإتمام هذا العقد والالتحاق بهذا الكيان جمعًا للكلمة وحفظًا لمكتسبات الثورة والجهاد”. ومن يرفض فإن مصيره الاعتداء والقتال بتهم مختلفة: تارة الفساد، وتارة القبض على مجرمين، وثالثة بالعمالة لقوى أجنبية، وهكذا. (75) وفي تحريم ترك البيعة قال سيد إمام: “نكث العهد ـ أيا كان ـ هو كبيرة من كبائر الذنوب للوعيد الوارد في ذلك … إلا أن نقض هذه البيعة ورد فيه وعيد خاص لعظم خطره”. (76)
أما اختراق الجماعات وتقويضها
فقد قال أبو بكر ناجي: “بالنسبة لاختراق الجماعات الإسلامية الأخرى بل والترقي في سلمها القيادي من خلال أفراد موثوق في تمكنهم من مدافعة الشبهات العلمية والشهوات، ينتج عن ذلك فوائد كثيرة مختلفة … أما اختراق الحركات التي لا تؤذي المجاهدين فلا يتم لجمع المعلومات ولكن لدعوتهم والتقرب منهم والاستفادة من تحويل مواقفهم في صالح الجهاد حال الأوضاع والمواقف الحاسمة”. (77) وقد يصل هذا الاختراق إلى درجة القتل قال أبو بكر ناجي: “هذا الدور بمثابة عملية استشهادية بل قد ينتهي فعلًا بعملية استشهادية لتدمير الموقع المُخترق”. وكل هذا جائز باسم المصلحة، قال: “هناك إشكالية حرمة التجسس على المسلمين فكيف يمكن جمع المعلومات عنهم؟ وفي هذا أعتقد بجواز ذلك تجاه الحركات التي تؤذي المجاهدين أو تتعامل مع الطواغيت”. (78) فالكذب، والتجسس، وصولًا إلى تدمير المال والممتلكات وإفناء الجماعات والقتل كله جائز للمصلحة في هذا الاختراق. وهذا ما عملت عليه القاعدة في العراق طوال سنوات عملها، ثم كشفت وثائق مجلة دير شبيغل جانبًا من خطط التنظيم لاختراق الفصائل في سورية بعد إعلان دولته. (79)
فإن لم تستطع هذه الجماعات القيام بالخطوات السابقة فإنها تلجأ إلى إسقاط هذه الجماعات وإنهائها وإن أدى ذلك إلى سيطرة الأعداء على بلاد المسلمين؛ لأنَّهم يرون أنَّ المشاريع المنافسة لهم أخطر من مشاريع الاحتلال، ويُقدمون قتالها من باب قتال العدو الأقرب، ويوهمون أنفسهم أنَّ العاقبة والنصر لهم بعد الانتهاء من هذه الجماعات المنحرفة الضالة!
قال عطية الليبي في رسالته لابن لادن عن اليمن: “… الاضطراب والفوضى، وهو خيرٌ من سيطرة الكفرة المرتدين”. (80)
وما فعلته القاعدة في سورية من الاعتداء على فصائل مدينة حلب وخصوصًا (تجمع فاستقم) مما أدى إلى سقوطها بيد النظام والميليشيات الإيرانية، واعتدائها على فصائل الغوطة وخصوصًا (جيش الإسلام) مما أدى إلى سقوط أكثر من نصف الغوطة بيد النظام، وما تبعه من تسليم العديد من المناطق للنظام دون السماح لمنافسيها بالدخول لها.
سابعًا: الموقف من الشعوب الإسلامية
اتخذت هذه الجماعات العنف ضد عامة الشعوب الإسلامية من خلال مسارين:
الأول: الزج بالشعوب في معاركهم، تحت شعار:
1- القيام بالجهاد الواجب، وإلا تعطل الجهاد وتوقف.
2- عدم العيش في ظل الطواغيت.
3- من قتل بهذه العمليات فهو شهيد، وسيتولون دفع ديته عند القدرة على ذلك.
4- أن هذه الجماعات قد أنذرت المسلمين القريبين من تلك الأهداف، فعليهم أن يستجيبوا لها. (81)
المسار الثاني: ما يسقط من ضحايا مسلمين في العمليات المتنوعة التي تقوم بها هذه الجماعات في البلاد الإسلامية أو غير الإسلامية، وقد بررت هؤلاء الضحايا:
1- أن ما يسقط منهم من ضحايا فهو من باب (الترس) الجائز في الفقه الإسلامي. (82)
2- من باب مصلحة المسلمين، كما في فتوى عمر محمود (أبو قتادة الفلسطيني) حيث أجاز قتل نساء وأطفال عساكر الدولة الجزائرية (المرتدين) في فتواه المشهورة. (83)
ومن المسائل الملحقة بهذه النقطة: العنف الموجه لغير المسلمين في البلاد الإسلامية كالنصارى، والعنف الموجه لغير المسلمين من الزائرين والمسافرين والسياح، بحجة أن أمانهم منتقض بردة الحكومات في العالم الإسلامي. (84)
ثامنًا: العنف في بلاد الكفار
يقوم جزء من مخطط هذه الجماعات على القيام بعمليات عسكرية في بلاد الكفار والتي يكون فيها غالب الضحايا من عامة الناس، وقد سوّغوا أعمالهم تلك:
1- من باب المعاملة بالمثل، وبما أن الكفار يقتلون نساءنا وأطفالنا فهذا جائز لنا. (85)
2- فيه نكاية بالكفار، وإرهابًا لهم، وإلحاق خسائر مالية ضخمة قد تؤدي بدولهم للانهيار.
3- دول هؤلاء الكفار محاربة للمسلمين؛ فلا أمان بينهم وبين المسلمين، والتالي يجوز خداع الكفار بأخذ تأشيرة لدخول بلادهم، ثم القيام بهذه العمليات؛ لأنَّ الأمان هنا باطل.
المبحث الثالث: نقد مسوّغات العنف عند الغلاة المرتبطة بإقامة الدولة
في هذا الفصل إجابات على أهم أصول الغلاة دون الغوص في فرعيات المسائل العقدية والفقهية، أو استيعاب ذكر سائر جوانب الحكم الشرعي الصحيح في المسائل المطروحة.
أولًا: تكفير الحكومات لحكمها بالقانون الوضعي
من أهم ما وقع فيه الغلاة في هذه المسألة أمران:
الأول: عدم اعتبار كلام أهل العلم في فهم النصوص الشرعية وتأصيل المسائل وتنزيلها على الواقع.
الثاني: الأخذ ببعض النصوص أو كلام أهل العلم في المسائل المطروحة دون بقيتها.
والإجابة على شبهاتهم من خلال المسائل التالية:
المسألة الأولى: حكايتهم الإجماع على كفر الحكم بالقوانين الوضعية بإطلاقٍ دون تفصيل.
وهذه الحكاية غير صحيحة، فقد ثبت عدم التكفير بالحكم بالقوانين الوضعية في بعض الحالات عن عدد من أهل العلم الذي حُكي عنهم الإجماع، ومن ذلك:
1- ما يُنقل عن الشيخ أحمد شاكر قوله: “إنّ الأمرَ في هذه القوانين الوضعية واضحٌ وضوحَ الشّمس، هي كفرٌ بَواحٌ، لا خفاءَ فيه ولا مداورة، ولا عذرَ لأحدٍ ممّن ينتسب للإسلام كائنًا مَن كان في العمل بها، أو الخضوع لها، أو إقرارها”. (86)
فقد قال في مواضع أخرى مُبينًا سبب الحكم بالكفر: “فانظروا إلى ما فعل بنا أعداؤنا المبشّرون المستعمرون! لعبوا بديننا، وضربوا علينا قوانينَ وثنيةً ملعونةً مجرمة، نسخوا بها حكمَ الله وحكمَ رسوله، ثم ربّوا فينا ناسًا ينتسبون إلينا، أشربوهم في قلوبهم بُغضَ هذا الحكم، ووضعوا على ألسنتهم كلمةَ الكفر: أنّ هذا حكمٌ قاسٍ لا يناسب هذا العصرَ… ولقد جادلتُ منهم رجالًا كثيرًا مِن أساطينهم، فليس عندهم إلا أنّ حكمَ القرآن في هذا لا يناسب هذا العصر!! وأنّ المجرمَ إنْ هو إلا مريضٌ يجب علاجُه، لا عقابُه”. (87) وقال: “والذي نحن فيه اليومَ هو هجرٌ لأحكام الله عامّةً بلا استثناء، وإيثارُ أحكامٍ غيرِ حكمِه في كتابه وسنّة نبيّهه، وتعطيلٌ لكلّ ما في شريعة الله، بل بلغ الأمرُ مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع على أحكام الله المنزلة، وادعاء المحتجّين لذلك بأنّ أحكامَ الشّريعة إنما نزلت لزمانٍ غير زماننا، ولعللٍ وأسباب انقضت، فسقطت الأحكامُ كلُّها بانقضائها”. (88)
فإنزال القوانين الوضعية محلَّ الشّريعة، أو تفضيلها عليها، أمرٌ زائدٌ عن مسألة الحكم بالقوانين الوضعية، وهو كفرٌ بالاتفاق، وليس جميع حالات الحكم بها كذلك.
2- ما يُنقل عن الشيخ محمد بن إبراهيم قوله في أنواع كفر الاعتقاد: “الخامس: وهو أعظمُهما وأشملُهما وأظهرها معاندةً للشّرع، ومكابرةً لأحكامه، ومشاقّةً لله ولرسوله، ومضاهاةً بالمحاكم الشّرعية… فكما أنّ للمحاكم الشرعية مراجعَ مستمدّات مرجعُها كلّها إلى كتاب الله، وسنّة رسول الله، فلهذه المحاكم مراجعُ هي القانون الملفّق مِن شرائعَ شتّى، وقوانين كثيرة… فأيُّ كفرٍ فوقَ هذا؟ وأيُّ مناقضةٍ للشّهادة بأنّ محمّدًا رسولُ الله بعد هذه المناقضة؟!” (89) فإنَّه فصَّل في حكم هذه القوانين في موضعٍ أخر، ذاكرًا أسباب الحكم بالكفر المخرج من الملة: قال: “مَن حكم بها، أَو حاكم إليها معتقدًا صحّة ذلك وجوازَه فهو كافرٌ الكفرَ الناقلَ عن الملّة، وإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازِه فهو كافرٌ الكفرَ العمليَّ الذي لا يَنقل عن الملّة”. (90) وأقوال سائر علماء الأمة في هذه المسألة منتشرة مشتهرة.
المسألة الثانية: قياسُ تكفير الحكم بالقوانين الوضعية على الحكم بكفر الياسق الذي وضعه التّتار، بجامع مخالفة الشريعة، ومن ثم الحكم على الحكومات الحالية بالشرك الأكبر.
ويجاب: بأنَّ إطلاق القياس غير صحيح لما يلي:
أ- أنّ واضع الياسق جنكيزخان كان مشركًا كافرًا كفرًا أصليًّا، حيث يروي المؤرخون أنَّ ديانته كانت شامانية، وأنَّه كان يصلّي إلى جبل برخان خلدون. (91)
ب- كان أتباع جنكيز خان يعظّمونه ويرفعونه إلى مرتبة النّبوة والتّأليه، ويعتقدون ذلك فيه.
قال الذّهبي: “دانت له قبائلُ المغول… وتعبّدوا بطاعته وتعظيمه”. (92)
ج- أنَّ الياسق لم يكن مجرّد قانونٍ مخالف للشّرع يتحاكم إليه الناس، بل كان تبديلًا للشّرع، وإحلالًا له محلّ الوحي، ونسبةً له إلى الدين؛ بناء على ما ادعاه جنكيزخان في نفسه.
قال ابن كثير: “هو عبارةٌ عن كتابٍ مجموعٍ مِن أحكامٍ قد اقتبسها عن شرائعَ شتّى، مِن اليهوديّة والنّصرانية، والملّة الإسلاميّة، وفيها كثيرٌ مِن الأحكامِ أخذها مِن مجرّد نَظرِه وهواه، فصارت في بنيه شرعًا متّبعًا، يقدّمونها على الحكم بكتاب الله، وسنّة رسوله”. (93)
وبهذا يتبيَّن أنَّ ما فعله جنكيزخان ادعاءٌ لحقّ التّشريع، ونزولِ الوحي، واختراعُ دينٍ جديد، وتشريعُ قوانينَ وأحكامِ بمنزلة الشّرائع السّماوية، وتفضيلُها عليها، وتعبيُد النّاس لها، وهذا كفرٌ بَواحٌ أكبرُ لا خلافَ فيه، وليس كل من وضع قوانينَ وضعيةٍ مخالفةٍ للشرع كان كذلك. وعليه: فقياسُ القانون الوضعي على الياسق بإطلاقٍ دون تفصيلٍ قياسٌ مع الفارق، فيكون قياسًا فاسدًا. (94)
المسألة الثالثة: تشريع القوانين الوضعية أو المخالفة للشريعة كفر.
قالوا: وضع القوانين المخالفة للشرع كفر أكبر مخرج من الملة لا خلاف في ذلك، وهو من الإشراك بربوبية الله تعالى وألوهيته، ويستدلون بقول ابن تيمية: “والإنسانُ متى حَلَّلَ الحرام الـمُجْمَعَ عليه، أو حَرَّم الحَلالَ الـمُجْمَعَ عليه، أو بَدَّل الشرع المجمع عليه كان كافرًا باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين: {ومَن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}”.
وليس الأمر كذلك: فقد عمَد عامّةُ الغلاة إلى نقل كلام ابن تيمية في هذه المسألة مبتورًا، مع أنّ بقيةَ كلامه توضّحُ أنّ الكفر الذي اتفق عليه الفقهاء يكون في حال الاستحلال، وتنزيل هذه التّشريعات محل التشريع الإلهي، ونسبتها كذبًا إلى الدّين، وهذا نصُ كلام ابن تيمية بتمامه: “والإنسانُ متى حَلَّلَ الحرام الـمُجْمَعَ عليه، أو حَرَّم الحَلالَ الـمُجْمَعَ عليه، أو بَدَّل الشرع المجمع عليه كان كافرًا باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين: {ومَن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} أي: هو المستحلُّ للحكم بغير ما أنزل الله.
ولفظُ الشّرعِ يُقال في عرف النّاس على ثلاثةٍ معان: الشّرع المنزّلُ، وهو ما جاء به الرسولُ، وهذا يجب اتباعه ومن خالفه وجبت عقوبته. والثاني الشّرع المؤول وهو آراءُ العلماء المجتهدين فيها، كمذهب مالك ونحوه. فهذا يَسوغُ اتّباعُه، ولا يجب، ولا يحرم، وليس لأحدٍ أنْ يُلزم عمومَ النّاس به، ولا يمنع عمومَ النّاس منه. والثالثُ الشرع المبدل، وهو الكذبُ على الله ورسوله، أو على النّاس بشهادات الزّور ونحوها، والظّلم البيّن، فمَن قال: إنّ هذا مِن شرع الله فقد كفر بلا نزاع، كمن قال إن الدم والميتة حلال ولو قال هذا مذهبي ونحو ذلك”. (95) وقال ابن العربي: “إنْ حَكَمَ بِمَا عِنْدَهُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ؛ فَهُوَ تَبْدِيلٌ لَهُ يُوجِبُ الْكُفْرَ”. (96)
وعند استقصاء ما يُنقل مِن كلام أهل العلم في هذه المسألة يتَّضح أنَّ لكلامهم تفصيلات وحالاتٍ أخرى لا يذكرها الغلاة. وجميع ما سبق يعني أنَّ الحكم بالقوانين الوضعية له حالات، منه ما يكون كفرًا أصغر، ومنه ما يكون كفرًا أكبر. (97) تتطلَّب النظر فيها، ثم تنزيل الحكم الشرعي عليها من أهل العلم والاجتهاد، وأنَّه إن تحقق وصف الكفر لحاكمٍ ما فلا يقتضي ذلك ما رتبوا عليه من أحكام أخرى كما سيأتي بيانه.
ثانيًا: الحكم على بلاد المسلمين أنها بلاد كفر وردة
حكم الغلاة على عامة بلاد المسلمين أنها بلاد كفر وردة؛ بناءً على أنَّ أحكام الكفر والشرك وشعائره هي الظاهرة الحاكمة بزعمهم، ثم رتَّبوا على ذلك العديد من الأحكام كما سبق. وهذا باطلٌ شرعًا، وبيانه كما يلي:
المسألة الأولى: كيف تتحول دار الإسلام لدار كفر. لأهل العلم في هذه المسألة أقوال:
1- الدّار التي ثبت كونُها دارًا للإسلام لا تصير دارَ كفرٍ مطلقًا، وإن استولى عليها الكفارُ، واندرست منها معالمُ الدِّين. قال ابنُ حجر الهيتمي: “ما حُكم بأنّه دارُ إسلامٍ لا يصير بعد ذلك دارَ كفرٍ مطلقًا”. (98)
2- دار الإسلام لا تتحوّل إلى دار كفرٍ إلا باجتماعِ شروطٍ ثلاثةٍ تدلُّ على تمام القهر والغلبة للمشركين عليها، قال التّمرتاشي الحنفي: “لا تصيرُ دارُ الإسلامِ دارَ حربٍ إلا: بإجراء أحكام أهلِ الشّركِ، وباتّصالها بدارِ الحرب، وبأنْ لا يبقى فيها مسلمٌ أو ذميٌّ آمنًا بالأمانِ الأوّلِ. (99)
3- دار الإسلامِ لا تتحوّل إلى دارِ كفرٍ بمجرّد استيلاء الكفّار عليها، وإظهار أحكامهم فيها ما دام المسلمون يقيمون شعائرَ الإسلام فيها. قال الدّسوقي: “دار الإسلام لا تصير دارَ حربٍ بمجرَّد استيلائِهم عليها، بل حتى تَنقطعَ إقامةُ شعائرِ الإسلامِ عنه. (100)
4- دار الإسلام تتحول إلى دار كفر إذا استولى عليها الكفّارُ، وأظهروا أحكامَ الكفر فيها. قال الكاساني: “وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إنَّها تصيرُ دارَ الكفر بِظهورِ أحكامِ الكفرِ فيها… فإذا ظهرَ أحكامُ الكفر في دارٍ فقد صارت دارَ كفر”. (101)
5- الدّيارَ الإسلاميةَ التي استولى عليها الكفّارُ، وأظهروا فيها أحكامَهم، ولكن بقي أهلُها مِن المسلمين: لا تتحوّل إلى دار كفرٍ ولا تكون دارَ إسلام، بل تكون دارًا مركّبة مِن الأمرين. قال ابن تيمية عن ماردين: “فهي مركبة: فيها المعنيان؛ ليست بمنزلة دار السلم التي تجري عليها أحكام الإسلام؛ لكون جندها مسلمين؛ ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار؛ بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه”. (102)
والذي يظهر أنّه أقربُ لأصول الشّريعة ومقاصدها: أنَّ دارَ الإسلام لا تتحوُّل إلى دارِ كفرٍ إلا إذا غلب عليها الكفّارُ أو المرتدّون، وظهرت فيها أحكامُ الكفر، واندرست منها معالمُ الدّين وشعائرُ الإسلام الظاهرة، كالأندلس.
أمّا إذا لم تكن أحكامُ الكفر هي الظّاهرة، أو بقيت شعائرُ الإسلام ظاهرةً، والمسلمون هم أهل البلد: فلا تكون دارَ كفرٍ، ولو كان حكامُها وذوو السّلطان فيها لا يحكمون بشريعة الإسلام.
وبناءً على ما سبق: فإنّ البلادَ الإسلاميّةَ اليوم بمجملها دارُ إسلام، ولا يُخرجها عن ذلك ما فيها مِن حكمٍ بالقوانين الوضعية؛ فالحكم على الدّار ليس حكمًا بالضّرورة على السُّلطة الحاكمة لها. ويدلُّ على ذلك:
1- الأصل بقاءُ ما كان على ما كان، ولا يُنتقل عن حُكم الأصل حتى يثبت ما ينقله، قال الكاساني: “فلا تصيرُ دارُ الإسلامِ بيقينٍ دارَ الكفرِ بالشّكِّ والاحتمالِ، على الأصلِ المعهود: أنّ الثّابتَ بِيَقينٍ لا يزولُ بالشّكِّ والاحتمالِ”. (103)
2- أنّ الشّرعَ عدَّ الشّعائر الظّاهرة مِن العلامات الفارقة التي يُستدلّ بها على دار الإسلام.
ولاشكَّ أنّ ظهورَ شعائر الدّين كالآذان وصّلاة الجمعة والجماعة، والحضّ على فعلِها يدلُّ دلالةً واضحةً على تمكّن الإسلام في تلك الدّيار.
قال ابنُ رجب: “إنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل الآذانَ فَرْقَ ما بين دار الكفر ودار الإسلام، فإنْ سمع مؤذنًا للدّار… كفَّ عن دمائهم وأموالهم”. (104)
3- أحكامَ الكفّار ليست ظاهرةً في هذه البلاد، بل الظّاهرُ هو أحكام الإسلام، كتوحيد الله تعالى، ورفع الآذان، وبناء المساجد، وإقامة الجمع والجماعات، والدّعوة إلى الله وتعليم الدِّين، والصّوم، والحج، والحجاب، وأحكام الأسرة، والمعاملات وغيرها، ومِن الخطأ قصرُ أحكام الإسلام على الحدود والقوانين فهي جزءٌ مِن أحكام الإسلام، وليست كلَّه.
قال الحصكفي موضحًا معنى ظهور الأحكام: “ودارُ الحربِ تصيرُ دارَ الإسلامِ بإجراءِ أحكامِ أهلِ الإسلام فيها: كجمعةٍ وعيدٍ”. (105)
ثم إنّ “ظهور الأحكام “الذي هو مناطُ الحكم على الدّار: متفاوتٌ في الدّرجة، ومما تختلف به الأزمنة والأمكنة، فالعبرةُ بغلبة الأحكام الشّرعية على أهل الدّار، وظهور الشّرائع بينهم، مع مراعاة اختلاف الأزمنة والعصور، وحال التَّمكُّن والاضطرار.
4- التّغيُّرَ الحاصل للأحكام الشّرعية ليس كاملًا، ولا غالبًا، فالأحكامُ الشّرعيةُ تُطبّق ويُقضى بها في أحكام الأسرة والأحوال الشّخصية عمومًا، وما يتعلق بالشّؤون الإسلامية والأوقاف، وكثير مِن المعاملات المالية تحت ما يُعرف بالقانون المدني. فتطبيقُ هذه الأحكام وظهورُها مع بقاء غالب الشّعائر الإسلامية، ومظاهر الدّين في المجتمع، وسعي المسلمين لتطبيق دينهم، والدّعوة إليه، ومدافعة ما يخالفه: كافٍ في بقاء وصف الإسلام للدّار.
5- مَن قال مِن الفقهاء إنّ دارَ الإسلام تتحوّل إلى دار كفر بظهور أحكام الكفر فيها، إنّما مرادُه بذلك استيلاء الكفار على الدّيار، وفرض سيطرتهم الكاملة عليها مع تعطيل الشّعائر الإسلامية، وتطبيق الأحكام الجاهلية بحيث يكون لهم الحكم والأمر والنّهي، وليس مجردَ تطبيق بعض أحكام الكفر كالقوانين الوضعية؛ فمِن الخطأ أنْ يُنزّل هذا الحكم على بلادٍ الغلبةُ فيها والسّلطانُ للمسلمين.
جاء في “الفتاوى الهندية” :”وصورةُ المسألةِ على ثلاثةِ أوجهٍ: إمّا أن يغلب أهلُ الحرب على دارٍ مِن دُورنا، أو ارتدّ أهلُ مصرٍ وغَلَبوا وأجروا أحكامَ الكفر، أو نقض أهلُ الذّمّةِ العهدَ، وتغلّبوا على دارهم”. (106)
وواضحٌ أنّ هذه الصّورَ لا تنطبق على بلاد المسلمين اليوم، فظهر بذلك اختلافُ هذه الصّوَر عن البلاد الإسلامية التي تُحكم بالقوانين الوضعية في بعض الجوانب أو معظمها.
المسألة الثانية: القولُ بتحوّل جميعِ بلاد المسلمين إلى دارِ كفرٍ مِن الأقوال المنكرة المخالفة للشّريعة، ولا يتّفق مع أيٍّ مِن أقوال أهلِ العلم السّابقة في تحوُّل دار الإسلام إلى دار الكفر. لا سيما وأنّ القائلين بأنّ ديارَ المسلمين اليوم دارُ كفرٍ لا يستثنون شيئًا مِن البلاد، ولا حتى مكة والمدينة، مع أنَّ الأدلة الشرعية، وأقوال أهل العلم دلَّت على بقاء الحرمين دارَ إسلامٍ إلى يوم القيامة.
قال ابن حجر عن حديث (لا هجرة بعد الفتح): “تضمّن الحديثُ بشارةً مِن النبي صلى الله عليه وسلم بأنّ مكةَ تستمرُّ دارَ إسلامٍ”، وقال: “وفي الحديث بشارةٌ بأنَّ مكةَ تبقى دارَ إسلامٍ أبدًا. (107) وقال النّووي: “وهذا يتضمّن معجزةً لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها تبقى دارَ الإسلامِ، لا يُتصوّر منها الهجرةُ”. (108)
المسألة الثالثة: اتفق أهلُ العلم على أنّ العصمةَ تتعلّق بالسّكان، لا بالدّور، فالمسلمُ معصومُ الدّم والمال سواء كان في دار الإسلام أو دار الكفر. قال الإمامُ الشّافعي: “وإنّما يحرم الدّمُ بالإيمان كان المؤمنُ في دار حربٍ أو دار إسلامٍ. (109) وقال ابنُ تيمية: “دماءُ المسلمين وأموالُهم محرّمةٌ حيث كانوا”. (110)
فلا تلازمَ بين الحكمِ على الدّار وبين الحكمِ على السّكّان مِن حيث الإيمان والكفر، فقد تكون الدارُ دارَ إسلام ومعظمُ أهلِها مِن غير المسلمين، كحال خيبرَ بعد فتحها، وكذلك مصر التي كان يسكنها الأقباط بعد فتحها في زمان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وقد تكون دارَ كفرٍ مع أنّ كثيرًا مِن سكانها مِن المسلمين كبعض المدن والأحياء التي يكثر فيها المسلمون في بلاد الغرب.
وبالتالي فجميع ما بنوه من أحكام على هذه المسألة –لو صح قولهم- باطل ومردود، (111) وسيأتي مزيد بيان لأهم مسائله.
ثالثًا: تكفير العاملين في الحكومات بمقتضى الطاعة الشركية
بنى الغلاة العديد من أحكام التكفير على فكرة: أنَّ من أطاع هؤلاء المرتدين في قوانينهم وإداراتهم فقد وقع في عبادتهم من دون الله، وصيرهم طواغيتًا، وهو بذلك قد وقع في الشرك، فخرج من الإسلام. وهذا الإطلاق غير صحيح: فطاعة المخلوق وتقديمها على طاعة الله ورسوله مِن بشرٍ، أو هوىً، أو غيره ليست على حالٍ واحد، فتارةً تكون كفرًا مخرجًا مِن الملّة، وتارة تكون معصية، ومِن كلام أهل العلم في ذلك:
قال ابنُ العربي: “إنّما يكون المؤمنُ بطاعة المشركِ مشركًا إذا أطاعه في اعتقادِه الذي هو محلُّ الكفر والإيمان؛ فإذا أطاعه في الفِعلِ، وعَقْدُه سليمٌ مستمرٌّ على التّوحيد والتّصديق فهو عاصٍ”. (112) وقال ابنُ تيمية: “هؤلاء الذين اتّخذوا أحبارَهم ورهبانهم أربابًا حيث أطاعوهم في تحليلِ ما حرّم اللّهُ، وتحريم ما أحلّ اللّهُ يكونون على وجهين: أحدهما: أنْ يعلموا أنّهم بدّلوا دينَ اللّه فيتبعوهم على التّبديل، فيَعتقدون تحليلَ ما حرّم اللّه، وتحريمَ ما أحلّ اللّه؛ اتباعًا لرؤسائهم، مع علمهم أنهم خالفوا دينَ الرّسل، فهذا كفرٌ، وقد جعله اللّهُ ورسولُه شركًا. والثاني: أن يكون اعتقادُهم وإيمانُهم بتحريم الحلالِ، وتحليل الحرام ثابتًا، لكنّهم أطاعوهم في معصية اللّه، كما يفعل المسلمُ ما يفعله مِن المعاصي التي يعتقد أنّها معاصٍ، فهؤلاء لهم حكمُ أمثالهم مِن أهل الذّنوب”. (113) فاتّباعَ المخالفين للشرع وطاعتهم ليس كفرًا مخرجًا من الملّة على كل حال، فضلاً عن أنَّ العمل في الحكومات القائمة لهم أحكام مختلفة ستأتي الإشارة لها في الفقرة التالية.
رابعًا: حكم العمل في الأنظمة والحكومات في العالم الإسلامي
على فرض أنَّ الحكومات في العالم الإسلامي كافرة فإنَّ الحكم بتحريم العمل فيها بإطلاق فضلًا عن تكفير هؤلاء الموظفين هو من الغلو والجهل في الدين: فقد يجوز للشخص أن يتولى ولايات أو وظائف في حكومات تحوي مبادئ مخالفة للشريعة إذا ترتب على عمله مصلحة للمسلمين، وعلى هذا كلام أهل العلم قديمًا وحديثًا، فقد سئل ابن تيمية عن رجل متولٍ ولاياتٍ، وعليه التزاماتٌ بأخذ المكوسِ المحرمة، ولا يستطيع منعَ كلِّ المظالم، مع اجتهاده في ذلك قدر الاستطاعة، فقال: “إذا كان مجتهدًا في العدل، ورفع الظلم بحسب إمكانه، وولايتُه خيرٌ وأصلُح للمسلمين مِن ولاية غيرِه، واستيلاؤه على الإقطاع خيرٌ مِن استيلاء غيره كما قد ذُكر، فإنه يجوز له البقاءُ على الولاية والإقطاع، ولا إثمَ عليه في ذلك، بل بقاؤه على ذلك أفضلُ مِن تركه إذا لم يشتغل إذا تركه بما هو أفضلُ منه، وقد يكون ذلك عليه واجبًا إذا لم يقم به غيرُه قادرًا عليه ، فنشرُ العدل بحسب الإمكان، ورفعُ الظلم بحسب الإمكان فرضٌ على الكفايةِ، يقوم كلُّ إنسانٍ بما يقدر عليه مِن ذلك إذا لم يقم غيرُه في ذلك مَقامه، ولا يُطالب والحالةُ هذه بما يعجِز عنه مِن رفع الظّلم، وما يقرّره الملوكُ مِن الوظائف [الضرائب] التي لا يمكنُه رفعُها لا يُطالبُ بها”. (114)
وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: “فعلى هذا؛ لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفَّار، وعمِلوا على جعْل الولاية جمهوريَّةً يتمكَّن فيها الأفرادُ والشعوب مِن حقوقهم الدِّينيَّة والدُّنيويَّة، لكان أَوْلَى مِن استسلامهم لدولةٍ تَقضي على حقوقهم الدِّينيّة والدُّنيويّة، وتحرِصُ على إبادتها، وجعْلِهم عملةً وخدمًا لهم، نعمْ إنْ أمكن أنْ تكون الدولةُ للمسلمين وهم الحُكَّام، فهو المتعيِّنُ، ولكن لعدم إمكان هذه المرتبةِ فالمرتبةُ التي فيها دفْعٌ، ووقاية للدِّين والدُّنيا مُقدَّمةٌ، والله أعلم”. (115)
وقد صدرت فتاوى عديدة لأهل العلم من هيئات شرعية ومشايخ تناولت قضايا الدخول في الانتخابات التي تجري في دول المسلمين وغير المسلمين، وقد ذهب العديد منهم إلى جواز ذلك بشروط، بينما ذهب فريق آخر إلى المنع من ذلك، مع اتفاق الطرفين على أنَّ التصويت لا يستلزم الإقرار بالكفر، والرضا به. (116) ومن المعلوم أنَّ في تولي بعض هذه الولايات والوظائف لمن يتولاها بشرط الإصلاح أو التخفيف من الضرر الكثير من المصالح التي لا تستقيم حياة الناس دونها، ولو اعتزل الصالحون والمصلحون العمل في هذه الوظائف والمناصب لأصبحت مرتعًا للصوص والفسقة والباحثين عن مصالحهم الخاصة، وهذا ما يضر بعامة المسلمين. وهذا في الوظائف العليا في الحكومات، أما الوظائف الأقل مرتبة فالأمر فيها أهون، بل هي آكد أن يبادر إليها أهل العدل والصلاح، كوظائف التعليم، والقيام بشؤون الناس صحةً، وأمنًا وغير ذلك. (117)
وبناءً على النقاط السابقة: يتبيَّن أن أحكام التكفير التي تطال العاملين في الحكومات من موظفين وجنود وغير ذلك هي أحكامٌ باطلة، وما بُني عليها من جواز الاستهداف والقتل باطل كذلك.
خامسًا: تكفير الجيوش ومنتسبي الأجهزة الأمنية
وقد بنوا التكفير على عدة أمور أهمها: الحكم بغير ما أنزل الله، وطاعة الحكام في الحكم بغير ما أنزل الله، وموالاة الحكومات المرتدة، وقد سبق بيان بعضها. وكذلك التكفير بالطائفة الممتنعة، وفيما يلي الإجابة عنها:
المسألة الأولى: المقصود بالطائفة الممتنعة
جماعة تترك شريعة من شرائع الإسلام المعلوم ثبوتها، ويكون بين أفرادها تناصُرٌ وولاء على ذلك، ولها شوكة ومنعة. قال ابن تيمية: “كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة”. (118) ويُطلق اسم الطائفة الممتنعة في كلام أهل العلم على فرق أو جماعات تؤسس على مخالفة أحكام الشرع والامتناع عنها، سواء كانوا داخل الدولة المسلمة، كفرق الزنادقة والباطنية، ومانعي الزكاة والمرتدين في عصر الصحابة، ونحوهم، أو خارجها كالتتار الذين غزوا بلاد المسلمين.
فهل يُعدُّ الجيش والأجهزة الأمنية في البلاد الإسلامية طائفة ممتنعة؟
من أخطاء الغلاة قياس الجيش والأجهزة الأمنية على الطائفة الممتنعة في الاسم؛ فالجيش والأجهزةُ الأمنية ليسوا طائفة دينيةً أو عقدية، بل هي مؤسسات خدميةٌ، لم يؤسسوا على الامتناع عن الشريعة، بل على أداء مهام وظيفية معينة، وهم جزء من الدولة التي يتبعون لها. وفي حال ثبوت كفر الحكومة والنظام، فإنها تعامل معاملة الحاكم المرتد كما ذكره أهل العلم.
المسالة الثانية: حكم الطائفة الممتنعة
يتعلق بامتناع طائفةٍ ما عن الامتثال لأحكام الشرع عدة أحكام، بيانها كما يلي:
1- قتالها حتى تنزل إلى الشرع. قال ابن العربي: “اتفقت الأمة على أن من يفعل المعصية يحارب، كما لو اتفق أهل بلد على العمل بالربا، وعلى ترك الجمعة والجماعة”. (119)
2- هل يُحكم بكفر الطائف الممتنعة لمجرد امتناعها وقتالها؟ (120)
امتناع طائفة عن التحاكم للشرع وقتالها عليه لا يقتضي الحكم بالكفر بإطلاق؛ فقد جعل أهل العلم قتال العصاة والبغاة والخوارج من قتال الطائفة الممتنعة عن الشرع: قال ابن تيمية: “أجمع علماء المسلمين على أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها، حتى يكون الدين كله لله، فلو قالوا: نصلي ولا نزكي… أو قالوا لا نجاهد الكفار مع المسلمين، أو غير ذلك من الأمور المخالفة لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، وما عليه جماعة المسلمين، فإنه يجب جهاد هذه الطوائف جميعاً، كما جاهد المسلمون مانعي الزكاة، وجاهدوا الخوارج وأصنافهم وجاهدوا الخرمية والقرامطة والباطنية… ولهذا تأول السلف هذه الآية [يقصد آية الحرابة] على الكفار وأهل القبلة، حتى أدخل عامة الأئمة فيها قطاع الطريق الذين يشهرون السلاح لمجرد أخذ الأموال، وجعلوهم بأخذ أموال الناس بالقتال محاربين لله ورسوله ساعين في الأرض فساداً، وإن كانوا يعتقدون تحريم ما فعلوه، ويقرون بالإيمان بالله ورسوله…”. (121)
المسألة الثالثة: أنَّ تكفير العسكر والجنود في حكومات الدول الإسلامية مخالف لطريقة أهل العلم، ومن الأمثلة على ذلك: موقف ابن تيمية من الجنود الذين يقاتلون في صفوف التتار. فإن موقفه من التتار واضح في الحكم بكفرهم عمومًا. (122) لكنه لم يجعل مجرد مناصرة التتار ومظاهرتهم كفرًا مخرجا من الملة، فلم يحكم على كل عسكرهم المقاتلين معهم بالكفر، بل ذكر أنَّ فيهم مسلمين، ومن ذلك قوله: “وغاية ما يوجد من هؤلاء يكون ملحدًا نصيريًا، أو إسماعيليًا أو رافضيًا، وخيارهم يكون جهميًا إتحاديًا أو نحوه، فإنه لا ينضم إليهم طوعًا من المظهرين للإسلام إلا منافق أو زنديق أو فاسق فاجر”. (123) فهو لا يجعل مجرد مناصرة التتار ومظاهرتهم وتقوية جانبهم كفرًا أكبر؛ إذ لو كان الأمر كذلك عنده لحكم على كل من عاونهم بالخروج من الإسلام. (124)
سادسًا: الخروج بالسلاح
مما قرَّره أهل العلم أنَّ من وسائل التعامل مع الحاكم الكافر الخروج عليه بالسلاح، عملًا بوصيته صلى الله عليه وسلم: (وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ). (125) قال القاضي عياض: “أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل… ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل، إن أمكنهم ذلك”. (126) إلا أنَّ الغلاة وقعوا في أخطاء عديدة في تعاملهم مع هذه المسألة:
الأولى: الحكم على أعيان جميع الحكام والحكومات بالكفر، وقد سبق.
الثانية: إسقاط شرطي الاستطاعة والنظر في المآلات في التعامل مع هذه المسألة.
الثالثة: الزعم أنَّ كل عمل غير هذا الخروج هو من العبث، بل خيانة الدين!
أما إسقاط شرط الاستطاعة، فقد أسقطوه من أدبياتهم وأعمالهم، مع أنه شرط أكَّد عليه الشّارع، وذكره أهل العلم في العديد مِن المواضع، وخاصة في باب السّياسة الشّرعية. قال العز بن عبد السلام: “التَّولي يوم الزحف مفسدة كبيرة، لكنه واجب إذا علم أنه يُقتل من غير نكاية في الكفار، لأنَّ التغرير بالنفوس إنما جاز لما فيه من مصلحة إعزاز الدين بالنكاية في المشركين، فإذا لم تحصل النكاية وجب الانهزام لما في الثبوت من فوات النفوس مع شفاء صدور الكفار، وإرغام أهل الإسلام وقد صار الثبوت ههنا مفسدة محضة ليس في طيها مصلحة”. (127)
والمتتبع لأعمال هذه الجماعات وتاريخها يجد أنها لم تكن في جميع عملياتها مستطيعةً ولا قادرة، ولم تحقق شيئًا من أهدافها، وغاية عملياتها بضعة قتلى بما لم يؤثر في أركان الحكم ولا السلطات. ومهما ادعت هذه الجماعات أنها قادرة فالتجارب التي خاضتها في عدد من البلدان وعلى مر عشرات السنين تكذبها. (128) ومن قال بالاستطاعة منهم فإنه قد جعل من نفسه وجماعته مقياسًا لهذه المسألة؛ لهذا عظَّموا مقولة (لا يفتي قاعدٌ لمجاهد)، لإسقاط أهل العلم ممن لم يحمل السلاح، واستفتوا الجهال ومدعي العلم، مع أنَّ هذه المقولة ليست مِن القواعد الفقهية، ولا الأصول الشّرعية التي يُعرف بها الحقُّ. (129)
وأما شرط النظر في المآلات، فقد قال الشاطبي: “النّظر في مآلات الأفعال معتبرٌ مقصودٌ شرعًا كانت الأفعال موافقةً أو مخالِفةً، وذلك أنّ المجتهد لا يَحكم على فعلٍ مِن الأفعال الصّادرة عن المكلفين بالإقدام أو الإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعلُ مشروعًا لمصلحةٍ فيه تُستجلب، أو لمفسدة تُدرأ”. (130)
ومِن آثار هذه البدعة: بدعةٌ أشدُّ خطرًا منها، وأعظم جرمًا، وهي استجلاب الأعداء لبلاد المسلمين لقتالهم وإنزال الخسارة بهم، كما يزعمون. وعلى الرغم من فشل هذه الطريقة في القتال، فهي محرمة شرعًا، بل هي من أعظم المخالفات الشّرعية، والكوارث التي يمكن أن تحل ببلاد المسلمين، وذلك لما يلي:
1- جلب الحرب والخراب لبلاد المسلمين، مخالفة للأمر الشرعي بالدفاع عن بلاد المسلمين، وتجنيبها الأعداء، فقد بذل النبي للدفاع عن المدينة جهده تارة بالخروج للقتال، وتارة بحفر الخندق، وتارة بعقد الهدن، واستجلابُ الكفّار يتضمّن تسليطهم على رقاب المسلمين بالقتل، وعلى أموالهم بالنهب، وعلى أعراضهم بالهتك، وعلى بلادهم بالتّدمير، ثمّ تكون المعركة أكبر مِن أولئك الأغرار فيهربون إلى بلادٍ أخرى، ويتركون المسلمين لمصيرهم! مع سلامةِ بلاد الكفار مِن كوارث هذه الحروب.
2- مخالفة الأمر النبوي في عدم استجلاب الحرب ودفعها:
قال صلى الله عليه وسلم: (أيّها النّاسُ، لا تتمنّوا لقاء العدوّ، وسَلوا الله العافيةَ، فإذا لقيتموهم فاصبروا). (131) وقال عليه السلام: (لا ينبغي لمؤمنٍ أنْ يذلَ نفسَه، قالوا: وكيف يذلُ نفسَه؟ قال: يتعرّض مِن البلاء لما لا يطيق). (132) وليس هناك أعظم من تعريض البلاد بأهلها، ودينها، وخيراتها للعدو المحتل الغاصب.
وإذا كان الغلاة يُشدِّدون على أنَّ إعانة الكافرِ على المسلمِ في معركةٍ ما كفرًا أكبر مخرجًا من الملة، فكيف بتسليط الكفار على المسلمين، وتمكينهم من أرضهم، وتعريضهم للقتل، وانتهاك الأعراض، وضياع الثروات، وتغييرِ هويةِ البلاد؟ لا شك أنَّ ذلك أشدّ مِن مجرد إعانة الكفار على المسلمين!
وأما زعمهم أنَّ كل عمل غير حمل السلاح هو من العبث أو خيانة الدين: فهذا من الغلو والجهل؛ فالجهادُ أنواعٌ عديدة لا تقتصر على حمل السلاح، وحتى إن كان الجهاد واجبًا جوبًا عينيًا فليس المطالب من كل أحدٍ أن يحمل السلاح أو يكون خائنًا جبانًا! والمجتمعات فيها المقاتل الذي يحتاج لخدمة في طعامه وإصلاح سلاحه وعلاجه، وغير المقاتل من عامة السكان والنساء والأطفال والمرضى والجرحى بحاجة لمن يقوم عليهم بالرعاية وتسيير الحياة، والتعليم، والطبابة، والتجارة، كما يحتاجون جميعًا للقاضي والعالم، وغير ذلك.
وإنما جاء هذا الخطأ من الجهل بمعاني النصوص الشرعية، وتعظيم النفس والمنهج. فما جاء في الأحاديث أنَّ أفضل الأعمالِ الجهادُ، كحديث: (قيل: يا رسولَ الله أيُّ النّاسِ أفضلُ؟ فقال رسولُ الله: مؤمنٌ يجاهد في سبيل الله بنفْسِه وماله)، (133) وهو لا يعني أفضليةَ الجهاد والمجاهد على الإطلاق، قال العيني: “قالوا: هذا عامٌ مخصوصٌ، تقديرُه: هذا مِن أفضل الناس؛ وإلا فالعلماءُ أفضل، وكذا الصّدّيقون كما جاءت به الأحاديث”. (134)
سابعًا: إيجاب إقامة الدولة الإسلامية
جعل الغلاة إقامة الدولة من أهم الفروض والواجبات؛ لغياب دار الإسلام ودولة الإسلام عن الوجود بزعمهم، وقد أخطأوا في فهم كلام أهل العلم، ومن ذلك استدلالهم بقول ابن تيمية: “يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين؛ بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها… ولأن الله تعالى- أوجبَ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم، وإقامة الحدود، لا تتم إلا بالقوة والإمارة”. (135)
واستدلالهم بهذه المقولات على معتقدهم غير صحيح، وفيه خلط بين عدة أمور: فكلام ابن تيمية هذا –ومثله كثير في كتب السياسة الشرعية- في أصل إقامة الدّول، ومعناه: أنَّ حياة الناس لا تستقيم إلا بدولة وحاكم؛ وإلا شاعت الفوضى وانعدم الأمن، وهذا صحيحٌ لا ينازع فيه أحدٌ مِن المسلمين ولا غيرهم. لكن هذا يكون في حال التمكين واستقرار الأحوال. أما في حال جهاد الدفع: فإنَّ لا يشترط إقامة دولة، ولا إمارة، ولا إذن حاكم، بل يكفي أن يقيم الناس أمراء وقادة (وهم أصحاب الولايات الخاصة) لينتظم أمر القتال، وينزَّل هؤلاء الأمراء مكان الحاكم، ويحكمون بين الناس بما يستطيعونه ويضطرون إليه من أحكام الدين. (136) قال أبو المعالي الجويني: “لو خلا الزّمانُ عن السّلطان فحقٌّ على قُطّان كلّ بلدةٍ، وسكّان كلِّ قريةٍ، أنْ يقدّموا مِن ذوي الأحلام والنُّهى، وذوي العقول والحِجا مَن يلتزمون امتثالَ إشاراته وأوامره، وينتهون عن مناهيه ومزاجره؛ فإنّهم لو لم يفعلوا ذلك، تردّدوا عند إلمام المهمّات، وتبلّدوا عند إظلال الواقعات”. (137) والجهادُ في العالم الإسلامي اليوم هو جهادُ دفعٍ للصّائل المعتدي، ولا يُشترط فيه إلا ما قرَّره أهلُ العلم، ودلَّت عليه النّصوص الشّرعية.
ثامنًا: التكفير بالموالاة
ينطلق الغلاة في غالب أحكامهم من التكفير بموالاة الكفار، وهم في ذلك مرتكبون لعددٍ من الأخطاء المنهجية:
المسألة الأولى: من المقرَّر عند أهل السنة أنه عند ورود نصٍ من نصوص الوعيد يجب ضمه لبقية النصوص في المسألة، وفهمها وفق منهج أهل العلم. ومن نصوص الوعيد تلك:
– التحذير من حمل السلاح ضد الأخ المسلم، قال صلى الله عليه وسلم: (مَن حمل علينا السّلاح فليس منّا). (138)
– التحذير من إيذاء الجار، قال صلى الله عليه وسلم: (لا يدخل الجنّة مَن لا يأمن جارُه بوائقَه). (139)
– التحذير من التّشبه بالكفار، قال صلى الله عليه وسلم: (مَن تَشَبَّه بقومٍ فهو منهم). (140)
فمعنى (فليس منا): “ليس مِن المطيعين لنا، ولا مِن المقتدين بنا ولا مِن المحافظين على شرائعنا”. (141)
ومعنى (لا يدخل الجنة): قال ابن حجر: “فيه نفيُ الإيمان عمّن يؤذي جاره بالقول أو الفعل، ومرادُه الإيمانُ الكامل، ولا شكّ أنّ العاصي غيرُ كامل الإيمان”. (142) ومعنى (فهو منهم): قال المناوي: “مَن تشبّه بالصّالحين وهو مِن أتباعهم يكرم كما يكرمون، ومن تشبه بالفساق يهان ويخذل كَهُم”. (143) وقد يصل حكم هذه المخالفات إلى الكفر في حالات:
قال ابن تيمية في حديث النهي عن التشبيه: “فقد يُحمل هذا على التّشبّه المطلق فإنّه يوجب الكفرَ، ويقتضي تحريمَ أبعاض ذلك. وقد يُحمل على أنّه منهم في القدرِ المشترك الذي شابههم فيه، فإن كان كفرًا، أو معصية، أو شعارًا لها كان حكمه كذلك”. (144) ونصوص الموالاة للكفار من نصوص الوعيد هذه، فمن فرَّق بين هذه النّصوص فقد فرَّق بين متماثلين دون دليلٍ صحيح.
المسألة الثانية: ادعاء أن الموالاة نوعٌ واحد، وأنها كفرُ أكبر مخرج من الملة بالإجماع بإطلاق غير صحيح. فقد ثبت من كلام أهل العلم النص على أنَّ الموالاة إمّا أن تكون على الدّين، فتكون حينها كفرًا أكبر. وإمّا أن تكون على غير الدّين مِن الأمور الماديّة والدّنيوية المختلفة، وهي معصية غير مخرجةٍ من الدين. وهذا هو قول عامة أهل العلم المتقدمين، ومحلّ خلافٍ لبعض أهل العلم المتأخرين. فمن أقوال المتقدمين:
قول الإمام الطبري عند تفسير قوله تعالى: {لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً} [آل عمران: 28]: “لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفارَ ظهرًا وأنصارًا توالونهم على دينِهم، وتظاهرونهم على المسلمين مِن دون المؤمنين، وتدلّونهم على عوراتهم؛ فإنّه مَن يفعل ذلك، فليس مِن الله في شيءٍ، يعني بذلك: فقد برئ مِن الله، وبرئ اللهُ منه بارتداده عن دينه، ودخوله في الكفر”. (145)
وقول الماوردي “{وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فِإِنَّهُ مِنْهُم} يحتمل وجهين: أحدهما: موالاتهم في العهد فإنّه منهم في مخالفةِ الأمر. والثاني: موالاتهم في الدّين فإنّه منهم في حكم الكفر، وهذا قول ابن عباس”. (146) ومن أقوال المعاصرين: قول ابن عاشور عن قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ}: “وقد تَأَوَّلَهَا المفسرون بأحد تأويلين: إما بحمل الولاية في قوله: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ} على الولاية الكاملة التي هي الرّضا بدينهم، والطّعن في دين الإسلام.. وإمّا بتأويل قوله: {فَإِنَّهُ مِنْهُم} على التَّشبيه البليغ، أي فهو كواحدٍ منهم في استحقاق العذاب…. وقد اتّفق علماء السنّة على أنّ ما دون الرّضا بالكفر، ومُمالَأَتِهِم عليه مِن الولاية لا يوجب الخروجَ من الرِّبقةِ الإسلامية”. (147)
وقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: “مسمّى الموالاة يقع على شعبٍ متفاوتة، منها ما يوجب الرّدّة وذهاب الإسلام بالكليّة، ومنها ما هو دون ذلك مِن الكبائر والمحرّمات”. (148) ومن أخطاء الغلاة في هذا الجانب: الاقتصار على بعض أقوال أهل العلم المتأخرين والزعم أنَّه القول الوحيد في المسألة، أو الاعتماد على كلام بعضهم المجمل وترك كلامهم المفصَّل في حالة أخرى.
ومن أهم أخطاء الغلاة في مسألة الموالاة: تفسير مختلف تصرفات مخالفيهم بأنها موالاة، فيقولون: من تولى عملًا أو منصبًا في الأنظمة التي يكفرونها فهو موالٍ لهم، ومن استعان بنظامٍ يكفرونه على بعض مجرميهم فهو موالٍ لهم، ومن دخل في منظومةٍ دولية سياسية أو عسكرية فهو موالٍ للكفار، ومن دخل في حلفٍ دولي أو إقليمي فهو موالٍ للكفار والمرتدين، وهكذا. وهذه الأحكام بينة البطلان؛ فالموالاة قدر زائد عن مجرد الاستعانة، والإعانة، أو التعامل مع الكفار، ولا تلازمَ بينها. (149)
تاسعًا: التكفير بالرضا بالكفر
مِن بدع الغلاة المعاصرين: الحكم على كل من لم يوافقهم أنه راضٍ بالكفر، فمن دعا لإقامة دولةٍ ضمن الحدود الحالية فهو راضٍ بتقسيم الكفار لبلاد المسلمين، ومن تحاكم إلى محاكم كفرية فهو راضٍ بالطاغوت، وهكذا، وهذا تلازم باطلٌ ومردود؛ فالرّضا هو الإقرار للكافر على كفره وتصحيح ما هو عليه، وهو أمرٌ زائدٌ على مجرّد الفعل، ولا يلزم أن يكون موجودًا مع كلّ فعل.
فقد نهى الله المؤمنين عن الجلوس مع أهل الكفر في مجالسهم التي يخوضون فيها بالباطل، قال تعالى: {إِذا سَمِعْتُمْ آيَات الله يكفر بهَا ويستهزأ بهَا فَلَا تقعدوا مَعَهم حَتَّى يخوضوا فِي حَدِيث غَيره إِنَّكُم إِذا مثلهم} [النساء: 140]. قال الطبري: “فأنتم إذًا مثلهم في ركوبكم معصية الله، وإتيانكم ما نهاكم الله عنه”. (150) لكن هذا الجلوس يصبح كفرًا إذا كان معه قبولٌ بما يقولونه، قال الواحدي: “وقوله: {إنكم إذا مثلهم} يعني: إن قعدتم معهم راضين بما يأتون مِن الكفر بالقرآن والاستهزاء به”. (151) وقد سبق بيان أنَّ طاعة المخلوق في مخالفة حكم الشرع قد تكون معصية لا كفرًا؛ وحينها لا تكون رضًا بمخالفة الشرع، بل وقوع في معصيةٍ لأجل الهوى أو الشهوة وغير ذلك.
عاشرًا: قتل المسلمين بحجة التترس
تُجيز جماعات الغلو قتل المسلمين من عامة الناس في عملياتهم في الدول الإسلامية أو بلاد الكفار؛ بسبب وجودهم بالقرب من ثكنات الجنود أو حواجزهم، أو مرور الجنود أو دورياتهم في أحياء المسلمين، أو بالقرب منها، ويعدون من قتل منهم ترسًا. والإجابة عن ذلك كما يلي:
أنَّ التّترس الذي وردت به نصوص الشريعة، وأقوال أهل العلم هو: أن يمتنع العدو بغير المقاتلين ويتخذهم دروعُا بشرية، فلا يستطيع المجاهدون الدفاع عن أنفسهم إلا بإصابة هذا الترس، أو أن يكون المجاهدون في حال التحام مع العدو في القتال، فيتترس العدو بمن لا يجوز قتلُهم، وبذلك لا يَقْدِرُ المسلمون على قتالهم إلا بإصابة هؤلاء المتترَّس بهم، فأجاز أهل العلم إصابة ضرب الأعداء وإن أدى إلى إصابة بعض الترس بشرطين:
1- أن يكون ذلك لضرورة، بحيث لا يمكن الوصول للأعداء أو دفعهم إلا إذا أصابوا الترس، وإذا ترك قتال الأعداء خيف من ضرر أعظم على المسلمين..
2- عدم قصد الترس، وتحاشي إصابته ما أمكن.
قال ابن قدامة “وإن تَتَرَّسوا بمسلمٍ ولم تدعُ حاجةٌ إلى رميهم، لكون الحربِ غير قائمة، أو لإمكان القُدرة عليهم بدونه، أو للأمن من شَرهم لم يَجُز رميهم، فإن رماهم فأصـاب مسلمًا فعليه ضمانه، وإن دعت الحاجة إلى رميهم للخوف على المسلمين جاز رميهم، لأنَّها حال ضرورة، ويقصد الكفار”. (152) أما ما تذكره هذه الجماعات من أحكام التترس في جواز عملياتها التفجيرية فهو عكس التترس المشروع، ويناقض الأدلة الشرعية وأقوال أهل العلم:
1- التترس الذي ذكره الفقهاء هو ما كان في ساحة المعركة هجومًا أو دفاعًا. أما هذه التفجيرات: فإنها تستهدف الجنود في مقراتهم أو ثكناتهم أو دورياتهم، أو حواجزهم المنتشرة في بلاد المسلمين في غير وقت القتال أو التحام الصفوف.
2- في التترس المشروع: يتخذ الجنود غير المقاتلين ترسًا يحتمون بهم ويكرهوهم على البقاء معهم، فوجودهم بين المقاتلين بينهم طارئ غير معهود ولا أصلي. أما عمليات هذه الجماعات: فإنها تستهدف الجنود في قواعدهم، أو في نقاط تفتيشهم، وغير المقاتلين آمنون في حياتهم المعتادة، غير مختطفين ولا مرغمين، ووجود مقرات الجنود أو دورياتهم بين السكان لا يجعل السكان ترسًا حقيقة ولا عرفًا، فوجود الجنود بين السكان أمر شائع ومتعارفٌ عليه.
3- الأصل المتقرر عند الفقهاء القائلين بجواز رمي الترس أنَّه لا يجوز رميهم إلا في حال الضرورة استثناء من تحريم الاستهداف، وأن يُتقى ضرب الترس ما أمكن. أما هذه العلميات فلا ضرورة شرعية فيها؛ لإمكان استهداف الأعداء المحتلين خارج هذه المناطق سواء في الطرقات العامة أو الثكنات البعيدة ونحوها كما تفعل عامة الجماعات المجاهدة.
بالإضافة إلى أنَّ غالب من تستهدفهم هذه الجماعات هم من الأجهزة الأمنية لتلك الدول التي يحكمون عليها بالكفر، وقد سبق بيان بطلانه. أما اعتبار المسلمين في بلاد الكفار من التُّرس الذين يجوز قتلهم أثناء القيام بعمليات ضد الكفار بحجة نصب الرسول صلى الله عليه وسلم للمنجنيق على الأعداء، وأنَّ إقامتهم في بلاد الكفر محرمة، (153) فيجاب عنه بما يلي:
1- وجود المسلمين في بلاد الكفار لا يبيح دماءهم، بل دماؤهم معصومة محرمة، ولو كانت إقامتهم محرمة في بلاد الكفار، فهم باقون على هذا الأصل لا يتغير.
2- الرمي بما يعم يكون في حال الحرب ولا يستطيع المسلمون هزيمة الأعداء، أو فتح البلاد، فيجوز رمي الأعداء بما يعم، وتكون موجَّهةً للمحاربين، فإن سقط شيءٌ منها خطأ على غير المقاتلين وتسبب بقتله فهذا مما لا يؤاخذ فاعله، وهذا من طبائع الحروب ولوازمها.
3- عمليات هذه الجماعات لا تستهدف جنود الأعداء أو معسكراتهم، بل هي تستهدف غير المقاتلين بالأصل بحجة النكاية أو المماثلة، ولا وجود فيها لامتناع الجنود، ولا وتحصنهم، وسيأتي في الفقرة التالية.
4- أن هذا التترس هو عكس مسألة الترس الشرعية، والإخلال بشرط الاضطرار فيه. (154)
الحادي عشر: قتل غير المسلمين في البلاد الإسلامية وبلاد الكفار
اعتمد الغلاة على جواز القيام بعملياتهم ضد الكفار غير المقاتلين من زوار البلاد الإسلامية كالسياح، أو الإعلاميين، أو رجال الدين، وغيرهم، أو القيام بعمليات ضد الكفار في بلادهم بعد الدخول إليها في المطارات أو المحطات وغير ذلك على أنَّ هذه الدول محاربة للمسلمين، ولا أمان للمحارب؛ فالأمان المأخوذ منهم باطل لا أثر له، (155) وعلى أنَّ قتل هؤلاء هو من باب المعامل بالمثل. (156) والإجابة عن ذلك كما يلي:
المسألة الأولى: أما ما يتعلَّق ببطلان أمان هؤلاء الكفار
1- فكون بلادهم محاربة لنا لا أثر له في التعامل معهم؛ لأنه إن ثبت أنَّ هذه الدول محاربة فينصرف القتال إلى أهل القتال منها، لا إلى عموم أهلها بعمليات عشواء لا تفرق بينهم.
2- من المتقرر عند أهل العلم أنَّ الكافر المحارب إن أخذ الأمان من المسلمين ودخل بلادهم فإنه يحرم على المسلمين قتله أو إيذاؤه، وكذا إذا دخل المسلم بلاد الكفار المحاربين بعقد أمان فأنه لا يجوز له نقض هذا العقد والاعتداء عليهم.
قال الإمام الشافعي: “إذا دخل قوم من المسلمين بلاد الحرب بأمان فالعدو منهم آمنون إلى أن يفارقوهم أو يبلغوا مدة أمانهم وليس لهم ظلمهم ولا خيانتهم”. (157)
وقد نص أهل العلم على أن الأمان في الشرع ينعقد بكل ما يفيده لفظًا، أو كتابة، أو عرفًا؛ صريحًا أو كناية، مهما كان ضعيفًا تغليبًا لجانب حقن الدماء، ولم يشترطوا لذلك لفظًا أو صيغة أو طريقة، وقالوا: ينعقد ولو لم يقصده المسلم، ولو أُعطي خطأ، ولو كان الأمان غير مكتمل؛ لأنَّه فيه شبهة أمان فيُعامل معاملة المؤمَّن، قال ابن تيمية: “ومعلوم أن شبهة الأمان كحقيقته في حقن الدم”. (158)
ومن صور الأمان المعاصرة: دخول الكفار لبلاد المسلمين بتأشيرة إقامة أو زيارة، ومثله دخول المسلمين لبلاد الكفار بتأشيرة إقامة أو زيارة أو طلب لجوء، أو المرور في البلد بوسائل المواصلات كالطائرات والسيارات والقطارات والسفن وغيرها؛ لأنَّ فيها إذن دخول مشروط، فمن فعل شيئًا من ذلك فقد عقد بينه وبين الكفار أمانًا لا يجوز له نقضه. (159)
أما دخول بلاد الكفار لادعاء الزيارة، أو الدراسة، أو غير ذلك ثم القيام بهذه العمليات فهو من الخيانة والغدر ونقض الأمان.
3- استدلال الغلاة بحادثة قتل محمد بن مسلمة رضي الله عنه لكعب بن الأشرف على جواز نقض الأمان بعد إعطائه للكافر غير صحيح؛ فكلام أهل العلم يوضح خطأ فهمهم للحديث واستدلالهم به. فليس في حديث قتل كعب إعطاء له الأمان ثم الغدر به؛ بل هي مخادعة له وقتله بذلك، والخدعة في الحرب جائزة، فقد قال محمد بن مسلمة لكعب: “أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَشُمَّ رَأْسَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَشَمَّهُ ثُمَّ أَشَمَّ أَصْحَابَهُ، ثُمَّ قَالَ: أَتَأْذَنُ لِي؟ قَالَ: نعَمْ، فَلَمَّا اسْتَمْكَنَ مِنْهُ، قَالَ: دُونَكُمْ، فَقَتَلُوهُ، ثُمَّ أَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُوهُ”. (160) أخرج الطحاوي أنَّه: “ذُكر قتل ابن الأشرف عند معاوية فقال ابن يامين: كان قتله غدرًا. فقال محمد بن مسلمة: يا معاوية، أيُغدَّر عندك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم لا تنكر؟! والله لا يُظِلني وإياك سقف بيت أبدًا. (161) ونقل النووي عن المازري: “لا يحل لأحد أن يقول إن قتله كان غدرًا.. وإنما يكون الغدر بعد أمان موجود، وكان كعب قد نقض عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنه محمد بن مسلمة ورفقته، ولكنه استأنس بهم، فتمكنوا منه من غير عهد ولا أمان”. (162)
وما يُقال إنَّ ابن تيمية جاز نقض الأمان في حادثة كعب فغير صحيح، فقد قرر ابن تيمية أنَّ ما وقع لكعب هو خداع وليس أمانًا، فقال: “أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتالوه ويخدعوه بكلام يظهرون به أنهم قد آمنوه ووافقوه ثم يقتلوه، ومن المعلوم أن من أظهر لكافر أمانًا لم يجز قتله بعد ذلك لأجل الكفر”.
ثم ذكر أنَّ الأمان لا ينعقد لمن وجب قتلُه بعينه شرعًا لأنَّه كالحدود، فقال: “وإنما قتلوه لأجل هجائه وأذاه لله ورسوله ومن حل قتله بهذا الوجه لم يعصم دمه بأمان ولا عهد، كما لو آمن المسلم من وجب قتله لأجل قطع الطريق ومحاربة الله ورسوله والسعي في الأرض بالفساد الموجب للقتل …”. وعلى فرض التسليم بأنهم قتلوه بعد أمانه لأن مثله لا ينعقد له الأمان: فإنَّه لا ينطبق على المقتولين بهذه العمليات؛ لأن قتل عينهم لم يثبت بنصٍ شرعي، وهم ليسوا من أهل القتل ولا القتال أصلًا، ومن كان منهم من أهل القتال فهو من الكفار الحربيين الذين ينعقد أمانهم بالاتفاق.
4- قول الغلاة إنَّ الأمان الذي تعطيه الحكومات في الدول الإسلامية للكفار المحاربين باطل؛ لأنه صادر عن مرتدين، وأمان المرتد باطل، كلام مردود؛ لأنَّ عقد الأمان لا يبطل بردة الحاكم، وإلا لزم من ذلك بطلان جميع العهود والعقود التي تعقدها تلك الحكومات، وفي هذا فساد لتعاملات الناس، وإن قيل ببطلان الأمان لردة تلك الحكومة فيبقى لهؤلاء الكفار شبهة أمانٍ، وهذا كافٍ في عصمة دمائهم، وتحريم الاعتداء عليهم.
المسألة الثانية: قتل غير المقاتلين من باب المعامل بالمثل
نظرًا لما أشاعه أهل الغلو في هذه المسألة لابد من توضيح التالي:
أولًا: الأصل في النساء والأطفال أنَّهم ليسوا من أهل الحرب والقتال، فلا يجوز قتلهم، ولا الاعتداء عليهم، قال تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا} [البقرة: 1900]. قال ابن جرير الطبري: “إنما الاعتداء الذي نهاهم الله عنه هو نهيه عن قتل النساء، والذراري”. (163) وعن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (وُجِدَتْ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ). (164) قال النووي: “أجمع العلماء على تحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا”. (165)
ثانيًا: دلت أقوال أهل العلم على استثناء ثلاث حالات من منع القتل، كما يلي:
الحالة الأولى: الاشتراك في القتال حقيقةً أو حُكمًا، سواء بحمل السلاح، أو التحريض، أو التجسس، أو الإيقاع بالنساء المسلمات بما يؤدي لانتهاك أعراضهن أو قتلهن أو اعتقالهن. قال ابن قدامة: “من قاتل من هؤلاء أو النساء أو المشايخ أو الرهبان في المعركة قتل، لا نعلم فيه خلافًا”. (166)
الحالة الثانية: في حال التَّبييت والغارات الحربية إذا احتيج إليه؛ لعدم القدرة على التمييز بينهم وبين غيرهم من المقاتلين.
عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ، قَالَ: (سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الذَّرَارِيِّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ؟ يُبَيَّتُونَ فَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ؟، فَقَالَ: هُمْ مِنْهُمْ). (167) قال الخطابي: “يريد أنهم منهم في حكم الدين وإباحة الدم، وفيه بيان أن قتلهم في البيات وفي الحرب إذا لم يتميزوا من آبائهم وإذا لم يتوصلوا إلى الكبار إلاّ بالإتيان عليهم جائز”. (168)
ويدخل في هذا: رميهم بما يعم كالصواريخ والقاذفات والقنابل وغيرها، في حالة الحصار، أو ضرب المقرات؛ لأنَّه لا يمكن التمييز بين المقاتلين وغيرهم في هذه الحالات. قال ابن رشد”: “واتفق عوام الفقهاء على جواز رمي الحصون بالمجانيق، سواء كان فيها نساء وذرية، أو لم يكن؛ لما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام نصب المنجنيق على أهل الطائف”. (169)
الحالة الثالثة: إذا تَترَّس بهم العدو بحيث لا يَقْدِرُ المسلمون على مهاجمته في ثكناته أو حصونه أو آلياته أو أثناء انسحابه إلا بقتل هؤلاء المُتَتَرس بهم، فيجوز للمجاهدين ضرب هؤلاء المجرمين وإن أدى ذلك إلى قتل النساء والأطفال، بغير خلاف بين الفقهاء، مع تحاشي قصد ضرب النساء والأطفال ما أمكن.
ثالثًا: لا يكاد يوجد في كلام أهل العلم المتقدمين ما يدل على جواز قتل النساء والصبيان من باب المعاملة بالمثل، مع وجود الداعي له من كثرة الحروب والإجرام في حق المسلمين. وأما الاستدلال بقوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل: 126]، وقوله: {فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ} [البقرة:194]، على جواز قتلهم معاملةً بالمثل، فهو استدلال في غير محله، لأمور:
1- المماثلة في العقوبة: مشروطة بكونها لا تشتمل على معصية. قال الشوكاني”: “وقوله: (وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ) فيه دليل على أنه لا يجوز مكافأة الخائن بمثل فعله فيكون مخصصا لعموم قوله تعالى: {وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها}، وقوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ}، وقوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ}”. (170)
ولا شك أن قتل النساء والأطفال معصية، لثبوت النهي عنه بإجماع العلماء.
2- المماثلة في العقوبة تكون مع الجاني نفسه لا غيره، ولذلك استدل العلماء بهذه الآية على الاقتصاص من الجاني بمثل جنايته، ولا يراد منها الاعتداء على غير الجاني.
3- هذه الآيات نصوص مخصصَّةٌ بما سبق من أدلة عدم قتل النساء والأطفال.
4- قواعد ونصوص الشريعة دلت على أن المرء لا يجوز أن يُؤخذ بجريرة غيره، قال تعالى: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}، وقال صلى الله عليه وسلم في حجَّة الوداع: (أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ، أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ عَلَى وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ)، (171) ونساء الأعداء وأطفالهم لا يجوز أن يؤاخذوا بجريرة وأوزار آبائهم.
رابعًا: وأما الاستدلال بكون النصيرية “أهل ردة” أو “مرتدون” على جواز قتل النساء والأطفال، فيجاب عنه من وجوه:
1- أنَّ الصبيَّ المرتدَّ لا يجوز قتله عند عامة العلماء؛ لأنه ليس من أهل العقوبة. قال الغزالي عن النصيرية: “فإن قيل هَل يقتل صبيانهم ونساؤهم؟ قلنا: أما الصّبيان فلا، فإِنَّه لا يؤاخذ الصَّبي…”. (172)
2- أما قتلُ المرأة المرتدة
أ- فهو من المسائل الخلافية بين العلماء، فمنهم من أجاز قتلها وهم الجمهور، ومنهم من منع من ذلك، وهي من مسائل الاجتهاد التي يقرر فيها إمام المسلمين ما يراه مناسبًا وفق المصلحة الشرعية. قال الغزالي عن النصيرية: “فإن المرتدة مقتولة عندنا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (من بدَّل دينه فَاقْتُلُوهُ)”. (173)
ب- ومن قال بجواز قتلها قال بوجوب استتابتها، وهم جمهور أهل العلم، قال الماوردي: “إذا ظفر بأهل الردة لم يجز تعجيل قتلهم قبل استتابتهم، فإن تابوا حقنوا دمائهم بالتوبة، ووجب تخلية سبيلهم”. (174)
ج_ أن إقامة حكم الرِّدة من اختصاص الحاكم الشرعي، وليس لآحاد الناس تنفيذه حسب آرائهم وأهوائهم، وإلا انفتح باب من الشر يتعذر إغلاقه. قال ابن الهمام: “وقتل المرتد مطلقًا إلى الإمام عند عامة أهل العلم”. (175)
وعلى هذا جاءت أقوال أهل العلم في النصيرية؛ فإنَّه لم يُنقل عن أحد منهم أنه أفتى الجنود والعساكر الإسلامية بقتل نساء النصيرية دون إذن الحاكم. والكتائب في سوريا ليست حاكمًا ولا تأخذ أحكامه في هذه المسائل. وما سبق هو بناء على القول بردَّتهم، وإلا فمن أهل العلم من يرى أنهم في حكم الكفار الأصليين، وليس هذا مجال تفصيل ذلك. (176)
وعليه: فإنَّ عمليات استهداف المسلمين وغير المسلمين من عامة الناس بالقتل بحجة التترس أو المماثلة في الانتقام باطلة لا صحة لها.
الثاني عشر: جماعة الحق و”الطائفة المنصورة”
المسألة الأولى: المقصود بالجماعة شرعًا
ورد في الشّرع الأمرُ بلزوم جماعة المسلمين، وعدمِ الشّذوذ عنها باعتقادٍ، أو قولٍ، أو عملٍ؛ لذا كان مِن خصائص أهل السنة: الاجتماعُ على الحقِّ، ولزومُ الجماعة المتمسكة به، والنصوص في ذلك كثيرة. والمقصودُ بجماعة المسلمين: سوادُهم الأعظمُ ومجموعهم الملتزمون بالسّنّة، أو المجتمعون على إمامٍ يُطبِّق فيهم شرعَ الله. (177) أما الزعم أنَّ لابد في كل مجتمعٍ من جماعةٍ صغيرة هي التي ينحصر فيها الحق، وتقود المجتمع إلى الخلاص، فهذا بيِّن البطلان: (178)
1- فألفاظ الشرع يُرجع في فهم معانيها ومعرفة أحكامها إلى الشرع نفسه، فيعلم المراد منها، وإن بدعة جعل الجماعة الخاصة هي جماعة المسلمين من ذلك؛ فتخصيص فئة دون بقية المسلمين بأنّها جماعة المسلمين أمر يأباه الفهم السليم للنصوص السابقة.
2- الادعاء الخالي من الدليل مردود، فكيف إذا كان هذا الادعاء لاحتكار الحق؟ وادعاء جماعة معينة أنها جماعة المسلمين المقصودة بالنصوص الشرعية دعوى تحتاج إلى برهان.
3- ادعاء الحق في جماعةٍ مُعينة هي طريقة أهل البدع والضلال، فقد قال اليهود والنصارى: {وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى} [البقرة: 111]، ثم كانت هذه طريقة كل فرقة ضالة خرجت عن جماعة المسلمين، وبالأخص فرق الخوارج.
وهذا هو حال هذه جماعات الغلو المعاصرة منذ ظهورها، كل جماعةٍ تطعن في الأخرى وتدعي احتكار الحق لنفسها، دون أي دليل إلا اتباع الهوى والظن. بل إنَّ منظري القاعدة أنفسهم قد تناقضوا في تحديد هذه الجماعة، واختلفت مواقفهم:
– فقد اعتبر الفلسطيني (الجيا) “الجماعة المنصورة، لأنّها تملك معطيات الوراثة، وأهمّها العقيدة الصّحيحة”، (179) ثم نزع عنها هذه الشهادة وادعاها للقاعدة.
– كما صدر عنه وعن مختلف قيادات ومنظري القاعدة تزكية فرع القاعدة في العراق (دولة العراق الإسلامية)، والطلب من جميع فصائل العراق بيعتها والانضمام له، ولم يسمعوا شكواهم فيها، ولا كلام أهل العلم في حقيقتها، ثم أسقطوها عندما خرجت عن مشورتهم، وادعوها لفرع القاعدة في سورية. وبتتبع مسيرتهم خلال العقود الماضية يتضح كثرة تناقضهم وتنازعهم في هذا الأمر، وسرعة توثيق الجماعات وشخصياتها، والانتقال منها إلى النقيض، مما يدل على أنَّ المحرك في ذلك هو الهوى.
المسألة الثانية: تعيين الطائفة المنصورة
يقع الغلاة في الحديث عن الطائفة في عدة أخطاء، من أهمها:
1- حصر هذه الطائفة بمن حمل السلاح فحسب، بينما قرَّر أهل العلم أنَّ هذه الطائفة توجد في كل طبقات العاملين في سبل الله. فقد أخرج البخاري حديث تحت باب (باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، وهم أهل العلم). ونقل النووي بعض أقوال أهل العلم ثم قال: “ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين منهم شجعان مقاتلون ومنهم فقهاء ومنهم محدثون ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض”. (180)
2- حصر هذه الطائفة في أنفسهم، والشهادة لها بالولاية. فادعاء النجاة والصلاح هو من تزكية النفس المنهي عنها، قال تعالى: {فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى} [النجم: 32]، وهي من أخطر الأمراض القلبية التي تُعمي القلب عن رؤية عيوبه وأخطائه، وتدفع الإنسان إلى الكبر والعُجب واحتقار الآخرين. وقد قرَّر أهل العلم أنَّ الشهادةَ لمُعيَّنٍ بأنَّه من أولياء الله لا تجوز إلا بدليلٍ شرعيٍ، وقيل يجوز إذا استفاض ذلك بين الناس، قال ابن تيمية: ” والشهادة بهذا لغير من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة: لا تجوز عند كثير من العلماء أو أكثرهم. وذهبت طائفة من السلف كابن الحنفية وعلي بن المديني: إلى أنه لا يشهد بذلك لغير النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: بل من استفاض في المسلمين الثناء عليه شهد له بذلك”. (181) وعلى فرض صحة الشهادة باستفاضة الثناء بالصلاح بين المسلمين فإنَّ هذا غير متحققٍ في هذه الجماعات، بل الذي عليه أهل العلم وسائر الناس التحذير منهم، والشهادة عليهم بالبدعة والضلال!
3- أوجبوا على سائر الناس اتباع نهجهم وطريقتهم دون سائر أهل العلم، وهذا إيجاب بما لا يجب في الشرع، بل عدَّ ذلك أهل العلم من البدع، قال ابن تيمية: “ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصًا يدعو إلى طريقته، ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينصب لهم كلامًا يوالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة، بل هذا من فعل أهل البدع”. (182) فكيف إذا كان عامة أهل العلم يُحذرون منهم وينهون عن منهجهم وأفكارهم؟!
الثالث عشر: استدلالهم بالملاحم وأشراط الساعة على الأحداث والجماعات
حفلت النصوص الشرعية ببيان ما يقع في آخر الزمان من أحداث وملاحم، وأشراط تدل على قرب الساعة، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على توضيح الموقف الشرعي الواجب اتخاذه منها، وفصَّل ذلك في العديد من الأحاديث؛ نصحًا للأمة، وإرشادًا لها، وحمايةً لها من الانحراف والخطأ في التعامل معها. (183) ومن أهم ما وقعت به جماعات الغلاة من أخطاء في هذه المسالة:
1- تنزيلُ أحاديث آخِر الزَّمان على أحداث أو جماعاتٍ معينة بتخرصات وأوهام، لم يشهد لها دليلٌ من كتابٍ ولا سنةٍ، ولا قول عالم معتبر، وها قد شهد التاريخ باندثار هذه الجماعات الواحدة تلو الأخرى وعدم تحقق مزاعمها. قال القرطبي: “والذي ينبغي أن يقال به في هذا الباب أنما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن والكوائن أن ذلك يكون، وتعيين الزمان في ذلك من سنة كذا يحتاج إلى طريق صحيح يقطع العذر”. (184)
2- اعتمادهم في كثيرٍ من مزاعمهم على المنامات والرؤى كما هو معروف من القصص التي يتداولونها.
3- ترتيب الأحكام على الآخرين بناء على هذه الاعتقادات، فإنَّهم لما اعتقدوا أنهم جماعة الحق المذكورة في النصوص الشرعية حكموا على المخالفين بالتبديع والتكفير، وسفكوا دماءهم.
4- بناء مشاريعهم وأعمالهم على هذه الاعتقادات؛ فإنهم لما اعتقدوا أنهم المعنيون بنصوص الوعد بالانتصار والتمكين، وأيقنوا أنهم في طريقهم للإمساك بزمام الحكم، تصرفوا على هذا الأساس: فاستهانوا بالأعداء، وأعلنوا الحرب على العالم كله، وجعلوا ذلك علامة تحقيق التوحيد وصدق الولاء والبراء، ومن ثم فقد كثر بينهم ترديد عبارة (لا يضرهم من خذلهم)، لكنهم حين مقتل قادتهم، وفناء جماعتهم، وتبددهم في الأرض، واسوا أتباعهم بالأماني الخادعة وقالوا: البلاء سنة قبل التمكين!
الرابع عشر: البيعة
تعتمد تنظيمات الغلاة على نشر فكر “البيعة”، وإيهام أتباعها أنها مِن الواجبات التي لا يجوز التّخلّي عنها، وتحذرهم مِن عدم الوفاء بها، أو تركها مهما كانت الظّروف، ويستدلون على ذلك بما يلي:
1- وجوب البيعة، لقوله : (إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ)، (185) وقوله: (مَن ماتَ وليس في عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، ماتَ مِيتةً جاهليّةً). (186)
2- وجوب الطاعة وعدم جواز نقض البيعة بقوله : (مَن بايعَ إِمامًا فَأعطاهُ ثَمَرةَ قَلبهِ وصَفْقةَ يَدِهِ، فلْيُطِعهُ ما اسْتَطاعَ). (187)
3- عقوبة مَن خلع يدَه مِن البيعة ولو بالقَتل بحديث: (مَن أتاكمْ وأمرُكم جميعٌ على رجلٍ واحدٍ يريدُ أنْ يشقّ عصاكم، أو يفرّق جماعتَكم فاقتلوه). (188)
4- عدمُ جواز بيعة شخصٍ آخر بما سبق مِن أحاديث.
وفي هذا الكلام العديد مِن المغالطات، وبيانها في التالي:
المسألة الأولى: المراد بالبيعة: إعطاءُ العهد على السّمع والطّاعة. قال ابن خلدون: “اعلم أنّ البيعةَ هي العهد على الطّاعة، كأنّ المبايِع يعاهد أميرَه على أنَّه يسلِّم له النَّظرَ في أمر نفسه، وأمور المسلمين لا ينازعه في شيء مِن ذلك، ويطيعه فيما يكلّفه به”. (189) وإذا أطلقت البيعةُ فإنّ المقصودَ بها بيعةُ الحاكم الذي يتولى أمورَ الرعيّة وتدبير شؤونهم، وهذا المعنى هو المقصود في النّصوص الشرعية، والذي جاء في كتب أهل العلم.
المسألة الثانية: تُعقد البيعة للحاكم من أهل الحل والعقد، وبمشورةٍ من عامة المسلمين، وبشروط وكيفية ذكرها أهل العلم.
ويترتَّب على البيعة للحاكم أمورٌ عديدة، مِن أهمها: وجوب السّمع والطاعة بالمعروف، وتحريمُ مبايعة حاكم آخر، وتحريم نزع اليد مِن البيعة أو نقضها دون موجبٍ شرعي، وتحريم عقد بيعةٍ أخرى لغير الحاكم.
المسألة الثالثة: ورد في بعض النصوص إطلاقُ البيعة في حال الحرب للإمام نفسه، فهي تجديدٌ للبيعة العامة، وما فيها من تذكير بالتزام المقاتلين بالطاعة، وحث المقاتلين على الصبر في المعركة. جاء في صحيح مسلم تحت باب (باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال): عن جابرٍ قال: (كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةً، فَبَايَعْنَاهُ وَعُمَرُ آخِذٌ بِيَدِهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَهِيَ سَمُرَةٌ، وَقَالَ: بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَّ، وَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ). (190) وقال النووي: “فالبيعة (على أن لا نفر) معناه: الصبر حتى نظفر بعدونا أو نقتل، وهو معنى (البيعة على الموت)، أي نصبر: وإن آل بنا ذلك إلى الموت، لا أن الموت مقصود في نفسه، وكذا (البيعة على الجهاد) أي: والصبر فيه”. (191) وقد تكون لقائد الجيش في أرض المعركة بمعنى (المعاهدة على القتال)، لتصبير المقاتلين، وتشجيعهم، وتقوية معنوياتهم. فقد وورد عن عكرمة رضي الله عنه أنه نادى في معركة اليرموك: “مَنْ يُبَايِعُ عَلَى الْمَوْتِ؟ فَبَايَعَهُ الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ وَضِرَارُ بْنُ الأَزْوَرِ في أربعمائة مِنْ وُجُوهِ الْمُسْلِمِينَ وَفِرْسَانِهِمْ”. (192) ويقصد بها هنا البيعة اللغوية التي هي بمعنى الاتفاق والمعاهدة، ولا يتعدَّى أثرها موضع المعركة فحسب، بدلالة أنَّه ليس لهذا المبايَع إلا مناصرته أثناء الحمل على العدو فحسب.
المسألة الرابعة: من الخطأ في هذه المسالة الخلط بين مسائل الإمارة، والعمل الجماعي، والبيعة. حيث اعتقد القائلون بالبيعة لغير الإمام الحاكم أنَّ كلّ أميرٍ لا بدّ أن تُعقد له بيعةٌ، واستدلوا بأحاديث الإمارة والتّأمير على لزوم البيعة، وهذا خطأ. فالإمارة تُعقد للاجتماع على رأي واحد وعدم النّزاع، وقد حثَّ عليها النبي في الأمور اليسيرة كالسفر تنبيهًا على ما هو أعظم منها، قالَ الخطّابي: “إنّما أمر بذلك؛ ليكون أمرُهم جميعًا، ولا يتفرّق بهم الرأيُ، ولا يقع بينهم اختلافٌ”. (193) ولم يرد في هذه النصوص الشرعية، وأقوال أهل العلم ما يدلّ على البيعة في مثل هذه الأحوال، ولا تسميةُ هذه الإمارة الخاصة بالبيعة، بل جميعُ ذلك مبتدعٌ محدث. وفرقٌ بين إمارةٍ مخصوصةٍ في الزمن والغاية، والسلطات، وبين بيعة هي من جنس بيعة الحكام. كما اعتقد بعضهم أنَّ العمل الجماعي لا يقوم إلا ببيعة، وهذا إلزام بما لا يلزم، ولا دليل عليه، فتنظيم العمل الجماعي راجعٌ إلى تحديد الصلاحيات، وتقسيم الأعمال، ولا ارتباط له ببيعة ولا إمارة.
المسألة الخامسة: مما سبق يتَّضح أنَّ ما يعرف باسم (بيعة الجماعات) سواء كانت دعوية أو جهادية أمر بدعيٌ غير مشروع، وهو مِن آثار الانعزال عن المجتمع والتمايز عنه بجماعة تحصر الحق في دعوتها. وأن العمل ضمن الجماعات أو المؤسسات، هو من جنس العقود، للشّخص طلب الإقالةِ مِنه بعد إبراء ذمته منه، كما يقع التحلّل مِن هذا العهد بانتهاء الغرض الذي تعاقدوا عليه. وأنَّ تعدُّد البيعات لهذه الجماعات يؤدي إلى تفريق كلمة المسلمين، وعقد الولاء والبراء عليها، وجميع ذلك داخلٌ فيما حذر الله منه من التفرق والاختلاف، والجماعةَ الحق التي يُعقد لها الولاء والمحبة والنصرة بإطلاقٍ هي جماعة المسلمين العامة، وهو مقتضى أخوة الدين. ومن التناقض: ما ردَّت به القاعدة على خلافة البغدادي من أنها وقعت دون مشورة المسلمين، وفي الوقت نفسه يفرضون بيعة جماعتهم ورؤيتها على المسلمين كافة، وهذه سنة الغلاة في احتكار الحق والتنازع عليه منذ القدم.
الخاتمة
يتناقض فكر الغلاة عن الدولة في الإسلام مع المعقول في الوصول إلى الحكم، وبناء الدولة المستقرة القائمة بحقوق الناس؛ فضلًا عن مخالفته للمتقرر شرعًا في شتى مسائل السياسة الشرعية والجهاد. وما فشلهم في إقامة مشاريعهم إلا دلالة على هذا التناقض والبطلان، والذي لا يجدون له جوابًا إلا بمزيد من الهروب للأمام والتعلق بنصوص آخر الزمان ومحاولة إنزالها على واقعهم ومواساة أتباعهم بها.
لذا فإنه الحل الأمثل للتعامل مع انحرافات هؤلاء الغلاة: يكون برفع ظلمة الجهل والتلبيس عن الشعوب الإسلامية، ونشر العلم الشرعي الصحيح، وبيان الأخطاء العقدية والفقهية التي يرتكبها هؤلاء في حق الأمة والدين، مع ضرورة الاعتناء ببيان دور الحكومات والأنظمة في نشوء هذه الجماعات، ورعايتها وانتشارها بين الشباب وفي المجتمعات؛ لما يحمل فكرها في طياته من بذور الفناء وعوامل السقوط، ويرومون بذلك إسقاط الإسلام وحملته من أهل العلم وتشويههم واستبعادهم من مجريات الحياة.
وفيما يلي جملة من الرسائل المستخلصة من هذه الدراسة:
1- مهما اختلف الغلاة في عددٍ من الأفكار والمعتقدات، وتباينت مشاريعهم فإنَّ الأصول الفكرية لها واحدة، والاختلافات التي تقع بينهم منشؤها اختلاف وجهات النظر ضمن هذه المبادئ، فليس في الغلاة معتدلون، ولا ينبغي أن ننخدع بانتقاد بعضهم لبعض، أو تبرؤهم من بعض ولو وصل الأمر إلى القتال، فما زالت هذه سنتهم منذ القدم.
2- علماء الأمة هم ورثة الأنبياء، وحملة الدين، وإليهم يرجع في فهم الدين ومعرفة لأحكام الشرعية، في النوازل، ومسائل القتال. في المقابل تعمد جماعات الغلو إلى إسقاط كافة علماء الأمة، ورميهم بالخيانة والعمالة والضلال، والاستهداف بالقتل والتهجير، لتشويه صورتهم وإبعادهم عن التأثير، وقطع صلة الناس بهم، ليتسلَّط الجهال على هذه الأحكام ويعبثوا بتفسير النصوص الشرعية وأحكامها دون ضابط.
3- تقوم أسس الدولة في الإسلام على أصولٍ راسخةٍ من الثوابت والمبادئ المستخلصة من النصوص الشرعية، مع المرونة في التنزيل على الواقع، والقابلية للاجتهاد والنظر من أهل العلم المتمكنين، والتي تقوم في كثيرٍ منها على قواعد: “الاستطاعة”، و”مراعاة المآلات”، و”لا تكليفَ مع العجز”، و”تحصيل أعلى المصلحتين بتفويت أدناهما”، و”دفع أعظم المفسدتين باحتمال أخفِّهما”. بينما مشروع الدولة عند الغلاة لا يقوم على أسسٍ شرعية، ولا فتاوى وآراء لأهل العلم، ولا يؤمن بالتدرج ولا مراعاة المصالح ولا المفاسد، فهو مشروع تدميري عدمي، لا يؤدي إلى بناء دولة ولا نهوض أمة، بل هو مشروع قتل وتفجير، وإبقاء مناطق سيطرتهم والمجتمعات التي يخرجون فيها في القتل والهدم حتى يتحقق حلمهم.
4- يقوم الإصلاح في المجتمع على بذل الجهد في جميع المجالات التعليمية، والتربوية، والإعلامية، والسياسية، والاقتصادية، كل فيما يحسن ويستطيع، وكل ذلك من الجهاد في سبيل الله. بينما تعتنق جماعات الغلو حمل السلاح منهجًا وحيدًا للتغيير ضد الحكومات في العالم الإسلامي والتي يصفونها بالردة، بناء على مبادئ مشوهة ومغالية لموضوعات الحاكمية الولاء والبراء، ويصفون كل ما عدا ذلك بالعبث والخيانة.
5- تبنى الدولة وينهض المجتمع بتعاضد جميع الفئات والمكونات، واتفاقهم على مشروع وطني جامع، يتشارك الجميع في إنشائه وحمايته والدفاع عنه. أما أهم ركائز الدولة عند الغلاة: فهي تعظيم النفس وحصر الحق والطائفة المنصورة فيها، وتنزيل نصوص آخر الزمان من ملاحم وبشائر على جماعتهم، مع الطعن في سائر الشعوب الإسلامية والجماعات العاملة فيها، مما يجعلهم الأحق بقيادة الأمة، واتخاذ القرارات المصيرية فيها.
6- مشروع الدولة في الإسلام يقوم على خدمة الناس والقيام بشؤونهم، والحفاظ على دماء الناس وأعراضهم وأموالهم، وتحييد الأعداء وتقليل العداوات لينعم المجتمع بالتنمية والاستقرار. بينما يقوم مشروع الدولة عند الغلاة على استغلال ظروف المجتمعات غير المستقرة لإقامة مشروعها، وتسخير مواردها لها، ثم تعمد إلى زج الشعوب وإرغامها على الدخول في معاركها لتتخذهم وقودًا لها.
7- في الدولة في الإسلام توجه القوة والسلاح للأعداء الحقيقين الذين يريدون غزو البلاد من الخارج أو إثارة القلاقل من الداخل، مما يحفظ بيضة المسلمين وكيانهم. أما عند الغلاة: فإنَّ القوة والسلاح يوجه لكل من يختلفون معه من جماعات وشخصيات بتهم الانحراف أو العمالة وغير ذلك، مما يؤدي إلى نشوء الصراع والدمار في مناطق أهل السنة، وتصفية كوادرهم، ومن ثم يتسلط الأعداء عليها وتكون لقمة سائغة لهم.
8- في الدولة في الإسلام: للوسيلة حكم الغاية، فلا يجوز اتخاذ وسائل محرمة للوصول إلى الهدف مهما كان مشروعًا أو نبيلاً؛ لذا ينبغي أن يتحلى المسلم العامل في هذا المشروع بالصدق، والأمانة، وسائر ما أمر به الشرع. أما الغلاة: فالأساس لديهم الوصول إلى الهدف مهما كانت الوسيلة؛ لذا فإنهم يلجؤون إلى الكذب، والخيانة، والغدر، ونقض العهود، واستحلال دماء وأموال المخالفين بحججٍ شتى، مخالفين في ذلك نصوص الشرع، متبعين للهوى ورغبات النفوس.
نسأله تعالى أن يبرم لهذه الأمة أمرًا رشدًا، يُعزّ فيها أهل طاعته وسنته، ويؤمر فيها بالمعروف ويُنهى فيها عن المنكر، وأن يهدي شباب المسلمين ويردهم إليه ردًا جميلًا. والحمد لله رب العالمين.
فهرس المراجع
أولاً: الكتب والأبحاث
– الأحكام السلطانية للماوردي، دار الحديث، القاهرة.
– أحكام القرآن، محمد بن عبد الله بن العربي، تحقيق: محمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت.
– إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (شرح القسطلاني)، أحمد بن محمد القسطلاني، المطبعة الكبرى الأميرية، مصر.
– الاستذكار، يوسف بن عبد الله بن عبد البر، تحقيق: سالم عطا، ومحمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت.
– الاستطاعة، محمد سرور زين العابدين، دار الجابية، لندن.
– اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق: د. ناصر العقل، دار عالم الكتب، بيروت.
– الأم، محمد بن إدريس الشافعي، دار المعرفة، بيروت.
– الإيمان، القاسم بن سلام الهروي، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض.
– بداية المجتهد ونهاية المقتصد، محمد بن رشد القرطبي، دار الحديث، القاهرة.
– بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، أبو بكر الكاساني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 1406هـ – 1986م.
– تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد (تفسير التحرير والتنوير)، محمد الطاهر بن محمد بن عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس، 1984م.
– تحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن حجر الهيتمي، تحقيق جماعة من العلماء، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة.
– التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، محمد بن أحمد القرطبي، تحقيق: د. الصادق إبراهيم، دار المنهاج، الرياض.
– تنظيم القاعدة ومشروع الدولة الإسلامية، سعيد بن حازم السويدي، مركز ثبات للبحوث والدراسات.
– تنوير الأبصار المطبوع مع الحاشية، محمد التمرتاشي، تحقيق: عبد المنعم إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت.
– التوقف والتبين، محمد سرور زين العابدين، الطبعة الرابعة، دار الجابية، لندن.
– تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (تفسير السعدي)، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تحقيق: د. عبد الرحمن اللويحق، مؤسسة الرسالة، بيروت.
– جامع البيان في تأويل القرآن (تفسير الطبري)، محمد بن جرير الطبري، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت.
– الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه (صحيح البخاري)، محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: محمد زهير الناصر، ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، دار طوق النجاة.
– جماعة المسلمين، محمد سرور زين العابدين، الطبعة الرابعة، دار الجابية، لندن.
– حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر.
– الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، علي بن محمد الماوردي، تحقيق: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت.
– الدر المختار شرح تنوير الأبصار، محمد الحصفكي، تحقيق: عبد المنعم إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت.
– الدرر السنية في الأجوبة النجدية، جمع: عبد الرحمن بن قاسم.
– الدّولة الإسلامية بين الحقيقة والوهم، أبو عبد الله المنصور.
– الردُ على أهلِ التوقُف والتَبَيُن والغلو في التكفير، عبد الله الغليفي.
– سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد (ماجه) القزويني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وآخرون، دار الرسالة العالمية.
– سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث الأزدي، تحقيق: شعَيب الأرنؤوط، محمد بللي، دار الرسالة العالمية، بيروت.
– سنن الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق: أحمد شاكر، وآخرون، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر.
– السنن الكبرى، أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: محمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت.
– سير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق: مجموعة من المحققين، مؤسسة الرسالة، بيروت.
– شبهات تنظيم “الدولة الإسلامية” وأنصارها، والرد عليها، عماد الدين خيتي، هيئة الشام الإسلامية.
– شرح مشكل الآثار، أحمد بن محمد الطحاوي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت.
– الصارم المسلول على شاتم الرسول، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، طبعة الحرس الوطني، الرياض.
– عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، أحمد محمد شاكر، دار الوفاء.
– عمدة القاري شرح صحيح البخاري، محمود بن أحمد العيني، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
– الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة، د. عبد الرحمن اللويحق، مؤسسة الرسالة، بيروت.
– غياث الأمم في التياث الظّلم “الغياثي”، إمام الحرمين أبو المعالي الجويني، تحقيق: د. عبد العظيم الديب، مكتبة إمام الحرمين .
– الفتاوى الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، دار الفكر، بيروت.
– فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم، محمد بن إبراهيم آل الشيخ، جمع وترتيب: محمد بن قاسم، مطبعة الحكومة مكة المكرمةـ
– فتح الباري شرح صحيح البخاري، مع تعليقات الشيخ عبد العزيز بن باز، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، إخراج وتصحيح: محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت.
– فتح القدير، محمد ابن الهمام السيواسي، دار الفكر، بيروت.
– فضائح الباطنية، محمد بن محمد الغزالي، تحقيق: عبد الرحمن بدوي، مؤسسة دار الكتب الثقافية، الكويت.
– فيض القدير شرح الجامع الصغير، محمد المناوي، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة.
– قواعد الأحكام في مصالح الأنام، عبد العزيز بن عبد السلام، علق عليه: طه سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة.
– مجموع الفتاوى، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، جمع: عبد الرحمن بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية.
– مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وآخرون، مؤسسة الرسالة.
– المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (صحيح مسلم)، مسلم بن الحجاج النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
– معالم السنن (شرح سنن أبي داود)، حمد بن محمد الخطابي، المطبعة العلمية، حلب.
– معالم ومنارات في تنزيل نصوص الفتن والملاحم وأشراط الساعة، د. زاهر بن محمد الشهري.
– المعلم بفوائد مسلم، محمد بن علي المازري المالكي، تحقيق: محمد الشاذلي النيفر، الدار التونسية للنشر.
– المغني، عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، مكتبة القاهرة.
– مفهوم جماعة المسلمين، د. عبد الرحمن اللويحق، دار الوراق، بيروت.
– منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق: د. محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض.
– الموافقات، إبراهيم بن موسى الشاطبي، تحقيق: مشهور آل سلمان، دار ابن عفان.
– الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، الندوة العالمية للشباب الإسلامي.
– نيل الأوطار، محمد بن علي الشوكاني، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، دار الحديث، القاهرة.
– الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (تفسير الواحدي)، علي بن أحمد الواحدي، النيسابوري،
– تحقيق: صفوان داوودي، دار القلم، دمشق.
ثانيًا: المواد المنشورة على شبكة المعلومات
– إدارة التوحش، أبو بكر ناجي.
– إسعاد الأخيار في إحياء سنة نحر الكفار، أبو البراء النجدي.
– الإعلام الجهادي: كيف وظفت التنظيمات الجهادية وسائل الإعلام؟ رانيا مكرم، المركز العربي للبحوث والدراسات
– إعلان الخلافة الإسلامية-رؤية شرعية واقعية، علوي بن عبد القادر السقاف، مقال على موقع الدرر السنية.
– أقلّوا عليهم، عمر محمود (الفلسطيني).
– إن الحكم إلا لله، كلمة لأبي عمر البغدادي.
– إني أنا النذير العريان، بيان لأبي بكر الزيلعي
– إني لعملكم من القالين، بيان لأبي يوسف الغريب.
– الآيات والأحاديث الغزيرة على كفر قوات درع الجزيرة، فارس آل شويل.
– الباحث عن حكم قتل أفراد وضباط المباحث، فارس آل شويل.
– براءة الموحدين من عهود الطواغيت وأمانهم للمحاربين، عصام البرقاوي (المقدسي).
– برنامج ما نريكم إلا ما يرى آل سعود، مقال لفارس آل شويل.
– بين منهجين، عمر محمود (الفلسطيني).
– تبديد الأسنة في الرد على من ظن أن القتل ذبحا سنة، أبو محمد الفلسطيني
– التبرئة، الظواهري.
– تبصير العقلاء بتلبيسات أهل التجهم والإرجاء، عصام البرقاوي (المقدسي).
– التبيان في وجوب قتال جيش موريتان، أبو طلحة الشنقيطي.
– التترس في الجهاد المعاصر، أبو يحيى الليبي.
– تسجيل صوتي لأبي يزن الشامي عن القاعدة وتنظيم (الدولة).
– التشكيلة الوزارية الأولى للدولة الإسلامية، محارب الجبوري.
– ثياب الخليفة، عمر محمود (الفلسطيني).
– الجامع في طلب العلم الشريف، سيد إمام.
– جريمة الانتخابات السياسية، كلمة لأبي عمر البغدادي.
– الجهاد الفريضة الغائبة، محمد عبد السلام فرج.
– الجواب المفيد بأن المشاركة في البرلمان وانتخاباته مناقضة للتوحيد، عصام البرقاوي (المقدسي).
– حتى نفهم فتوى البراك، مقال للشيخ ناصر العمر، منشور على موقع المسلم.
– حسن الرفاقة في أجوبة سؤالات سواقة، عصام البرقاوي (المقدسي).
– حقيقة الحرب الصليبية، يوسف العييري.
– حكم المشايخ الذين دخلوا في نصرة المبدلين للشريعة، عمر محمود (الفلسطيني).
– حوار جمال إسماعيل مع الظواهري لصالح قناة الجزيرة عام 1419ه.
– حوار عصام البرقاوي (المقدسي) مع قناة الجزيرة عام 2005م.
– حوار عمر محمود (الفلسطيني) مع قناة الجزيرة عام 2014م
– حول إمارة جبهة النصرة (5): القيادة السياسية لجبهة النصرة، عماد الدين خيتي.
– الحياة مع الجماعات المسلحة داخل السجون الجزائرية، جريدة الحياة اللندنية، العدد (13515) بتاريخ 12/3/2000م.
– دعوة المقاومة الإسلامية العالمية، أبو مصعب السوري (مصطفى المُزَيِّكْ، الست مريم).
– الديمقراطية دين، عصام البرقاوي (المقدسي).
– رسالة الشيخ أبي سليمان العتيبي للقيادة في خراسان.
– رسالة نصح وإرشاد إلى القاعدين عن الجهاد، أبو الليث الليبي.
– سلسلة دروس في مسمّى الإيمان مفرغة، عمر محمود (الفلسطيني).
– سلسلة مناقشة كتاب الحرب العالمية الرابعة، عمر محمود (الفلسطيني).
– السيرة الجهادية لأبي مصعب الزرقاوي، سيف العدل.
– شريط الجولاني المسرب عن إعلان الإمارة.
– شهادة د. حذيفة عزام على اعتداءات جبهة النصرة وجند الأقصى، المنشورة على موقع نور سورية.
– العمدة في إعداد العدة، سيد إمام.
– فتوى المجمع الفقهي الإسلامي في دورته (19) بتاريخ 27/10/1428ه، الموافق 8/11/2007م، في حكم المشاركة السياسية في البلدان غير الإسلامية.
– فتوى كبيرة الشأن في جواز قتل الذرية والنسوان درءًا لخطر هتك الأعراض وقتل الإخوان)، مجلة الأنصار التابعة للجماعة الإسلامية في الجزائر (الجيا)، بتاريخ شوال 1415ه- 3 / 1995م
– فتوى: الدستور المصري والتصويت عليه، للشيخ عبد العزيز الطريفي، منشورة على موقعه.
– فتوى: حكم قتل نساء وأطفال الأعداء من باب المعاملة بالمثل، هيئة الشام الإسلامية.
– فتوى: حكمُ مشاركة الفصائل السُّورية في تحالفاتٍ عسكرية وتلقّيها للدّعم الدّولي، هيئة الشام الإسلامية.
– فتوى: ما حكم ذبح أسرى الأعداء بالسكين؟ وهل هو فعلًا سنة نبوية يمكن اتباعها؟ هيئة الشام الإسلامية.
– فتوى: هل البلادُ الإسلاميةُ اليومَ دارُ كفر؟ هيئة الشام الإسلامية
– فرسان تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم، الظواهري.
– قصة جماعة الجهاد، هاني السباعي.
– قطف الثمرة.. فكرة تلخص مسيرة الجماعات (الجهادية)، عماد الدين خيتي.
– قل إني على بينة من ربي، كلمة لأبي عمر البغدادي.
– كشف شبهات المجادلين عن عساكر الشرك وأنصار القوانين، عصام البرقاوي (المقدسي).
– الكواشف الجلية، عصام البرقاوي (المقدسي).
– لقاء ابن لادن مع تيسير علوني عام 2001م لصالح قناة الجزيرة.
– اللقاء الصوتي الثاني مع أبي حمزة المهاجر.
– لقاء الظواهري الرابع مع مؤسسة السحاب: قراءة للأحداث.
– لماذا الجهاد؟ عمر محمود (الفلسطيني).
– لماذا نقاتل ومن نقاتل؟ أبو حمزة البغدادي.
– مجلة الأنصار الجزائرية.
– مفاهيم لترشيد الجهاد (5): جهاد لا إفساد، عماد الدين خيتي.
– مقابلات الجولاني الثلاث على قناة الجزيرة.
– ملة إبراهيم، عصام البرقاوي (المقدسي).
– نصيحة مشفق، كلمة للظواهري.
– هذا ما وعدنا الله ورسوله، كلمة لأبي محمد الجولاني.
– وعد الله، كلمة لأبي عمر البغدادي.
– وثائق دير شبيغل تكشف التنظيم الهرمي لداعش بالتفصيل، ترجمة موقع شبكة الثورة السورية بتاريخ 20/4/2015م.
– فتوى الشيخ عبد الرحمن البراك عن حكم المشاركة في الحكومة وصياغة النظام في مصر بعد الثورة، المنشورة على موقعه بتاريخ 9 ربيع الأول 1432ه.
– فتوى الشيخ يوسف القرضاوي أثناء حلقة (مشروعية الدستور وحكم الاستفتاء عليه) ) في حلقة على قناة الجزيرة بتاريخ 4/9/ 2004م، والمنشورة على موقعه.
– وقفات مع ثمرات الجهاد، عصام البرقاوي (المقدسي).
– وقفات مع كلمة الجولاني (هذا ما وعدنا الله ورسوله، للكاتب، والمنشور على موقع نور سورية.
– وقل جاء الحق وزهق الباطل، كلمة لأبي عمر البغدادي.
الإحالات
(1) ينظر مثلًا:
كتاب: الدّولة الإسلامية بين الحقيقة والوهم، لأبي عبد الله المنصور، الأمير والشرعي في جيش المجاهدين بالعراق.
مقال: إعلان الخلافة الإسلامية-رؤية شرعية واقعية، علوي بن عبد القادر السقاف، موقع الدرر السنية.
وللكاتب مؤلف بعنوان: (كتاب: شبهات تنظيم “الدولة الإسلامية” وأنصارها والرد عليها)، وهو مؤلف يحوي الإجابة عن أهم الشُّبه والمغالطات الشرعية في أمور العقيدة والسّياسة الشرعية التي تثيرها تنظيمات الغلاة وعلى رأسها تنظيم (الدولة)، وما تحملة من تلبيس الحق بالباطل، وتغرير المسلمين، وحَرف الأحكام الشرعية عن حقيقتها، وما يترتَّب على ذلك من تكفير المسلمين، واستحلال دمائهم وأموالهم، وإثارة الفتنة، وتحاول بها تضليل الناس وخداعهم، والتشكيك والطعن في المخالفين. وقد جاء الكتاب في عشرين شبهة رئيسة موزعة على ثلاثة أقسام: القسم الأول: الرَّدُّ على الشُّبه المتعلقة بمنهج تنظيم (الدولة)، القسم الثاني: الرَّدُّ على الشُّبه حول قتال تنظيم (الدولة)، والقسم الثالث: الرَّدُّ على الشُّبه حول منهج المخالفين لتنظيم (الدولة). وقد أُجيب عن هذه الشُّبه بطريقة علميةٍ محررَّة، ولغة ميسَّرة. ولم يقتصر الكتاب على شُبه تنظيم (الدولة) فحسب، بل تضمن الإجابة عن العديد من الشبة التي يثيرها بقية الغلاة مما له علاقة بموضوعات الكتاب. كما أُضيف للكتاب في طبعته الثانية الموسّعة أهم ما صدر من بحوث ودراسات وفتاوى في المسائل المطروحة، مع الإحالة إليها، وملحقان: ملحق بأهم أقوال زعماء التنظيم من خلال بياناتهم الرسمية مجموعة في مكان واحد، وآخر بأهمّ الدّراسات والمقالات والإصدارات عن التنظيم. وطبع الكتاب ووزع منه آلاف النسخ على طلبة العلم والدعاة في كل من سوريا، وفلسطين، وليبيا، والعراق، وتركيا، وغيرها، ولقي القبول والاستحسان من طلبة العلم بحمد الله تعالى.
(2) في ثنايا نقاشات مع مخالفي القاعدة في بعض المواقع على الشبكة العنكبوتية.
(3) ينظر: التبرئة، للظواهري ص (53-57).
(4) على الرغم من تبرؤ تنظيم القاعدة مؤخرًا من تصرفات فرعه في العراق وإظهار عدم الرضا عنها، إلا أنه مسؤول عنها مسؤولية كاملة؛ فهي نتاج فكره ومنهجه، بالإضافة إلى اعترافه بالتنظيم خل السنوات الماضية، داعمًا له، حاثًا فصائل العراق على بيعته، رافضًا سماع أي شكوى فيه، ينظر: تنظيم القاعدة ومشروع الدولة الإسلامية، لسعيد بن حازم السويدي، مركز ثبات للبحوث والدراسات، ص (46).
(5) يهدف المشروع إلى الحد من ظاهرة الغلوّ من خلال تطوير خطاب بديل من أجل تعزيز الوسطية، وإيضاح التداعيات السَّلبية لخطاب الحرب على الإرهاب، عبر ورش عمل وأبحاث تخدم هذا الهدف.
(6) ينظر مقال: (قطف الثمرة).. فكرة تلخص مسيرة الجماعات (الجهادية)، للكاتب، موقع نور سورية.
(7) الجهاد الفريضة الغائبة، لمحمد عبد السلام فرج.
(8) ينظر كلمته: التشكيلة الوزارية الأولى للدولة الإسلامية.
(9) أعلنت جماعة (جند الله) الموالية للقاعدة عن إقامة إمارة إسلامية من أحد مساجد مدينة رفح في قطاع غزة عام 2009م على يد عبد اللطيف موسى، قبل أن تنتهي الأحداث بمقتله وعدد من جماعته. كما يذكر أنَّ من أهم أسباب الخلاف بين جماعتي (الجماعة الإسلامية) و(الجهاد) المصريتين في السجن عام 1983م بسبب الاختلاف على جواز تولي د. عمر عبد الرحمن إمارة التنظيم وهو ضرير، وقد صدرت في ذلك فتاوى وردود متبادلة بين الطرفين.
(10) في المقابلة المعقودة معه بعنوان: نصيحة مشفق.
(11) عدة لقاءات على الانترنت نشرها تلميذه أبو محمود الفلسطيني.
(12) ينظر: كلمته (إن الحكم إلا لله).
(13) ينظر: كلمته (وقل جاء الحق وزهق الباطل).
(14) ينظر كلمته: (وعد الله).
(15) ينظر: بيان (إني أنا النذير العريان) لأبي بكر الزيلعي، وبيان (إني لعملكم من القالين) لأبي يوسف الغريب، وهما من قيادات الجماعة في الصومال الذين رفضا عددًا من تصرفات الجماعة وأصدرا بيانات لعموم الناس ولقيادة القاعدة في أفغانستان بذلك.
(16) كفرت (جماعة المسلمين) بزعامة شكري مصطفى عموم الشعوب الإسلامية؛ لأنهم رضوا بكفر الحكام وتابعوهم، وكفروا العلماء لأنهم لم يكفروا الحكام ولا الشعوب.
ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، الندوة العالمية للشباب الإسلامي (1/335)، وقد تتبع عقائدهم وأفكارهم وفندها الشيخ محمد سرور في كتابه: جماعة المسلمين.
وممن لم يحكم بالتكفير: جماعات (التوقف والتبين)، حيث يرون أن الناس ساكتون على الحكم بغير ما أنزل الله، ولهذا فهم شركاء للحكام في كفرهم، سواءً رضوا أم كرهوا، ومع ذلك فهم لا يكفرون أعيانهم حتى يسمعوا منهم، ويسمون هذا التوقف ورعًا، ومن أشهر زعمائهم مجدي الصفتي.
ينظر: التوقف والتبين، للشيخ محمد سرور، والردُ على أهلِ التوقُف والتَبَيُن والغلو في التكفير، لعبد الله الغليفي.
(17) سلسلة دروس في مسمّى الإيمان مفرغة، ص (200).
(18) إدارة التوحش ص (21).
(19) العمدة في إعداد العدة ص (154).
(20) لأبي قتادة الفلسطيني كلام طويل في هذه المسألة، ينظر: بين منهجين، المقالة (23)، والمقالة (24)، وينظر: دورة الإيمان، الشريط الثاني والثالث.
(21) إدارة التوحش ص (3).
(22) ينظر: بين منهجين المقالة (1).
(23) ينظر مقال: أقلّوا عليهم (5).
(24) العمدة ص (154).
(25) ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، الندوة العالمية للشباب الإسلامي (1/337).
(26) ينظر: رسالة الشيخ أبي سليمان العتيبي للقيادة في خراسان.
(27) في شهر رمضان من عام 1435ه، الموافق 12/ 7/ 2014م تسرب -أو سُرِّب- تسجيل صوتي للجولاني يحمل إعلانًا للإمارة المرتقبة، وحضر اللقاء عدد من الشخصيات، منهم: رضوان نموس (أبو فراس السوري)، وعبد الله المحيسني، الذي ألقى كلمة لاحقة أيد فيها قيام إمارة على منهج ابن لادن.
(28) ينظر كلمته: (قل إني على بينة من ربي).
(29) وقد سبق قادتهم في عدم الاعتراف بالمحاكم في البلاد التي يقيمون فيها، فقد حاكم الظواهري صبيين بتهمة اختراق الجماعة أثناء إقامته في السودان، ونفذ فيهما حكم الإعدام في مقر الجماعة، على الرغم من اعتراف الظواهري أن الحكومة السودانية كانت تطبق الشرع في ذلك الوقت. ينظر: قصة جماعة الجهاد، لهاني السباعي ص (34).
(30) ينظر كلمته: (قل إني على بينة من ربي).
(31) ينظر كلمة الجولاني: (هذا ما وعدنا الله ورسوله)، ومقال: وقفات مع كلمة الجولاني (هذا ما وعدنا الله ورسوله، للكاتب، والمنشور على موقع نور سورية.
(32) ذكرها أبو يزن الشامي في تسجيل صوتي عن القاعدة وتنظيم (الدولة).
(33) ينظر كلمته: (جريمة الانتخابات السياسية).
(34) ينظر: شريطه المسرب عن إعلان الإمارة.
(35) التبرئة ص (8)، وينظر كلام عصام البرقاوي في: تبصير العقلاء بتلبيسات أهل التجهم والإرجاء ص (94)، والفلسطيني في: بين منهجين، المقالة (33).
(36) العمدة ص (335).
(37) ينظر: رسالة نصح وإرشاد إلى القاعدين عن الجهاد.
(38) وقد ألّف أبو بكر ناجي كتابًا بعنوان: “إدارة التوحش: أخطر مرحلة ستمر بها الأمة” ضمّنه أفكار وخطط هذا المشروع.
(39) ينظر: العمدة في إعداد العدة ص (311)، ولماذا الجهاد، للفلسطيني، وملة إبراهيم، للبرقاوي ص (67).
(40) ينظر: إدارة التوحش ص (7) وما بعدها.
(41) إدارة التوحش، ص (4).
(42) إدارة التوحش، ص (8).
(43) إدارة التوحش ص (16).
(44) في مقابلته على قناة الجزيرة بتاريخ 19/12/2013م.
(45) إدارة التوحش ص (18).
(46) ينظر: ينظر: شريطه المسرب عن إعلان الإمارة.
(47) ينظر: العمدة في إعداد العدة ص (298).
(48) إدارة التوحش ص (21).
(49) إدارة التوحش ص (47).
(50) في مقابلته الثانية مع أحمد منصور على قناة الجزيرة بتاريخ 27/5/2015م، وحملت عناوين بياناتهم وخطاباتهم هذه المعاني مثل كلمة الجولاني (لأهل الوفاء يهون العطاء)، و(أهل الشام فديناكم بأرواحنا).
(51) ينظر: إدارة التوحش ص (21).
(52) ينظر: الإعلام الجهادي: كيف وظفت التنظيمات الجهادية وسائل الإعلام؟ رانيا مكرم، المركز العربي للبحوث والدراسات.
(53) ينظر: اللقاء الرابع مع مؤسسة السحاب: قراءة للأحداث.
(54) إدارة التوحش ص (74).
(55) ينظر: شريطه المسرب عن إعلان الإمارة.
(56) تولى مركز (دعاة الجهاد) الذي يقوم عليه عبد الله المحيسني هذه المسؤولية، وكان قد سمى أحد مراكز دعوته باسم البرقاوي قبل أن يغيره بسبب المعارضة الإعلامية، كما أنَّه يدرس في معاهده كتب البرقاوي، كـ (ملة إبراهيم)، ونشر منتجات الفلسطيني عبر مجلته إيحاءات جهادية. لذا تخصه القاعدة بالعمل الدعوي في مناطق وجودها، وتمكنه من السيطرة على ما تستطيع من مساجد ومخيمات، وتمنع غيره من الدعوة فيها، بإشرافها وحماية عناصرها.
(57) إدارة التوحش ص (46)، وينظر كلام “سيف العدل” المسؤول العسكري للقاعدة في كتابه: السيرة الجهادية لأبي مصعب الزرقاوي، وكلام الجولاني في مقابلته الثانية مع أحمد منصور على قناة الجزيرة بتاريخ 27/5/2015م.
(58) بل إنَّ إدارة القاعدة في سورية لمناطق سيطرتها طغت عليه الفوضى والظلم والتناقض بين الشعارات والتطبيق:
– ففي الإدارة المالية قال الجولاني في شريطه المسرب: “لو قلت لكم لما صدقتم، هناك أكثر من مليار ونصف مليون دولار ذهب منا ضياعًا بسبب استهانة واستخفاف الكثير من الأخوة في جبهة النصرة في حفظ أموال المسلمين”. كما أنَّهم لم يحافظوا على ما وقع تحت أيديهم من مصانع ومعامل وسكك حديدية ومحطات كهرباء وغيرها من البنى التحتية، فقد عمدوا إلى مصادرتها بتهمة عمالة أصحابها أو علاقتهم مع النظام، أو تفكيكها وبيعها، فتوقفت الصناعة والإنتاج في مناطقهم.
– وبخصوص إدارة منطقة إدلب: فالواقع يحكي فشل الإدارة على جميع المستويات الأمنية، والتعليمية، والخدمية وغيرها، مع أن لهم الكلمة العليا فيها، والتي وصلت إلى حد تبعية المنظومة التعليمية لوزارة تربية النظام السوري من حيث العائدية المالية، وتعيين المدرسين، وكذلك اعتماد قطاع الخدمات كالكهرباء والماء وغيرها على مؤسسات النظام، مع رفض أي تعاون مع مؤسسات الحكومة الحرة أو مؤسسات الإدارة الثورية بحجة الاتهام بالعلمانية ونحو ذلك، وللاطلاع على بعض ما نشر عن هذه الإدارة ينظر على سبيل المثال:
الإدارة المدنية في إدلب، مدى سورية، موقع مدى سورية، بتاريخ 15/2/2016م.
ومدينة إدلب.. ما بعد التحرير، موقع أورينت نت، بتاريخ 1/8/2015.
والإدارة المدنية في مناطق سيطرة المعارضة.. إدلب والرستن نموذجًا، موقع مجلة صور، بتاريخ 2/11/ 2015م
(59) ينظر: العمدة في إعداد العدة، وجامع العلم، لسيد إمام، والتبرئة، للظواهري، وعلى هذا كتب وفتاوى البرقاوي (المقدسي) مثل: الكواشف الجلية، ملة إبراهيم، والديمقراطية دين، وغيرها، وعمر محمود (الفلسطيني) مثل: بين منهجين.
(60) الجامع في طلب العلم الشريف ص (458).
(61) ينظر الإجابة عن سؤال: عمن انتهت فترة عمله من الوزراء والنواب السابقون، ولعل من أوائل التطبيق العملي لهذه الأفكار حادثة اغتيال وزير الأوقاف المصري الشيخ محمد حسين الذهبي على يد جماعة شكري مصطفى عام 1977م.
(62) الجامع في طلب العلم الشريف ص (459)، وينظر: الجواب المفيد بأن المشاركة في البرلمان وانتخاباته مناقضة للتوحيد، للبرقاوي.
(63) الجامع في طلب العلم الشريف ص (459).
(64) ينظر: كشف شبهات المجادلين عن عساكر الشرك وأنصار القوانين.
(65) ينظر: الباحث عن حكم قتل أفراد وضباط المباحث، لفارس آل شويل، عضو اللجنة العلمية بفرع القاعدة في الجزيرة العربية، والآيات والأحاديث الغزيرة على كفر قوات درع الجزيرة، له كذلك، والتبيان في وجوب قتال جيش موريتان، لأبي طلحة الشنقيطي، ومؤلفاتهم فيها كثيرة.
(66) ينظر: الجهاد الفريضة الغائبة.
(67) الجامع في طلب العلم الشريف ص (567)، وينظر: الجهاد الفريضة الغائبة، وينظر: بين منهجين، للفلسطيني، المقالة (36)، ووقفات مع ثمرات الجهاد، للبرقاوي ص (83)، واعتبر أنَّ من ديار الكفر الحالية: مكة والمدينة.
(68) الجامع في طلب العلم ص (488).
(69) ينظر: حكم المشايخ الذين دخلوا في نصرة المبدلين للشريعة.
(70) حسن الرفاقة في أجوبة سؤالات سواقة ص (20).
(71) ينظر: مجلة الأنصار الجزائرية، العدد (132) ص (10).
(72) ينظر مقال: برنامج ما نريكم إلا ما يرى آل سعود.
(73) العمدة في إعداد العدة ص (90).
(74) ينظر: كلمته (قل إني على بينة من ربي).
(75) ينظر: شهادة د. حذيفة عزام على اعتداءات جبهة النصرة وجند الأقصى، موقع نور سورية.
(76) العمدة في إعداد العدة ص (334).
(77) ينظر مقال: برنامج ما نريكم إلا ما يرى آل سعود.
(78) إدارة التوحش ص (52).
(79) وهي الخطة التي وضعها حجي بكر لاختراق الفصائل وتقويضها، ينظر: وثائق دير شبيغل تكشف التنظيم الهرمي لداعش بالتفصيل، ترجمة موقع شبكة الثورة السورية، بتاريخ 20/4/2015م.
(80) في رسالته بتاريخ 5 شعبان 1431ه- 17 يوليو 2010م، ضمن وثائق بوت آباد.
(81) ينظر: التبرئة، للظواهري، وقد أطال في عرض هذه الأمور والتبرير لها.
(82) ينظر: التترس في الجهاد المعاصر، أبو يحيى الليبي (حسن قائد).
(83) ينظر: (فتوى كبيرة الشأن في جواز قتل الذرية والنسوان درءًا لخطر هتك الأعراض وقتل الإخوان)، مجلة الأنصار التابعة للجماعة الإسلامية في الجزائر (الجيا)، بتاريخ شوال 1415ه- 3 / 1995م.
(84) ينظر: التبرئة، للظواهري، وبراءة الموحدين من عهود الطواغيت وأمانهم للمحاربين، للبرقاوي (المقدسي).
(85) ينظر: التبرئة، للظواهري.
(86) عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير (1/697)، عند آية: {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة: 50].
(87) عمدة التفسير (1/678)، عند قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38-40].
(88) في تعليقه على تفسير الطبري (10/348)، عند قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44].
(89) رسالة تحكيم القوانين الوضعية، ضمن الدرر السنية (16/215).
(90) فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم (1/80).
(91) ينظر موسوعة الويكبيديا عند التعريف بجنكيز خان.
(92) سير أعلام النبلاء (22/228).
(93) تفسير ابن كثير (3/131).
(94) ينظر: شبهات تنظيم الدولة، للكاتب ص (239).
(95) مجموع الفتاوى (3/268).
(96) أحكام القرآن (2/127).
(97) لا يعني ما سبق حصرَ الكفرِ الأكبر في مسألة الحكم بالقوانين الوضعية بالاعتقاد استحلالًا أو جحودًا؛ إذ إنَّ الكفرَ يكون بقول اللسان، وعمل الجوارح كذلك، لكنّ المقصودَ التّنبيهُ إلى أنَّ تشريع القوانين الوضعية لا يكون كفرًا أكبر بإطلاق.
فمِن الكفر وإن لم يكن استحلالاً أو جحودًا: الإعراض والترك، فقد يكون الإعراض والترك كفرًا أكبر في حالات:
قال ابن القيم في “مدارج السّالكين” (1/347): “وأمّا كفرُ الإعراض فأنْ يُعرض بسمعه وقلبه عن الرسول، لا يصدّقه، ولا يكذّبه، ولا يواليه، ولا يعاديه، ولا يصغي إلى ما جاء به ألبتة”.
(98) تحفة المحتاج (9/269).
(99) تنوير الأبصار المطبوع مع الحاشية (4/174).
(100) الحاشية على الشرح الكبير (2/188).
(101) بدائع الصنائع (7/130).
(102) مجموع الفتاوى (28/241).
(103) بدائع الصنائع (7/131).
(104) فتح الباري (5/232).
(105) الدر المختار (4/175).
(106) الفتاوى الهندية (2/232).
(107) فتح الباري (4/47).
(108) فتح الباري (6/39).
(109) الأم (7/369).
(110) مجموع الفتاوى (28/240).
(111) ينظر فتوى: هل البلادُ الإسلاميةُ اليومَ دارُ كفر؟ هيئة الشام الإسلامية، باختصار.
(112) أحكام القرآن (2/275).
(113) مجموع الفتاوى (7/70).
(114) منهاج السنة النبوية (5/113).
(115) تفسير السّعدي ص (388).
(116) وعلى ذلك فتاوى أكثر أهل العلم في البلاد التي حصلت فيها هذه الانتخابات كمصر، وتونس، وليبيا، والمغرب، وغيرها، ومن الفتاوى المنشورة التي عالجت هذه القضية:
– فتوى المجمع الفقهي الإسلامي في دورته (19) بتاريخ 27/10/1428ه، الموافق 8/11/2007م، في حكم المشاركة السياسية في البلدان غير الإسلامية.
– فتوى الشيخ يوسف القرضاوي أثناء حلقة (مشروعية الدستور وحكم الاستفتاء عليه) ) في حلقة على قناة الجزيرة بتاريخ 4/9/ 2004م، والمنشورة على موقعه.
– فتوى الشيخ عبد الرحمن البراك عن حكم المشاركة في الحكومة وصياغة النظام في مصر بعد الثورة، المنشورة على موقعه بتاريخ 9 ربيع الأول 1432ه.
– مقال: حتى نفهم فتوى البراك، مقال للشيخ ناصر العمر، منشور على موقع المسلم.
– فتوى: الدستور المصري والتصويت عليه، للشيخ عبد العزيز الطريفي، منشورة على موقعه بتاريخ 1/2/1434ه.
(117) رعاية شؤون المجتمع وخدمته والقيام بمصالح الناس، والحفاظ على دينهم وأخلاقهم، أمورٌ لا يقيم لها الغلاة وزنًا؛ لأنَّ مشروعهم يقوم على حمل السلاح، أو الهجرة إلى بلادٍ أخرى فحسب، وما عدا ذلك فعبث كما سبق نقل أقوالهم فيه!
(118) مجموع الفتاوى (28/502).
(119) أحكام القرآن (2/94).
(120) وللتوسع ينظر: تكفير الجنود والعسكر، دراسة شرعية في انحراف الغلاة، د. سلطان العميري.
(121) مجموع الفتاوى (28/468).
(122) مجموع الفتاوى (13/215).
(123) مجموع الفتاوى (28/535).
(124) ويتعلق بهذا الموضوع شبهة تكفير المسلمين المتعاملين مع الدول والأنظمة في قتال الغلاة، وللرد عليها بالتفصيل ينظر الإجابة عن الشُّبهة التّاسعة عشرة: الفصائل الأخرى توالي الكفّار في قتال تنظيم) الدّولة)، ص (253) من كتاب شبهات تنظيم (الدولة)، للكاتب.
(125) أخرجه البخاري (9/47، برقم 7055)، ومسلم (3/1470، برقم 1709).
(126) شرح النووي (12/229).
(127) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/111).
(128) للمزيد ينظر: الاستطاعة، للشيخ محمد سرور.
(129) ينظر: الرد على شبهة (لا يفتي قاعد لمجاهد) من كتاب شبهات تنظيم الدولة، للكاتب، ص (17).
(130) الموافقات (5/177).
(131) أخرجه البخاري (4/51، برقم 2966)، ومسلم (3/1362، برقم 1742).
(132) أخرجه الترمذي (4/523، برقم 2254)، وغيره.
(133) أخرجه البخاري (4/15، برقم 2786)، ومسلم (3/1503، برقم 1888).
(134) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (14/83).
(135) مجموع الفتاوى (28/390).
(136) ويُقتصر في هذه الحالة على ما يضطر إليه الناس من مسائل القتال والقضاء، كأحكام جهاد الدفع، والهدن، والغنائم، وأحكام الزواج والطلاق وفسخ النكاح، والمفقودين، دون التوسع إلى ما لا يضطرون إليه مما هو شأن الحاكم العام المستقر، كأحكام التصرف في العقارات، وفرض الزكاة، ونحو ذلك، ينظر مثلًا: فتوى حكم أخذ الزكاة عنوة والاختطاف لتمويل الكتائب، هيئة الشام الإسلامية.
(137) غياث الأمم (1/387).
(138) أخرجه البخاري (9/4، برقم 6874)، ومسلم (1/98، برقم 161).
(139) أخرجه مسلم (1/68، برقم 73).
(140) أخرجه أبو داود (6/144، برقم 4013).
(141) الإيمان، لأبي عبيد لقاسم بن سلام (1/85).
(142) فتح الباري (10/444)، فالنفيُ لكمال الإيمان الواجب؛ لأنّ الشيءَ لا يُنفى إلا لتفويتٍ شيءٍ مِن واجباته.
(143) فيض القدير (6/104).
(144) اقتضاء الصراط المستقيم (1/270).
(145) تفسير الطبري (6/313).
(146) تفسير الماوردي (2/46).
(147) التحرير والتنوير (6/230).
(148) الدرر السنية (8/342).
(149) من تطبيقات هؤلاء الغلاة: اعتبار أن الدخول في حلف دولي ضد الخوارج، أو تلقي إعانة من أي دولة إقليمية أو عالمية هو من الموالاة للكفار، وينظر للرد على هذه الشبهة فتوى: حكمُ مشاركة الفصائل السُّورية في تحالفاتٍ عسكرية وتلقّيها للدّعم الدّولي، هيئة الشام الإسلامية.
(150) تفسير الطبري (9/320).
(151) تفسير الواحدي (1/296).
(152) المغني (13/141).
(153) وقد فصل ذلك واستدل له أبو يحيى الليبي في كتابه: التترس في الجهاد المعاصر، وأثنى عليه الظواهري في كتاب التبرئة.
(154) ينظر: براءة الموحدين من عهود الطواغيت وأمانهم للمحاربين، لعصام البرقاوي (أبو محمد المقدسي)، وكتاب التبرئة للظواهري.
(155) وللمزيد ينظر مقال: مفاهيم لترشيد الجهاد (5): جهاد لا إفساد، للكاتب.
(156) ينظر: حقيقة الحرب الصليبية، ليوسف العييري.
(157) الأم (4/263).
(158) الصارم المسلول على شاتم الرسول (1/278).
(159) أطال الظواهري في كتاب (التبرئة) الحديث عن أن تأشيرة دخول بلاد الكفار ليست أمانًا اعتمادًا على أن تعريفها يخلو من لفظ الأمان، وهذا كلام من لم يفقه النصوص الشرعية ولا كلام أهل العلم.
(160) أخرجه البخاري (5/90، برقم 4037) وبوب عليه (باب الكذب في الحرب)، ومسلم (3/1425، برقم 1801).
(161) أخرجه في شرح مشكل الآثار (1/190).
(162) شرح النووي (12/160).
(163) تفسير الطبري (3/562).
(164) أخرجه البخاري (4/61)، ومسلم (2/1364).
(165) شرح النووي (12/48).
(166) المغني (9/313).
(167) أخرجه البخاري (4/61، برقم 3012)، ومسلم (3/1364، برقم 1745).
(168) معالم السنن (2/282).
(169) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/148).
(170) نيل الأوطار (5/355).
(171) أخرجه الترمذي (4/461، برقم 2159)، وابن ماجه (2/890، برقم 2669)، وأحمد (25/465، برقم 16064).
(172) فضائح الباطنية (1/156).
(173) فضائح الباطنية (1/156)، والحديث أخرجه البخاري (4/61، برقم 3017).
(174) الحاوي الكبير (13/444).
(175) فتح القدير (6/98).
(176) أخرجه مسلم (3/1340، برقم 1715).
(177) تنوَّعت عبارات أهل العلم في بيان مفهوم الجماعة، ولعلّ مِن أشمل مَن جمعها الشاطبي في الاعتصام (2/770)، حيث ذكر أنها ترجع إلى خمسة أقوالٍ، وهي:
1- أنها السواد الأعظم مِن أهل الإسلام.
2- جماعة أئمة العلماء والمجتهدين.
3- الصحابة على وجه الخصوص.
4- جماعة أهل الإسلام إذا أجمعوا على أمر.
5- جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير.
وغالبُ تفاوت أقوالهم من اختلاف التنوع والعبارات، لا اختلاف التضاد، وهي تؤول إلى معنيين:
الأول: أنها ما كان عليه رسول الله وصحابته رضي الله عنهم، من الاعتقاد والقول والعمل، مما لا يسوغ لأحد من المسلمين أن يخالفه.
الثاني: أنها الاجتماع على خليفة شرعي، وطاعته بالمعروف، وحرمة منازعته الأمر، ما لم يُر منه الكفر البواح.
ينظر: مفهوم جماعة المسلمين، د. عبد الرحمن اللويحق ص (18).
(178) ينظر: الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة، د. عبد الرحمن اللويحق ص (215).
(179) ينظر مقال: بين منهجين، المقالة (48).
(180) شرح النووي (13/67)، ويتظر: فتح الباري (13/295).
(181) مجموع الفتاوى (2/484).
(182) مجموع الفتاوى (20/164).
(183) ينظر: معالم ومنارات في تنزيل نصوص الفتن والملاحم وأشراط الساعة، د. زاهر بن محمد الشهري ص (41) وما بعدها.
(184) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، للقرطبي (1/1222).
(185) أخرجه أبو داود (3/306، برقم 2608).
(186) أخرجه مسلم (3/1478، برقم 1851).
(187) أخرجه أبو داود (6/302، برقم 4248)، وابن ماجه (5/103، برقم 3956)، وأحمد (6/54، برقم 6501).
(188) أخرجه مسلم (3/1480، برقم 1852).
(189) تاريخ ابن خلدون (1/261).
(190) أخرجه مسلم (3/1483، برقم 1856).
(191) شرح النووي (13/3).
(192) تاريخ الطبري (3/401).
(193) معالم السنن (2/260).