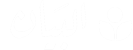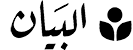تمهيد:
من الأمراض الفكرية الخطيرة التي ابتليت بها الأمة الإسلامية في مراحل مبكرة من تاريخها داء (الغلو في التكفير) الذي كان أصحابه أول الفرق البدعية ظهورا في الإسلام، وهم فرقة (الخوارج) المعروفة التي كفرت وقاتلت الخليفة الراشد علي بن أبي طالب ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم.
ونظرا لخطورة ظاهرة الغلو في التكفير، وتداعياتها المختلفة، وأثرها المباشر في التوسع في القتل والتهجير، وشيوع ثقافة التدمير والتفجير، وانتشار الفوضى في كثير من بلدان العالم اليوم، فإنه من المتعين على أهل الاختصاص تناولها بالدراسة والبحث من جوانبها المختلفة، ببيان حقيقتها، والموقف الشرعي منها، وذكر أهم أسبابها، ومظاهرها، والرد على أصحابها، وتقديم مقترحات تساعد في حلها.
وهذا ما ستحاول هذه الورقة التعرض له بشيء من الإيجاز تمليه عوامل مختلفة، على أمل أن نبسط الكلام في الموضوع لاحقا من خلال دراسات وبحوث أوسع. وسوف نتناول هذا الموضوع في عدد من المطالب على النحو التالي:
المطلب الأول: حقيقة الغلو في التكفير.
المطلب الثاني: أنواع الكفر وأهمية التفريق بينها.
المطلب الثالث: التحذير من الغلو في التكفير.
المطلب الرابع: أسباب الغلو في التكفير.
المطلب الخامس: مظاهر الغلو في التكفير
المطلب السادس: مقترحات لعلاج ظاهرة الغلو في التكفير.
ثم نختم بخلاصة للورقة، مذيلين إياها بقائمة بأسماء المراجع والمصادر، وفهارس للموضوعات.
وسوف نحاول في تناولنا لمحاور الموضوع المختلفة الجمع بين تأصيل الأفكار بالأدلة، وتوثيق النقول من المراجع، وعرض المادة بصورة سهلة وقريبة، قدر المستطاع.
المطلب الأول: حقيقة الغلو في التكفير
الغلو لغة: الارتفاع في الشيء ومجاوزة الحد فيه، ومنه قوله جل وعز: {لا تغلوا في دينكم} (النساء: 171) أي: لا تجاوزوا المقدار. (1)
والغلو في الدين: هو مجاوزة حد الحق فيه. (2)
والكفر في اللغة: التغطية والستر، تقول العرب للزراع كفارا، لأنهم يضعون الحب في الأرض ويغطونه بها، ومنه قوله تعالى {كمثل غيث أعجب الكفار نباته} (الحديد/20)
والكفر في الشرع: ضد الإيمان، ونقيضه.
يقول ابن حزم رحمه الله في تعريف الكفر شرعا: “وهو في الدين: صفة من جحد شيئاً مما افترض الله تعالى الإيمان به، بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه بقلبه دون لسانه، أو بلسانه دون قلبه، أو بهما معاً، أو عمل عملاً جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإيمان” (3) ويقول ابن تيمية رحمه الله: ” الكفر عدم الإيمان بالله ورسله، سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل شك وريب، أو إعراض عن هذا كله حسدا، أو كبرا، أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة، وإن كان الكافر المكذب أعظم كفرا، وكذلك الجاحد المكذب حسدا مع استيقان صدق الرسل”. (4)
والتكفير هو الحكم على عمل (اعتقاد، أو قول، أو فعل) بأنه مكفر، أو على شخص معين بأنه كافر. والغلو في التكفير نريد به التوسع ومجاوزة الحدود والضوابط الشرعية في الموضوع بتكفير من ثبت وتقرر إسلامه بيقين، دون النظر إلى توفر الشروط وانتفاء الموانع المعتبرة شرعا. وبهذا المعنى للغلو في التكفير يخرج الحكم بكفر الكافر الأصلي الذي لم يدخل في الإسلام أصلا، فهذا لا خلاف في كفره، فتكفيره ليس من الغلو في التكفير. ويخرج أيضا الحكم بكفر من ارتد عن الإسلام، وتوفرت فيه شروط الردة المعروفة شرعا، وانتفت في حقه الموانع، وحكم بردته مخول ومؤهل للحكم، فهذا ليس غلوا في التكفير، بل هو تكفير شرعي منضبط.
المطلب الثاني: أنواع الكفر وأهمية التفريق بينها
قسم أهل العلم الكفر إلى أقسام متعددة، وكل تقسيم هو باعتبار معين؛ فقد قسموا الكفر المخرج من الملة إلى أربعة أنواع هي:
كفر الإنكار: وهو أن يكفر بقلبه، ولسانه، ولا يعتقد الحق، ولا يقر به.
وكفر الجحود: وهو أن يعرف الحقَ بقلبه، ولا يُقر بلسانه، ككفر إبليس، وهو المذكور في قوله تعالى: {فَلَمَّا جَآءهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ} (البقرة: 89) يعني كفر الجحود.
وكفرُ المعاندة: وهو أن يعرفَ بقلبه، ويقرَّ بلسانِهِ، ولا يقبلُ ولا يتدينُ به، ككفرِ أبي طالب.
وكفرُ النِّفاق: وهو أن يقرَّ بلسانِهِ، ويكفرَ بقلبه” (5)
وقد ذكر ابن القيم تقسيما قريبا من هذا للكفر الأكبر فقال:
“وقد بيّن القرآن أن الكفر أقسام:
أحدها: كفر صادر عن جهل وضلال وتقليد الأسلاف وهو كفر أكثر الأتباع والعوامّ.
الثاني: كفر جحود وعناد وقصد مخالفة الحق، ككفر مَن تقدّم ذكره.
الثالث: كفر إعراض محض لا ينظر فيما جاء به الرسول ولا يحبّه ولا يبغضه ولا يواليه ولا يُعاديه بل هو مُعرِض عن متابعته ومُعاداته”. (6)
وأكثر هذه التقسيمات لا تترتب عليه نتيجة مهمة بالنسبة لموضوعنا خلا تقسيم الكفر إلى كفر أكبر وكفر أصغر، وتقسيمه إلى كفر نوع وكفر عين، فهذان التقسيمان لهما أثر بالغ في موضوعنا، لما يترتب على الخلط بينهما من أخطاء جسيمة في باب التكفير. ولذلك سوف نفرد كل واحد منهما بالكلام.
أولا: الكفر الأكبر والكفر الأصغر
الكفر الأكبر هو الكفر المخرج من الملة، المخلد صاحبه في النار يوم القيامة، وهو المراد بالكفر عند الإطلاق، وهو المقصود في التعريفات السابقة في المطلب الأول. أما الكفر الأصغر فالمراد به ما وصفه الشرع من الأعمال بأنه كفر، ولكن دلت الأدلة على أنه لا يخرج به صاحبه من الإسلام، ولا يخلد به في النار. وسوف تأتي معنا أمثلة عديدة له في هذا المطلب إن شاء الله.
وعدم التفريق بين الاثنين كان سببا من أسباب الخطإ الجسيم في باب التكفير عند الغلاة قديما وحديثا، لذلك كان لابد من التفريق بينهما. من خلال تتبع نصوص الكتاب والسنة، وأقوال علماء الأمة وُجد أن الشارع يطلق وصف الكفر، والنفاق، ونفي الإيمان، وما في معنى ذلك على من يرتكب أعمالا تشهد أدلة الشريعة وقواعدها أنها لا يخرج بها المسلم من الملة، وإن كانت من الكبائر العظام. ولذلك أشكلت هذه النصوص على بعض الناس في الصدر الإسلامي الأول.
والذي يهمنا هنا هو المذهب الذي تشهد له الأدلة بالصحة، وهو مذهب أهل السنة.
وخلاصة هذا المذهب أن الكفر الوارد في هذه النصوص وشبهها ليس الكفر الأكبر المخرج من الملة، بل هو كفر دون ذلك. وقد عبر عنه أهل العلم بعبارات متقاربة المعنى مثل قولهم إنه (كفر دون كفر)، أو (ليس هو بالكفر الذي يذهبون إليه) أو (ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله) ونحو هذه العبارات. وقالوا مثل ذلك في (الشرك) و (الظلم) و (الفسق) و (النفاق). وقد أجاد ابن القيم رحمه الله وأفاد وأصل وفصل في هذا الموضوع في مواضع متعددة من كتبه وخاصة في كتابيْ (مدارج السالكين) و(الصلاة وأحكام تاركها). وفيما يلي مجمل كلامه في هذه الموضوع منقولا من كتابه الأخير وقد نقلته بطوله للأهمية البالغة.
يقول ابن القيم رحمه الله: “فصل في نوعي الكفر: وها هنا أصل آخر وهو أن الكفر نوعان: كفر عمل وكفر جحود وعناد، فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحودا وعنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه، وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه. “وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان، وإلى ما لا يضاده، فالسجود للصنم، والاستهانة بالمصحف، وقتل النبي وسبه، يضاد الإيمان”.
ومثل -رحمه الله- للكفر العملي الذي لا يخرج من الملة، فقال: “وقد نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني، والسارق، وشارب الخمر، وعمن لا يأمن جاره بوائقه، وإذا نفى عنه اسم الإيمان فهو كافر من جهة العمل، وانتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد. “وكذلك قوله: (لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض) (7) “فهذا كفر عمل، وكذلك قوله: (من أتى كاهنا فصدقه، أو امرأة في دبرها، فقد كفر بما أنزل على محمد). (8) “وقوله: (إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما)”. (9)
ثم واصل رحمه الله ذكر الأدلة على التفصيل المذكور فقال: “وقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم بما قلناه في قوله في الحديث الصحيح: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) (10)، ففرق بين قتاله وسبابه وجعل أحدهما فسوقا لا يكفر به، والآخر كفرا، ومعلوم أنه إنما أراد الكفر العملي لا الاعتقادي، وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية، كما لا يخرج الزاني والسارق والشارب من الملة وإن زال عنه اسم الإيمان”.
ثم بيّن رحمه الله أن هذا التفصيل هو مذهب السلف من الصحابة فمن بعدهم فقال: “وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله، وبالإسلام، والكفر ولوازمهما، فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم”. (11، 12)
إذا عرفنا ذلك، وعلمنا الفرق بين مراتب وأنواع الكفر أدركنا حجم وخطورة الخطأ الذي وقع فيه من لم يفرق بينها بسبب الجهل، فقادهم ذلك إلى الحكم على من ارتكب كفرا أصغر بالكفر الأكبر والخروج من الملة، وما يترتب على ذلك من استباحة دمه، وماله، وعرضه!
ثانيا: الفرق بين كفر النوع وكفر العين
مرادنا بكفر النوع هنا الأعمال التي ثبت شرعا كونها كفرا. ومرادنا بكفر العين هو ثبوت حكم الكفر في حق مرتكب تلك الأعمال. وكثيرا ما يقع بعض الناس في الخلط في هذا الموضوع ظانين التلازم بين الأمرين، وأن كل من ارتكب مكفرا صار كافرا بصورة تلقائية، دون النظر في حاله، وما يلزم قبل الحكم بكفره من النظر في توفر شروط التكفير، وانتفاء موانعه.
والصواب أن الأقوال والأفعال الكفرية، قد تصدر من شخص، فيقال إنها كفر، ولكن الحكم بأنها كفر لا يستلزم بالضرورة الحكم بكفر صاحبها الذي قد لا تتوفر فيه الشروط التي يكفر صاحبها، وقد تتوفر الشروط، ويوجد لديه مانع أو أكثر يمنع من الحكم بكفره، كالجهل، والتأويل، والإكراه.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مبينا هذا الأمر: “وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون بلغته ولم تثبت عنده، أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها، فمن كان من المؤمنيـن مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فان الله يغفر له خطأه كائنـا ما كان، سواء كان في المسائل النظرية أو العملية، هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام”. (13) وبهذا التفريق بين التكفير المطلق، وتكفير المعين يزول إشكال كبير وقع فيه غلاة التكفير قديما وحديثا.
المطلب الثالث: التحذير من الغلو في التكفير
تكفير المسلم أمر خطير وكبير، ومن خطورته بعض ما يترتب عليه من:
1- الوعيد الشديد المترتب عليه في حق المكفِّر (إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما). (14)
2- استباحة دم المكفَّر.
3- رفع الحصانة عن ماله.
4- التفريق بينه وبين زوجته.
5- قطع موالاته مع المسلمين.
6- عدم تغسيله، أو تكفينه، أو الصلاة عليه، أو دفنه في مقابر المسلمين، أو الاستغفار له.
7- عدم إرثه، أو توريثه من ورثته.
8- الحكم بتخليده في النار.
9- وإذا كان المحكوم بكفرهم جماعة لهم شوكة، فإن ذلك يترتب عليه قتال واحتراب بين المسلمين، تزهق فيه الأرواح، وتنتهك الأعراض، وتتلف الأموال.
10- وقد يكون ذلك ذريعة لتدخل أعداء الأمة مع هذا الطرف أو ذاك، فتتسع دائرة الصراع، وتتمدد رقعة الحرب.
ولذلك وغيره كان الخوض في موضوع التكفير والتسرع فيه مزلة أقدام، ومدحضة أفهام، أحجم عنه كثير من الأئمة الأعلام، وحذر منه ذوو الحجى والأفهام. والأدلة في ذلك متضافرة متظاهرة، وسوف نذكر باختصار بعض ما تيسر من ذلك من القرآن والسنة، وأقوال علماء الأمة، من السلف، والخلف، وأصحاب المذاهب، والمتكلمين، والمجددين المصلحين، عبر تاريخ الإسلام.
فمن الآيات القرآنية الناهية والمحذرة من تكفير المسلم قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا} (النساء:94). أورد ابن كثير رحمه الله في سبب نزول هذه الآية ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس قال: “مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم وهو يسوق غنماً له فسلم عليهم، فقالوا: ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا، فعمدوا إليه فقتلوه، وأتوا بغنمه النبي صلى الله عليه وسلّم، فنزلت هذه الآية {يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا} إلى آخرها، ورواه الترمذي في التفسير عن عبد بن حميد، عن عبد العزيز بن أبي رزمة، عن إسرائيل به، وقال: هذا حديث حسن، وفي الباب عن أسامة بن زيد، ورواه الحاكم من طريق عبيد الله بن موسى عن إسرائيل به، ثم قال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه”. (15) فسبب نزول هذه الآية كما هو ثابت يبين حالة مبكرة من حالات التسرع في تكفير أهل القبلة، رد عليها القرآن بكل قوة ووضوح.
ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم: (من دعا رجلا بالكفر أوقال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه). (16) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في معنى الحديث: “وحار بمهملتين: أي رجع، وهذا يقتضي أن من قال لآخر أنت فاسق، أو قال له أنت كافر، فإن كان ليس كما قال كان هو المستحق للوصف المذكور، وأنه إذا كان كما قال لم يرجع عليه شيء، لكونه صدق فيما قال”. (17)
أما مذاهب الأئمة المتبوعين في التحذير من الغلو في التكفير، فالمنقول من مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يكفر أحدا من أهل القبلة. قال التفتازاني في (شرح المقاصد) في علم الكلام عند كلامه على الخلاف في تكفير المخالف من أهل القبلة في بعض الأصول: “فذهب الشيخ الأشعري وأكثر الأصحاب إلى أنه ليس بكافر، وبه يشعر ما قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا أرد شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية لاستحلالهم الكذب. “وفي المنتقى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لم يكفر أحدا من أهل القبلة، وعليه أكثر الفقهاء (…) واختيار الإمام الرازي أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة”. (18)
وأما الإمام مالك رحمه الله، فالمعروف عنه عدم تكفير أهل القبلة من أهل الأهواء، مع شدته وتغليظه في الإنكار عليهم، بل والقول بقتل من لم ينقطع شره إلا بالقتل أحيانا. ويقول ابن عبد البر رحمه الله في كتاب التمهيد “ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: (من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما) (19)، قوله صلى الله عليه وسلم: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) (20)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض)، (21) وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم). (22)
“ومثل هذا كثير من الآثار التي وردت بلفظ التغليظ، وليست على ظاهرها عند أهل الحق والعلم، لأصول تدفعها نصوص أقوى منها من الكتاب والسنة المجمع عليها والآثار الثابتة أيضا من جهة الإسناد”. (23)
والمشهور من مذهب الشافعي رحمه الله عدم تكفير المخالفين في بعض الأصول من أهل القبلة، بل عدم فسقهم أو رد شهادتهم. يقول الشافعي رحمه الله في الأم: “فلمْ نعلمْ أحداً من سلف هذهِ الأمة يقتدى بهِ، ولا منَ التابعينَ بعدهمْ ردَّ شهادة أحدٍ بتأويلٍ، وإنْ خطَّأهُ، وضللهُ، ورآهُ استحلَّ فيهِ ما حرمَ عليهِ، ولا ردّ شهادة أحدٍ بشيءٍ منَ التأويلِ كانَ لهُ وجه يحتملهُ، وإنْ بلغَ فيهِ استحلالَ الدم، والمال، أوِ المفرط منَ القولِ”. (24) الإمام الشافعي كما رأينا لم يفسق هؤلاء فضلا عن أن يكفرهم.
وأما الإمام أحمد فقد قال في وصيته المشهورة لمسدد بن مسرهد: “ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرجه من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم أو برد فريضة من فرائض الله تعالى جاحدا بها، فإن تركها كسلا أو تهاونا كان في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه”. (25) ومما نقل عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله في عدم تكفيره لأحد من أهل القبلة، ما ذكره الذهبي رحمه الله حيث قال: “رأيت للأشعري كلمة أعجبتني، وهي ثابتة رواها البيهقي: سمعت أبا حازم العبدري، سمعت زاهر بن أحمد السرخس. يقول: لما قرب حضور أجل أبي الحسن الأشعري في داري ببغداد، دعاني فأتيته، فقال: اشهد علي أني لا أكفر أحدا من أهل القبلة، لأن الكل يشيرون لمعبود واحد، وإنما هذا كله اختلاف العبارات”. (26) وقد علق الذهبي رحمه الله على كلام أبي الحسن الأشعري رحمه الله هذا قائلا: “قلت (أي الذهبي): وبنحو هذا أدين، وكذا كان شيخنا ابن تيمية في أواخر أيامه يقول: أنا لا أكفر أحدا من الأمة، ويقول: “قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن) (27) فمن لازم الصلوات بوضوء فهو مسلم”. (28)
ومن الأئمة المجتهدين غير المحسوبين على مذهب معين، والذين كانوا على هذه الشاكلة الإمام الشوكاني رحمه الله الذي بين في كتبه المختلفة، وبالذات المتأخرة منها خطورة تكفير المسلمين، وحذر من ذلك أشد التحذير. ومن كلامه في ذلك: “اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام، ودخولـه في الكفر، لا ينبغي لمسلم يؤمن باللـه واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار، فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة أن (من قال لأخيه يا كافر، فقد باء بها أحدهما).. هكذا في الصحيح. “وفي لفظ آخر في الصحيحين وغيرهما: (من دعا رجلا بالكفر، أو قال عدو اللـه، وليس كذلك، إلا حار عليه، أي رجع. “وفي لفظ في الصحيح: (فقد كفر أحدهما) (29) “ففي هذه الأحاديث، وما ورد موردها أعظم زاجر، وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير”. (30)
وبمثل هذه الأدلة والنقول تتبين خطورة التسرع في التكفير، والإقدام عليه دون توفر شروطه، وانتفاء موانعه، وأخذ الحيطة والحذر في بابه.
المطلب الرابع: أسباب الغلو في التكفير (31)
للغلو في الدين بصورة عامة، والتكفير بصورة خاصة أسباب عامة مشتركة، وأسباب خاصة ببعض المجتمعات والدول. وسوف نحاول التركيز على أبرز الأسباب العامة، وأهمها:
1. الجهل
أغلب الغلاة بصورة عامة، والغلاة في باب التكفير بصورة خاصة يغلب عليهم الجهل وقلة الفقه في أمور الدين على العموم، وفي أحكام التكفير، ونواقض الإيمان على الخصوص. وهذا الجهل يظهر في الأحكام والفتاوى التي يصدرونها بحق مخالفيهم، بل في حق بعضهم أحيانا! فهم بسبب الجهل يحكمون أحيانا بالكفر الأكبر على مرتكب كفر أصغر، ويلازمون بين كفر النوع وكفر العين، ويخلّطون في أبواب نواقض الإيمان، كالحكم بغير ما أنزل الله، وموالاة المشركين، إلخ. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال في الخوارج الأوائل (يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يقرءون القرآن، لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة) (32) وفي رواية: (لا يجاوز تراقيَهم، ولا تعيه قلوبهم). فهذا الحديث وما في معناه من صفات هؤلاء يبين ما هم فيه من عدم الفقه في الدين، مع ما هم عليه من الاجتهاد في العبادة.
2. الخلل التربوي
من أسباب الغلو في التكفير عند كثير من الغلاة اليوم الخلل التربوي الحاصل بسبب عملية الشحن العاطفي والفكري التي تقوم بها بعض الجماعات الإسلامية أثناء تربية وتوجيه أتباعها دون توازن، ففي حين تقصّر هذه الجماعات في جوانب التربية الإيمانية التي تصلح القلوب وتهذب النفوس، وتهمل العلم الشرعي، والتفقه في الدين الذي يعرف به الحق من الباطل والصواب من الخطإ، تهتم كثيرا بالجوانب الفكرية، والشحن العاطفي غير المنضبط بالعلم والتربية الصحيحة، الأمر الذي يدفع كثيرا من الغلاة إلى الوقوع فيما وقعوا فيه من الغلو في التكفير. ومن أسباب الخلل الحاصل في عملية التربية عند كثير من الشباب اليوم أنهم لم يتربوا على أيدي مربين ربانيين، ولم يتعلموا على علماء عاملين، بل كان شيوخهم الكتب، والأشرطة، والمجلات، والمواقع الإلكترونية. ومن النتائج السيئة لهذا الخلل حصول فجوة كبيرة بين الغلاة وبين العلماء، كان من مظاهرها تصدر الجهال للفتوى دون مؤهلات لذلك، فصاروا رؤوسا جهالا يفتون بغير علم، فضلوا وأضلوا. وهذا يحيلنا على السبب الثالث.
3. عدم قيام العلماء بواجبهم
من أهم أسباب الغلو عند الشباب المسلم اليوم أن علماء الأمة لم يقوموا بالواجب الملقى على عواتقهم في توجيه، وتعليم، وترشيد، وتربية، ونصح الشباب المسلم بالطرق المناسبة. فهنالك فريق من العلماء التحقوا بركب الحرب على الإسلام من قِبل أعدائه الدوليين، والمحليين، فانحصر دورهم في إصدار فتاوى تأتي في الغالب بناء على طلب هذا التحالف، فأساؤوا بذلك إلى أنفسهم، وإلى دينهم، وأمتهم، وفقدوا مصداقيتهم، فكانوا بذلك سببا إضافيا من أسباب الغلو عند الشباب الذين تولدت لديهم ردة فعل مضادة. وهنالك فريق آخر من العلماء لم يقع فيما وقع فيه الفريق الأول، ولكنهم انشغلوا بأمور مهمة عما هو أهم، فانشغلوا بالأمور المريحة التي لا تجلب متاعب، ولا تتسبب في مشاكل. ولعل هؤلاء يعتذر لهم بأنهم لم تتح لهم الفرصة من قبل السلطات للقيام بواجبهم كما يريدون، ولم يقبلوا أن يوظًّفوا كما وُظف الفريق الأول، فآثروا السلامة، والنأي بأنفسهم عن الموضوع. وبقيت قلة من أهل العلم هي التي اهتمت بالموضوع، وصبرت على ما يكال لها، ويقال في حقها من تهم من طرف كل من الغلاة، والجفاة. ولكن الواجب أكبر بكثير من طاقات هؤلاء وإمكاناتهم.
4.الخلل في المناهج الدراسية
من أسباب الغلو المهمة الخلل التعليمي والتربوي الموجود في المناهج الدراسية، فكثير من المناهج التعليمية في المدارس والجامعات الحكومية في كثير من البلاد الإسلامية هي مناهج علمانية. ومادة التربية الإسلامية في هذه المناهج مادة هزيلة، قليلة، مشوهة، لا تشفي عليلا، ولا تروي غليلا. والأجيال التي تتخرج على هذه المناهج تتخرج جاهلة بدينها، وعقيدتها، وشريعتها، وهويتها، ولو كانت متميزة في تخصصاتها، فقد تجد دكتورا متخصصا، ولكنه عامي في دينه. والجاهل الذي لا حصانة له من علم صحيح، أو تربية سليمة عرضة للتأثر بفكر الغلو والغلاة كما مر معنا. وهذا ما يفسر أن كثيرا من المنتمين لجماعات الغلو هم من خريجي المدارس والجامعات الحكومية، أو غير المتعلمين أصلا. ويقل بينهم خريجو المدارس الإسلامية التقليدية غير الحكومية. وهنالك دول إسلامية أخرى تهتم مناهجها الدراسية بالدراسات الإسلامية، ولكنها لم تول جوانب بناء الشخصية الإسلامية المتكاملة، والمتزنة المعتدلة، العناية الكافية. ولما انتبهت السلطات إلى أهمية المناهج الدراسية، وتأثيرها في الجوانب الفكرية والسلوكية للشباب، عالجت الموضوع بصورة خاطئة، فغيرت المناهج، وعدلت المقررات الدراسية، ولكن بناء على مقترحات وطلبات من ساسة، وخبراء تربويين، وأمنيين، وسياسيين من الدول الغربية!! وكانت تلك التعديلات جزءا مما يسمى (الحرب على الإرهاب)! ومن التعديلات التي حصلت على المناهج في بعض الدول الإسلامية، حذف بعض الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، والموضوعات الأخرى!! وكانت نتائج تلك التعديلات عكسية، حيث شعر المسلمون أن الغربيين، وحلفاءهم من الحكام المحليين يحاربونهم في دينهم، ويتدخلون حتى في نوع التعليم الذي يتلقاه أبناؤهم، فكان ذلك عاملا من عوامل أخرى غذت غلو الغلاة.
5. الانحراف العام عن الإسلام
من الأسباب التي غذت الغلو في التكفير شيوع المنكرات العظام، والموبقات الجسام في المجتمعات المسلمة المختلفة. فخلال القرون الأخيرة –ولأسباب متعددة داخلية وخارجية-ابتعدت الأمة عن التمسك بدينها بشكل لم يحصل من قبل، فشاعت فيها كثير من المنكرات الغليظة، والفواحش الشنيعة، فانتشرت البدع والشركيات، كالاستغاثة بالأموات، وعبادة القبور وأصحاب المقامات، وكثرت المعاصي والمحرمات، فانتشر التعامل بالربا، وعم العري والزنا، وفسدت الأخلاق، وحوربت الفضيلة، وراجت الرذيلة. رافق كل ذلك غياب شبه تام لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والاحتساب على الناس، فشكل كل ذلك استفزازا لمشاعر كثير من الشباب المدفوع بعاطفة قوية ليس لها خطام من فقه، ولا زمام من تربية، ولا لجام من تجربة، فتأججت مشاعر الرفض، وتحولت إلى غلو قاد في النهاية إلى التكفير.
6. استبداد الحكام ومحاربتهم للإسلام
مع مجيء حكام ما بعد (سايكس بيكو) في العالم الإسلامي واصل هؤلاء الحكام سياسة محاربة الإسلام التي بدأها المستعمر على مختلف الصعد، فمكنوا لأذناب المستعمرين، وأصحاب الأفكار الهدامة من علمانيين وليبراليين وشيوعيين، في مجالات التعليم، والثقافة، والإعلام، والفن، وغيرها. يضاف إلى ذلك سياسات هؤلاء الحكام في تعطيل الشريعة الإسلامية، وتحكيم القوانين الغربية، ومحاربة الإسلام ودعاته، والبطش والتنكيل الذي تعرض له الشباب المسلم في السجون، وسد سبل العمل القانوني أمام الحركات الإسلامية مما ساهم بشكل واضح في ظهور موجة التكفير التي بدأت بتكفير الحاكم، ووصلت إلى تكفير معظم الأمة عند بعض التكفيريين.
7. الغلو المضاد
من أسباب ظهور الغلو بصورة عامة، والغلو في التكفير بصورة أخص، ظهور الغلو المضاد الذي يتبجح بالكفر البواح، والردة العلنية، وسب الدين، والاستهزاء بالله ورسوله، والتطاول على الإسلام في حفاوة دولية، وتكريم علني للمرتدين والزنادقة في العالم!! هذا الأمر ولد ردة فعل معاكسة، وهذا أمر طبيعي، فالغلو في طرف يؤدي إلى الغلو في الطرف المقابل، وهذا معروف في تاريخ الفكر الإسلامي، فظاهرة الإرجاء كانت ردة فعل على ظاهرة التكفير عند الخوارج، والقدرية كانت ردة فعل على الجبرية.
8. استهداف المسلمين من قبل القوى الكبرى
من العوامل المغذية للغلو عموما، والغلو في التكفير خصوصا ما يشعر به المسلمون من استهداف منظم وممنهج لهم من قبل القوى الدولية الكبرى، ومن دول غربية محددة على وجه الخصوص. فالمسلمون يرون مثلا أن دعم الغرب لاحتلال فلسطين من قبل اليهود، واحتلال أفغانستان، والعراق، والجرائم التي ترتكب في حق الإسلام والمسلمين في أكثر من بلد مسلم، ودعم الأنظمة الفاسدة في العالم الإسلامي، ونهب خيرات المسلمين، وسلب ثرواتهم، ما هي إلا أمثلة على عداوات دول غربية معروفة للإسلام والمسلمين. هذا الشعور غذى روح السخط على الغرب، وكل المرتبطين به من الحكام وأذيالهم، والمتغربين من العلمانيين، والليبراليين، فكان من العوامل المغذية لروح الغلو في التكفير. وقد بسطنا الحديث في هذه النقاط في الورقة المشار إليها قبل.
المطلب الخامس: مظاهر الغلو في التكفير اليوم
قبل استعراض مظاهر الغلو في التكفير عند الغلاة اليوم لا بد من التذكير بأهم شروط وضوابط التكفير التي مر معنا أكثرها متفرقا حتى نحاكم إليها تلك المظاهر، ونبين وجه كونها من الغلو في التكفير. وأهم هذه الشروط والضوابط:
– أن يكون العمل (المكفِّر) الذي أقدم عليه الفاعل كفرا أكبر مخرجا من الملة بدلالة نص صحيح صريح من الكتاب أو السنة، أو إجماع ثابت منقول.
– أن يثبت على الفاعل ارتكاب العمل المكفر باعتراف صريح، أو بينة شرعية لا تقبل الشك.
– أن يكون الفاعل عالما بالحكم الشرعي، وبحقيقة العمل الذي قام به، غير جاهل جهلا يعذر به.
– أن يكون مختارا غير مكره.
– ألا يكون متأولا ولو تأويلا ضعيفا، أو متعلقا ولو بشبهة.
– ألا يكون مقلدا في ذلك تقليدا يعذر به مثله.
– أن تقام عليه الحجة، وتزال عنه الشبهة.
– أن يحكم عليه مؤهل لهذا الحكم الكبير الخطير من المتمكنين في العلم والمؤهلين للحكم.
– والمتتبع لساحة الغلو في التكفير اليوم يجد أن إهمال هذه الشروط، وعدم الانضباط بتلك الضوابط، والتساهل فيما يجب من الحيطة والحذر في هذا الباب من أهم مميزات هذه الساحة.
وأبرز مظاهر الغلو في التكفير في الساحة اليوم هي:
1. التكفير بغير مكفر
من الشروط التي لا يجوز تكفير أحد دون توفرها أن يكون الفعل الذي هو سبب الحكم عليه بالكفر كفرا أكبر مخرجا من الملة، بدلالة نص صريح صحيح من الكتاب أو السنة، أو إجماع متيقن. وهذا أمر خالفه غلاة التكفير قديما وحديثا، فقد كفروا بالكبيرة حينا، ويكفرون حتى بالمباح أحيانا، بل وبالطاعة في بعض الحالات نتيجة قلة العلم، وسوء الفهم!
ومن الأمثلة المعاصرة للتكفير بغير مكفر، بل بغير محرم أصلا تكفير بعض الغلاة لكل من يحمل وثائق رسمية، كالبطاقات الشخصية، وجوازات السفر، أو يتعامل بالعملات الرسمية، بحجة أن ذلك يمثل اعترافا بالحكومات المرتدة التي صدرت عنها، والاعتراف بها كفر!
وقد عشتُ مع بعض هؤلاء في مدينة (بيشاور) الباكستانية، ومنطقة (جلال أباد) الأفغانية سنة 1991-1992، وقد شكلوا يومها جماعة سموها جماعة (الخلافة) وكفروا وقاتلوا المسلمين المخالفين لهم، فسمعت ورأيت منهم عجبا من هذه الأقوال والأفعال! (33)
ومن التكفير بغير مكفر التكفير بالكبائر التي لا يخرج بها المسلم من الملة، وإن كان بعضها كفرا أصغر.
وقد وقعت بعض جماعات الغلو في التكفير بها، ومن هذه الجماعات (جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد) في نيجيريا المعروفة ب (بوكو حرام) فهذا الشيخ أبو يوسف مؤسس الجماعة يضع بعض هذه المنكرات ضمن ما يكون به الكفر البواح، فقد جاء في كتابه (هذه عقيدتنا ومنهج دعوتنا) في معرض الاستدلال والاعتقاد: “… ومن الكفر البواح أن يفشو وينتشر الزنا، والربا، والقمار، والرشوة، ونحو ذلك…” (34) ومن المعلوم أن المعاصي المذكورة في هذا الكلام كبائر، ولكن لا يخرج بها المسلم من دينه إلا بالاستحلال، وإنكار حكمها الشرعي.
2. التكفير بالمحتمل
من الشروط التي لا بد من توفرها في الفعل الذي يحكم بكفر صاحبه أن يكون نصا في الكفر لا يحتمل غيره، فإذا كان محتملا للكفر وغيره وجب التبين والتثبت لمعرفة الوجه الذي فعله الفاعل عليه. ومن أمثلة ذلك موالاة الكفار ومناصرتهم، فموالاة الكفار ومناصرتهم قد تكون ميلا إلى دينهم، وحبا في كفرهم، وعداء للإسلام وأهله، فهذه الموالاة كفر أكبر مخرج من الملة، لقوله تعالى: {ومن يتولهم منكم فإنه منهم} (المائدة:51). وقد تكون مناصرتهم ومولاتهم من أجل الحصول على منفعة دنيوية، مع بقاء بغض ما هم عليه من الكفر، فهذه الموالاة ليست كفرا، وإن كانت ذنبا عظيما.
وهنالك مراتب أخرى في الموالاة. يقول الشيخ الطاهر بن عاشور في تفسير قوله تعالى {لا يتخذِ المؤمنون الكافرين أولياءَ من دون المؤمنين…} (آل عمران: 28) “، والآية نهي عن موالاة الكافرين دون المؤمنين باعتبار القيد أو مطلقا، والموالاة تكون بالظاهر والباطن وبالظاهر فقط، وتعتروها أحوال تتبعها أحكام، وقد استخلصت من ذلك ثمانية أحوال.
الحالة الأولى: أن يتخذ المسلم جماعة الكفر، أو طائفته، أولياء له في باطن أمره، ميلا إلى كفرهم، ونواء لأهل الإسلام، وهذه الحالة كفر، وهي حال المنافقين. ثم ذكر رحمه الله سبعة أنواع من الموالاة دون هذه المرتبة، وليست بكفر مخرج من الملة. (35) ومن الخطإ الشائع عند غلاة التكفيريين اليوم التسرع في الحكم بكفر كل من صدرت منه أية مرتبة من مراتب الموالاة لغير المسلمين دون تبين أو تبصر، أو استفصال، بل يكفرون أحيانا بما ليس من باب الموالاة أصلا، فيكفرون كل من جلس مع الكفار، أو ذكرهم بأي خير، أو أثنوا عليه، أو ظهر معهم في صورة، أو دخل في مفاوضات معهم، أو قبل مساعدة منهم. ثم بنى بعضهم على هذا التكفير تكفيرا آخر أشد غلوا، فعدَّوا هذا التكفير إلى من صدر منه مثل تلك الموالاة لمن كفروهم بالموالاة الأولى، وهكذا بالتسلسل تتوسع دائرة التكفير لتشمل معظم أهل القبلة، فالحكام مثلا كفار ومن أسباب كفرهم، ومناطاته موالاتهم ومناصرتهم لأعداء الأمة. والجيش والشرطة كفار لأنهم موالون للحكام. وموظفو الدولة كفار عند بعض الغلاة، لأنهم أعوان للحكام الكفار. بل إن الشعب كله كفار عند بعض آخر لأنه موال للنظام الكفري، أو راض بكفره! (36) يقول الدكتور سيد إمام المعروف بعبد القادر بن عبد العزيز في تكفيره لأعوان الدولة: “اﻟﻔﺮد ﻟﻪ حكم اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ الممتنعين عن القدرة والذين لا يكونون إلا ممتنعين عن الشرع أيضا.. وحكم الطائفة هو حكم رؤوسها وأيمتها، وعلى هذا فإذا كان رأس الطائفة مرتدا كمسيلمة وطليحة سميت طائفته بالمرتدين” (37). واستدل على ما ذهب إليه بقوله تعالى {إن فرعونَ وهامان وجنودَهما كانوا خاطئين} (القصص:8) وما في معناها من الآيات التي تسوي بين فرعون وجنوده في الحكم. (38)
وهذا الحكم من الدكتور سيد إمام غلو ظاهر، وخطأ بين، عارضه فيه حتى بعض رموز الحركة الجهادية من أهل العلم الذين يشاركونه القول بتكفير الحكام الذين يعتبر تكفيرهم موضوع جدل وخلاف داخل الحركة الإسلامية. ومن بين هؤلاء الذين عارضوه الشيخ عطية الله الليبي رحمه الله القيادي السابق في تنظيم القاعدة حيث يقول في الرد عليه: “الاستدلال بهذه الآية الكريمة على أن كل عسكري ينتسب إلى أي حكومة من الحكومات التي نكفرها كحكومة السودان مثلا، أو السعودية كفار لأنهم أتباع لهذه الدولة، والأتباع كالمتبوعين في الحكم، لأن الآية سوت بينهم، مجازفة خطيرة في الحكم.” (39) ويقول أيضا في موضوع تكفير جيش وشرطة الحاكم الذي ثبتت ردته عن الدين: “في مسألة التكفير فإننا نحتاط … وذلك لغلبة ظلمات الجهل على الناس، وفساد العلوم والفهوم، وانطماس أنوار علم هذه المسائل، وكثرة تلبيس الملبسين من علماء الدنيا وعلماء السلطان علماء الضلالة ممن يحسن الناس فيهم الظن، ولاختلاط الأمور وكثرة التأويلات عند الناس” (40).
والحق أن هذه المسائل فيها تفصيل لا يُحسن الكلام فيه إلا أهل العلم والعدل؛ فالموالاة مراتب سبق بيانها، ولا يُكفِّر منها إلا ما كان موالاة للكفار البين كفرهم نصرة لكفرهم، وميلا إلى دينهم. ودون ذلك مراتب بعضها محرم كالتجسس على المسلمين للكفار مقابل مال أو منفعة دنيوية، كما فعل حاطب رضي الله عنه لما أخبر قريشا بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إلى فتح مكة. وبعضها مباح كالتجارة معهم. وبعضها من البر والصلة المشروعان، قال تعالى: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين} (الممتحنة:8)
ومن المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم حالف خزاعة وكانوا عربا مشركين، وسالم اليهود وعاهدهم وكانوا أهل كتاب، وقبل الهدية من المقوقس صاحب مصر وكان قبطيا، ولاطف هرقل في دعوته ووصفه بـ(عظيم الروم)، وزار غلاما يهوديا كان يخدمه لما مرض، وقبل دعوة امرأة يهودية في خيبر، وأنزل نصارى نجران في مسجده.
وما يقال في موالاة ومعاملة الكفار الأصليين يقال مثله في معاملة وموالاة المرتدين بعد ثبوت ردتهم (41)، فإذا كان هنالك حاكم ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام أو أكثر، وثبت عليه ذلك، وتوفرت شروط تكفيره، وانتفت موانعه، وحكم عليه أهل الحكم والفتوى بالكفر، فهذا يكفي للحكم بكفره هو فقط، أما غيره من الأتباع ففيهم تفصيل. فهنالك قسم يتبعه ويطيعه في كفره، ومحاربته للإسلام، ومعاداته لأهله، وموالاته لأعدائه على علم وإدراك، ويعتقد ذلك دينا، فهذا حكمه حكم المرتد. وهنالك من يطيعونه في معصية الله، ولكنهم مقرون بأنها معصية، وأنهم آثمون بذلك، فهؤلاء عصاة، وليسوا كفارا.
يقول ابن تيمية رحمه الله في شأن من أطاع غيره في معصية الله مفصلا الحكم في ذلك: “وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا – حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين: (أحدهما): أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا – وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم – فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله؛ مشركا مثل هؤلاء. “و(الثاني): أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص؛ فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إنما الطاعة في المعروف) وقال: (على المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية)” (42) وهنالك من يعمل معه، ولكنه يريد تخفيف ظلمه، وتحقيق ما يمكنه تحقيقه من العدل والحق، ودفع ما يستطيع دفعه من ظلم وباطل، فهذا مأجور على نيته وعمله. ومن هذا الباب كان طلب يوسف عليه السلام من الملك أن يجعله على خزائن الأرض.
يقول ابن تيمية رحمه الله: “…ثم الولاية وإن كانت جائزة أو مستحبة أو واجبة فقد يكون في حق الرجل المعين غيرها أوجب أو أحب، فيقدم حينئذ خير الخيرين وجوبا تارة واستحبابا أخرى، ومن هذا الباب تولي يوسف الصديق على خزائن الأرض لملك مصر بل ومسألته أن يجعله على خزائن الأرض وكان هو وقومه كفارا كما قال تعالى: {ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به} الآية، وقال تعالى عنه: {يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم} الآية، ومعلوم أنه مع كفرهم لا بد أن يكون لهم عادة وسنة في قبض الأموال وصرفها على حاشية الملك وأهل بيته وجنده ورعيته ولا تكون تلك جارية على سنة الأنبياء وعدلهم ولم يكن يوسف يمكنه أن يفعل كل ما يريد وهو ما يراه من دين الله فإن القوم لم يستجيبوا له لكن فعل الممكن من العدل والإحسان ونال بالسلطان من إكرام المؤمنين من أهل بيته ما لم يكن يمكن أن يناله بدون ذلك وهذا كله داخل في قوله: {فاتقوا الله ما استطعتم} (43) وهنالك قسم آخر وهو أكثر العاملين في الدولة لا صلة لعملهم أصلا بمناط كفر الحاكم المرتد، كالموظفين في مجال التعليم، والصحة، والخدمات العامة، والحالة المدنية، وأمثالهم، فهؤلاء لا إثم عليهم أصلا.
أما عامة الشعب فهم جهال في الأغلب بأحوال الحكام، ثم هم مغلوبون في الغالب على أمرهم. فتبين أن لا وجه لتكفير هؤلاء المسلمين بمثل هذه التخرصات والأوهام المبني بعضها على ضعف بعض. يقول ابن تيمية رحمه الله: “ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك”. (44)
ومن باب التكفير بالمحتمل أيضا تكفير الغلاة كلّ من يؤمن بـ (الديمقراطية) أو يدعو إلى (الدولة المدنية). يقول الدكتور سيد إمام: “الديمقراطية: قانون وضعي مخالف للشرع اخترعه الكفار، ويقضي بمنح البشر الحق المطلق في التشريع، وذلك في مقابل دين الإسلام الذي حق التشريع فيه لله تعالى، فالديمقراطية كفر أكبر حكمها في ذلك حكم مثلها من القوانين الوضعية، بل هي دين مخالف لدين الإسلام لما تمثله من شرك صريح في الربوبية، قال تعالى: {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله}(التوبة 31)، وكانت هذه الربوبية بالتشريع من دون الله، وقال تعالى: {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله} (الشورى 21)، ووسائل تطبيق الديمقراطية لها نفس الحكم، كإنشاء الأحزاب السياسية، وإنشاء المجالس النيابية (البرلمانات) والمشاركة في هذه الأحزاب أو في انتخابات المجالس النيابية بالترشيح أو الانتخاب، كل هذا كفر أكبر ممن فعله، أو دعا إليه وزيَّنه للناس، أو رضي به وإن لم يفعله، لأن هذه هي وسائل تطبيق الديمقراطية التي هي دين الكفار، ولا تغتر بكثرة الهالكين في هذا الذين فارقوا دين الإسلام، ودخلوا في دين الكفار ما داموا قد ارتضوا بالديمقراطية ووسائلها، وإن كان أحدهم يركع في اليوم ألف ركعة، أو يختم في اليوم مائة ختمة هو كافر، قال تعالى {وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون} (يوسف 106)”. (45)
والمتأمل لهذه الكلام الخطير يجد أنه يوسع دائرة التكفير بالديمقراطية لتشمل آلياتها، ووسائل تطبيقها المختلفة، حتى تشمل من لم يقم إلا بوضع بطاقته الانتخابية في الصندوق!! ومع غلو هذا الكلام، فهنالك ما هو أشد منه غلوا، وهو القول بتعدية الكفر (الديمقراطي) ليشمل حتى من لا يؤمن بالديمقراطية إذا جمعه تنسيق أو تعاون مع من يؤمن بها. ومن باب تعدية التكفير بالديمقراطية من القائلين بها إلى غيرهم عند الغلاة، تكفير (تنظيم الدولة الإسلامية) لجبهة النصرة في سوريا، وكل الفصائل التي دخل معها التنظيم في قتال بالردة بسبب تحالفهم مع فصائل تؤمن بالديمقراطية! جاء في نص فتوى التكفير تلك بعد ذكر الحيثيات السابقة: ” إن الدولة الإسلامية أعلنت بما لا يدع مجالا لكل مشكك حكم الشرع في تلك الفصائل، وأنها طوائف مرتدة”. وأضافت الفتوى: “لذا فلن يقبل أن يظهر بين جنودنا من يتوقف في تكفير أعيان هؤلاء”. (46)
وهذا الغلو من تنظيم الدولة في سوريا والعراق لا يماثله أو يزيد عليه إلا غلوهم في ليبيا، فمن آخر ما صدر عنهم في هذا الباب فتوى يكفرون بها (سرايا الدفاع عن بنغازي). ومما جاء في حيثيات الحكم، أنهم كفروا بسبب: “أنهم وقعوا في تحالف مطلق مع من ارتد ردة ظاهرة من البرلمانيين التابعين للمؤتمر الوطني الديمقراطي، والعسكريين والمرتدين، والمتأسلمين”. (47)
والمتأمل في هذه الفتاوى يجدها غلوا مفرطا لا يستند إلى دليل، وذلك للأسباب التالية:
أن تكفير المسلمين بسبب إيمانهم بالديمقراطية هو تكفير بأمر محتمل، فالديمقراطية قد تطلق ويراد بها فصل الدين عن الدولة، وإعطاء حق التشريع للشعب من دون الله، بما في ذلك تحليل الحرام، وتحريم الحلال، وحرية الكفر والإلحاد والإفساد. وهذه المعاني للديمقراطية هي التي تصطدم مع الإسلام. ولكن هذه المعاني لا يقصدها أكثر المطالبين بها من المسلمين الذين لا تعني عندهم أكثر من كونها أداة تتمكن الأمة من خلالها من اختيار حكامها، ومسئوليها، ومحاسبتهم، وعزلهم، ومراقبة عمل حكوماتهم. والعاملون للإسلام المؤمنون بالديمقراطية يرونها وسيلة لتبليغ رسالتهم، وإيصال دعوتهم، وتمثيل أمتهم. وعلى هذا الأساس صدرت فتاوى من علماء كبار وجماعات إسلامية عريقة في العمل الإسلامي بمشروعية المشاركة الديمقراطية، فما وجه تكفير هؤلاء؟! قد يكونون مخطئين، أو جهالا، أو متأولين، أو مقلدين لغيرهم. وهذه موانع من تكفيرهم.
أن تكفير من تحالف معهم مبني على تكفيرهم هم، فإذا تبين أنهم ليسوا كفارا، فلأن لا يكفر من تحالف معهم من باب أولى. وعلى افتراض كفرهم، فالكفر المختلف فيه ليس كالكفر المجمع عليه، وكفر من يعلن إسلامه، ليس ككفر من يعلن خروجه من الإسلام، فهؤلاء يعلنون في كل مناسبة تمسكهم بدينهم، واعتزازهم به، وحرصهم عليه، وأنهم لم يدخلوا العملية السياسية إلا لخدمته، فما وجه تكفير من تعاون معهم؟! وعلى افتراض كفرهم، فليست كل موالاة للكفار تخرج من الملة، كما سبق بيانه.
3. التكفير بالظن
من الشروط التي يلزم توفرها قبل الحكم بالكفر أن يكون الفعل مكفرا بصورة قطعية، وأن يكون المحكوم عليه ارتكب الفعل المكفر فعلا، ويثبت ذلك ثبوتا شرعيا، ولا يكتفى بمجرد الظنون والشائعات، والشكوك والتوهمات. ومع ذلك، فإنك تجد اليوم كثيرا من الغلاة يكفرون أفرادا، وجماعات بأمور لم تثبت عليهم، بل ربما ثبت عنهم عكسها، فتجدهم يكفرون طائفة كاملة، أو جماعة عامة بما ينسب إلى بعض افرادها من مكفرات قد تكون غير صحيحة، وإن صحت فقد تكون غير مكفرة، وحتى في حالة صحتها، وصحة كونها مكفرة عن بعضهم فمن الخطإ الجسيم تعميم الحكم بشأنها على البقية بمجرد الظن والاحتمال لوقوعها فيها.
ومن أشنع ما رأيت في هذا الباب تكفير تنظيم الدولة لجماعة (الإخوان المسلمين). ومما اطلعت عليه في ذلك مقال منشور في مجلة (دابق) على الإنترنت بعنوان (الإخوان المرتدون)! وقد خلص المقال بعد كثير من (الحيثيات!) إلى الحكم بكفر الجماعة وردتها، ناقلا عن الناطق باسم تنظيم الدولة (أبي محمد العدناني) قوله: “إن هذا الكفر الذي وقع فيه حزب الإخوان، وأوقع الناس فيه هو من جراء طاعة الكفرة من الذين أوتوا الكتاب من أمريكا والغرب.. لا فرق (في الكفر) بين مبارك، ومعمر، وابن علي، وبين مرسي، وعبد الجليل، والغنوشي، فكلهم طواغيت، يحكمون بنفس القوانين، غير أن الأخيرين أشد فتنة على المسلمين”. (48)
والحقيقة أن تهافت الحيثيات الواردة في المقال، وشناعة الحكم، وجهل الحاكم، تغنى عن الرد عليه. بالإضافة إلى كون تلك الحيثيات في مجملها هي مما رددنا على جنسه في أكثر من موضع من هذه الورقة.
4. التكفير باللازم
لازم القول، أو لازم المذهب هو ان يعتقد الإنسان مذهبا، أو يقول بقول يلزم منه أمر آخر قد لا يكون خطر ببال صاحب القول أو المذهب لزومه له. والمستقر عند المحققين من أهل العلم أن لازم القول ليس بقول لصاحبه، ولازم المذهب ليس بمذهب، خاصة إذا لم يلتزمه صاحبه. يقول ابن تيمة رحمه الله: “الصواب: أن لازم مذهب الإنسان ليس بمذهب له إذا لم يلتزمه؛ فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه كانت إضافته إليه كذبًا عليه، بل ذلك يدل على فساد قوله وتناقضه في المقال غير التزامه اللوازم التي يظهر أنها من قبل الكفر والمحال مما هو أكثر، فالذين قالوا بأقوال يلزمها أقوال يعلم أنه لا يلتزمها لكن لم يعلم أنها تلزمه، ولو كان لازم المذهب مذهبا للزم تكفير كل من قال عن الاستواء أو غيره من الصفات أنه مجاز ليس بحقيقة؛ فإن لازم هذا القول يقتضي ألا يكون شيء من أسمائه أو صفاته حقيقة”. (49)
ويقول ابن حزم رحمه الله “أما من كفر الناس بما تؤول إليه أقوالهم فخطأ لأنه كذب على الخصم وتقويل له ما لم يقل به، وإن لزمه فلم يحصل على غير التناقض فقط، والتناقض ليس كفرا، بل قد أحسن إذ فر من الكفر… فصح أنه لا يكفر أحد إلا بنفس قوله ونص معتقده ولا ينتفع أحد بأن يعبر عن معتقده بلفظ يحسن به قبحه لكن المحكوم به هو مقتضى قوله فقط”. (50)
ومع ذلك فقد انتشر بين الغلاة التكفير بلازم القول ولازم المذهب عندهم. ومن الأمثلة على ذلك تكفير بعض الجماعات الجهادية لكل من عارضها بحجة أن تلك المعارضة يلزم منها معارضة تحكيم الشريعة الإسلامية الذي تتبناه هي، وتدعو له، وهذا كفر!! ومن الأمثلة على ذلك تكفير (تنظيم الدولة الإسلامية) للجماعات التي تقاتله بتلك الحجة. ومن فتاواهم في هذا الباب: “ونبين للجميع أن موقف الدولة الإسلامية واضح في الحكم على هذه الفصائل، وهي أنها طوائف ارتدت عن دين الله، وارتكبت مناطات متعددة نقضت فيها أصل الدين، ومن ذلك قتال دولة تحكم بشريعة الله في خندق واحد، وحلف واحد مع فصائل امتنعت عن تحكيم الشريعة” وأعلنت سعيها لبناء دولة ديمقراطية مدنية”. (51)
ولا يخفى بطلان هذا الكلام، فقد خرج الخوارج على علي رضي الله عنه وقاتلوه، ولم يكفرهم، وقاتلوا عمر بن عبد العزيز، ولم يكفرهم. وحصل قتال بين الصحابة في موقعة (الجمل) و(صفين) ولم يكفر طرف منهم الطرف الآخر بمثل هذه الحجج المتهالكة.
5. التكفير بعدم التكفير المختلف فيه
مما اتفق عليه أهل العلم أن من لم يكفر الكفار الذين نص القرآن والسنة على كفرهم يكون كافرا، لأنه عندئذ يكون مكذبا لما جاء به القرآن، وأخبرت به السنة، وأجمعت عليه الأمة. ومن هنا قال أهل العلم: (من لم يكفر الكافر كفر). ولكن المراد هو الكافر المتفق على كفره، ولا يدخل في ذلك المختلف في كفره؛ فقد اختلف السلف في بعض الأعمال والتروك هل يكفر صاحبها أم لا؟ ومن قال بكفره لم يقل بكفر من لم يوافقه على تكفيره. ومن أبرز الأمثلة على ذلك الخلاف في تارك الصلاة تكاسلا، فالجمهور لم يكفره الكفر المخرج من الملة، ومن كفره منهم لم يقل أبدا بكفر من لم يكفره.
واليوم ترى بعض غلاة التكفير لا يكتفي بالتعميم في تكفير من يحلو له تكفيره بناء على أصوله الفاسدة، بل يذهب أبعد من ذلك إلى تكفير كل من لم يوافقه على ذلك التكفير! ومن الأمثلة على ذلك أنهم كفروا كل من يؤمن بالديمقراطية، دون ضوابط أو شروط، ثم كفروا من لم يوافقهم في تكفيرهم، لأنه لم يكفر الكافر من وجهة نظرهم! (52)
ولا يخفى فساد مثل هذا المذهب، فهو مذهب فاسد أدى إلى ما هو أفسد منه. وقد سبق معنا بيان بطلانه، عند الكلام على التكفير بالمحتمل.
6. الخلط بين التكفير المطلق وتكفير المعين
سبق معنا أن الإنسان قد يرتكب ما هو كفر، ولكنه لا يجوز الحكم بكفره حتى تتوفر فيه الشروط وتنتفي الموانع، ونقلنا في ذلك نقولا مستفيضة. (53) ومع هذا الوضوح في الفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين، فإن كثيرا من التكفيريين يخلطون بين الأمرين، ويجعلون بينهما تلازما حتميا. وقد يفرقون بينهما من الناحية النظرية، ولكن يخلطون من الناحية العملية من خلال إفراغ موانع الجهل، والتأويل، والإكراه من معناها، فتكون النتيجة واحدة، وهي تكفير كل من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام دون نظر في توفر الشروط وانتفاء الموانع. ومن ذلك تكفيرهم للعوام، والجهال، والمقلدين، والأتباع، والأعوان بصورة شاملة وكاملة بحجة ارتكابهم لبعض المكفرات دون نظر حقيقي في توفر الشروط وانتفاء الموانع.
وهذا خطأ جسيم، وأمر عظيم، فمثل هؤلاء لا يكفرون ولو ارتكبوا ما هو ناقض من نواقض الإسلام حتى تتوفر فيهم الشروط وتنتفي الموانع التي بيناها من قبل.
المطلب السادس: مقترحات للعلاج
أمام تعقيدات الظاهرة، وتداخل الأسباب، وتعدد المظاهر، لا يكون من السهل تحديد مقترحات محددة تكفي وحدها للعلاج، فالظاهرة مركبة، وعلاجها يجب أن يكون مركبا كذلك. ومع ذلك فسوف نحاول تقديم بعض المقترحات التي نراها ذات أولوية في هذا الباب، موجزين هنا، ومحيلين على الورقة المشار إليها من قبل تحت عنوان (فصل المقال فيما بين الأربعة من اتصال…) فقد ذكرنا هناك ما لم نذكره هنا في الموضوع. وأهم هذه المقترحات:
1. الإقرار بما مع الغلاة من حق ورد ما معهم من باطل
من الأخطاء التي يقع فيها كثيرون في محاولاتهم التصدي لظاهرة الغلو بصورة عامة محاولتهم هدم ورد كل ما يعتقده الغلاة من أفكار، ويدعون إليه من عمل دون تفريق بين ما عندهم من حق وما معهم من باطل. الغلاة عندما يقولون إن هنالك نواقض للإيمان يكفر من ارتكبها، ومن توفرت فيه الشروط وانتفت في حقه الموانع يحكم بردته، فكلامهم صحيح. وعندما يقولون إن معظم الحكام اليوم يحكمون بغير ما أنزل الله، فهم محقون في ذلك. وعندما يقولون إن معظم هؤلاء الحكام خدام للمصالح الغربية، ويتآمرون مع الأعداء على الأمة الإسلامية، فهم مصيبون في قولهم. وعندما يقولون إن كثيرا من العلماء الرسميين هم علماء سلطان لا علماء قرآن، فكلامهم صحيح. وعندما يقولون إن الحكم بغير ما أنزل الله كفر (أكبر أو أصغر)، أو يقولون إن موالاة الكفار ونصرتهم ومساعدتهم في حربهم على الإسلام والمسلمين ناقض من نواقض الإسلام، فهذا الكلام فيه ما هو صحيح في الجملة، ولكن يحتاج إلى ضبط، وتفصيل، وتنزيل، ينطلق مما قررناه قبل في هذه الورقة. وعندما يقولون إن الجهاد ضد الاحتلال، ومقاومة الظلم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرائض شرعية، فهم محقون، وليس هذا من الغلو. ولكن يقال لهم إنها فرائض تحتاج إلى فقه خاص، ولا بد لها من شروط، وضوابط ومقومات. إن من الخطإ الفادح أن تدفعنا ردة الفعل على الغلاة، إلى الغلو في الطرف الآخر، فالبدعة لا ترد ببدعة، ولكن ترد بالسنة. ثم إن الغلو مراتب، فلا بد من فقه في حال الغلاة وغلوهم، ومعرفة الفروق بينهم، حتى لا نقع فيما وقع فيه الغلاة من عدم التفريق بين أنواع الكفر، والفسق، والظلم، والمعاصي، ومراتبها.
2. القضاء على أسباب الغلو
أهم الخطوات في سبيل علاج ظاهرة الغلو في التكفير القضاء على الأسباب التي كانت وراءه، والعوامل التي تغذيه. وقد ذكرنا أهمها في مطلب سابق، وفي الورقة المشار إليها في هامشه، فعندما يقوم الحكام بواجبهم في تطبيق الشريعة الإسلامية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع الظلم، وفتح الحريات المنضبطة بالشرع. وعندما يقوم العلماء بواجبهم في نشر العلم، وتربية الشباب، ونصحهم، وترشيدهم، والاقتراب منهم، وتفهم ظروفهم، ودوافعهم، ويصدعون بالحق، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وعندما تصلح المناهج التعليمة والتربوية، وتكون مناهج تخرج أجيالا من المسلمين عارفة بدينها، متمسكة بقيمها، محصنة من كل فكر منحرف، وسلوك شاذ. وعندما ترجع الأمة إلى الله تعالى تأتمر بأمره وتنتهي بنهيه، وتأخذ على يد الظالم، فتمنع الظلم، وتكف العدوان. وعندما يكف المعتدون شرهم، وينتهون عن ظلمهم وعدوانهم، ويتوقفون عن غزو بلاد المسلمين، واحتلال مقدساتهم، ونهب خيراتهم، وسلب ثرواتهم، ومساندة طغاتهم. عند ذلك سوف نقضي على أهم أسباب الغلو في التكفير.
3. الحوار
أكثر الغلاة لديهم شبهات وتأويلات، وهذه الشبهات والتأويلات تحتاج إلى ردود وبيان لوجه الحق بشأنها. وهذا لا يتأتى بدون حوار مع هؤلاء الغلاة. وهذا الحوار يجب أن تتوفر فيه أمور أهمها:
– الإخلاص: إن أهم شرط في نجاح حوار من هذا القبيل هو الإخلاص فيه لله تعالى، وقصد الوصول إلى الحق، وإيصاله للطرف الآخر، وقبوله منه. وإذا فقد هذا الشرط تحول الحوار إلى مناظرة للمغالبة الهدف منها الدعاية وليس الهداية.
– الحكمة والرفق: من الأمور المهمة في أي حوار من هذا القبيل توخي الحكمة والرفق واللين، والحرص على كسب القلوب لا كسب المواقف، فقد قال صلى الله عليه وسلم: (لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم). (54)
وبدون هذه الأمور تتحول المناظرة إلى مكابرة ومفاجرة!! وهذا الحوار لا يمكن أن يقوم به على الوجه الأكمل إلا العلماء العاملون الذين يجمعون بين فقه الدين، وفقه الواقع، وبين العلم والعمل، ويحظون بثقة الأمة، ولا يعرفون بموالاتهم للحكام، ومناصرتهم للسلاطين في باطلهم. لما خرج الخوارج سنة (100هـ) على عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، رحمه الله، بعث إليهم عمرُ مَنْ يدعوهم إلى الحق، ويتلطف بهم، ولا يقاتلهم حتى يفسدوا في الأرض؛ فلما فعلوا ذلك، بعث إليهم جيشاً فهزمهم الخوارجُ، فأرسل إليهم ابنَ عمه مسلمةَ بن عبد الملك، فانتصر عليهم. وأرسل عمر إلى كبير الخوارج يقول له: ما أخرجك عليّ؟ فإن كنتَ خرجتَ غضباً لله فأنا أحق بذلك منك، ولستَ أوْلى بذلك مني، وهلمَّ أناظرك، فإن رأيتَ حقاً اتبعتَه، وإن أبديتَ حقاً نظرنا فيه..” (55) هذه الحادثة مع ما سبقها من مناظرة علي بن أبي طالب، وابن عباس رضي الله عنهما للخوارج، وما نتج عن ذلك من رجوع كثير منهم للحق تدل على أهمية الحوار، فالفكر لا يرد إلا بالفكر.
4. فتح أبواب الحريات المنضبطة
من الأمور التي تساعد على التخفيف من حالة الاحتقان، والتوتر النفسي عند الشباب المسلم فتح الحريات، وإتاحة فرص العمل للإسلام، وخدمة الدين والمجتمع من خلال الجمعيات، والنوادي، والروابط، والمراكز، ومؤسسات المجتمع المدني، ورفع القيود عن حرية الدعوة، والعمل للإسلام.
الخاتمة
لعلنا من خلال ما سبق نكون قد ساهمنا في إعطاء صورة ولو تقريبية عن حقيقة التكفير، والغلو فيه، وأزلنا اللبس الحاصل بين بعض أنوعه، وبينا الخلط الواقع في ذلك عند بعض الغلاة، مع بيان التحذير من التسرع في التكفير، وما يجب من الانضباط بضوابط الشرع في الباب. كما تطرقنا إلى إبراز أهم أسباب ومظاهر هذه الظاهرة قبل أن ننهي الورقة بمقترحات تساهم في علاج هذا الداء الذي بدأ يستفحل وينتشر بشكل خطير وكبير. وأهم الأفكار والرسائل التي يمكن الخروج بها من هذه الورقة هي:
1. أن الغلو في التكفير هو التوسع فيه وعدم مراعاة الضوابط الشرعية في الباب بتكفير من ثبت وتقرر إسلامه بيقين، دون النظر إلى توفر الشروط وانتفاء الموانع المعتبرة في حقه شرعا. ولا يدخل في الغلو الحكم بكفر الكافر الأصلي، ولا الحكم بردة من توفرت فيه شروط الردة، وانتفت في حقه موانعها، وحكم عليه مؤهل للحكم بذلك، فهذا تكفير منضبط.
2. أن تكفير المسلم أمر خطير وكبير، حذر من الشرع أشد التحذير، وأنكره الأئمة أشد النكير. وله تداعيات خطيرة، وآثار وكبيرة، ليست استباحة الدماء المعصومة، والأعراض المصونة، والأموال المحرمة، وانتشار الفوضى، وانعدام الأمن إلا بعضا منها.
3. أن هنالك فروقا جوهرية بين بعض أنواع الكفر، بينها أهل العلم وفصلوا فيها. والخلط بين هذه الأنواع والجهل بالفروق بينها كان من أسباب انتشار ظاهرة الغلو في التكفير قديما وحديثا.
4. أن من ثبت إيمانه بيقين، لا يزول عنه بالشك، وأن المسلم وإن ارتكب ناقضا أو أكثر من نواقض الإسلام، فلا يجوز تكفيره قبل التحقق من توفر شروط التكفير، وانتفاء موانعه في حقه من قبل مؤهل للحكم عليه من أهل القضاء والفتوى.
5. أن الجهل، والتأويل، والإكراه، والخطأ… موانع من تكفير المسلم، ولو ارتكب مكفرات تخرج من الملة. والأدلة متضافرة على ذلك من الكتاب والسنة، وكلام الأئمة، وعلماء الأمة.
6. أن أهم أسباب الغلو في التكفير هي:
– الجهل المنتشر بين شباب الأمة، وضعف مستوى العلم الشرعي، والوعي الفكري لديهم، فالخطأ في الفهم والعلم، قادهم للخطإ في الممارسة والسلوك.
– الخلل التربوي عند الغلاة، وانعدام التوازن في التربية بعض الجماعات.
وقد أدى ذلك الخلل إلى تشوه في الفكر، وإعاقة في الفهم، مما أدى إلى تضخم بعض الجوانب على حساب بعض آخر.
– عدم نهوض العلماء الربانيين بواجبهم الشرعي تعليما، وتربية، وتوجيها، وإصلاحا، وقيادة، وريادة، الأمر الذي ترك فراغا ملأه الجهال بجهلهم، وعلماء السلاطين بدجلهم.
– الخلل في المناهج التربوية والتعليمية في المدارس والجامعات، وخاصة المناهج العلمانية المصادمة لعقيدة وشريعة وقيم الأمة الإسلامية.
– انحراف الأمة بصورة عامة عن الدين، وبعدها عن هدي كتابها، وسنة نبيها في شتى مجالات الحياة.
– حرب الحكام على الإسلام، وتعطيلهم لشريعته، ومعاداتهم لدعاته، وموالاتهم لأعدائه.
– غلو الجفاة المضاد المتمثل في المجاهرة بالردة، والاستهزاء بالدين، والتشكيك في ثوابت العقيدة، ومحكمات الدين.
– استهداف الأمة من قبل الأعداء الخارجيين، وخاصة الغربيين الذين عزوا بلادها، واحتلوا مقدساتها، وسلبوا خيراتها، ونهبوا ثرواتها، وتحالفوا مع طغاتها.
فهذه العوامل مجتمعة كان وراء ظهور ظاهرة الغلو أولا، وانتشارها ثانيا، فظاهرة الغلو جاءت بالأساس ردة فعل على هذا الواقع، ونتيجة لتضافر هذه العوامل.
7. أن من أهم مظاهر الغلو في التكفير اليوم: التكفير بغير مكفر – التكفير بالمحتمل – التكفير بالظن – التكفير باللازم – التكفير بعدم تكفير المختلف في كفره – الخلط بين أنواع من الكفر – التكفير باللازم. وقد عالجت الورقة تلك المظاهر، وبينت أوجه الخطإ فيها، وردت عليها.
8. وأخيرا اعتبرت الورقة أنه أمام تعقيدات الظاهرة، وتداخل الأسباب، وتعدد المظاهر، ليس من السهل تقديم حلول جاهزة وبسيطة لهذه الظاهرة المقعدة والمركبة، إلا أن الورقة قدمت بعض المقترحات لعلاج هذه الظاهرة.
وأهم هذه المقترحات:
– الإنصاف والعدل في التعاطي مع ظاهرة الغلو، والإقرار بما مع الغلاة من حق ورد ما معهم من باطل، وعدم رد كل ما يعتقده الغلاة من أفكار، أو يدعون إليه من عمل دون تفريق بين حقه وباطله.
– القضاء على أسباب الغلو السابق ذكرها، فلا قيمة لأية جهود تبذل في علاج الظاهرة ما دامت الأسباب التي أنتجتها، وعملت على انتشارها وتغذيتها موجودة. فما دامت بلاد المسلمين تتعرض للاحتلال من قبل الأعداء المحتلين، وشعوبهم تحكم بالحديد والنار من قبل الحكام الفاسدين. وما دام الجهل منتشرا بين الشباب والناشئين، ومناهج التعليم والتربية بيد العلمانيين، ووسائل الإعلام في قبضة الملحدين والليبراليين.
وما دام العماء الربانيون، والدعاة والمصلحون غير فاعلين، غائبين أو مغيبين. وما دامت الأمة لم ترجع لكتاب ربها، وسنة نبيها، في اعتدالها ووسطيتها، خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وما دام الأمر على هذه الحال فلا أمل في خروج الأمة من مربع المأساة الذي أضلاعه: الغزاة، والطغاة، والجفاة، والغلاة.
– الحوار الجاد والهادف مع الغلاة، لأن أكثرهم، كما رأت الورقة، لديه شبهات وتأويلات تحتاج إلى ردود وبيان لوجه الحق بشأنها. وهذا لا يتأتى بدون حوار تتوفر لدى أطرافه صفات الإخلاص، والحكمة، والرفق. وحوار الغلاة لا يمكن أن يقوم به إلا من تتوفر فيهم صفات الكفاءة العلمية، والمعرفة بالواقع، وقضاياه، وأن لا يكونوا من علماء السلاطين والحكام الذين لا مصداقية لهم عند الطرف الآخر.
– فتح أبواب الحريات المنضبطة، ورفع القيود عن العمل الإسلامي السلمي الدعوي، والتعليمي، والاجتماعي والسياسي، والاعتراف بمؤسساته المختلفة.
فهذه أمور تساعد على التخفيف من حالة الاحتقان، والتوتر النفسي عند الشباب، وتؤسس للحد الأدنى من الثقة المطلوبة لحوار ناجح وهادف يحرص أطرافه على إنجاحه بعد أن فشلت كل المقاربات الأمنية والعسكرية.
وبهذا نرجو أن نكون قد وصلنا إلى ما نريد من هذه الورقة، سائلين المولى تعالى أن يتقبل العمل، ويغفر الزلل، ويتجاوز عما كان من خطإ أو خلل. هذا جهد المقل، وعمل المقصر… والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
قائمة المصادر والمراجع
– القرآن الكريم
– ابن القيم: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين، (المتوفى: 751هـ).
(مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة) الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، (بدون تاريخ أو رقم للطبعة)
(الصلاة وأحكام تاركها)، الناشر: مكتبة الثقافة بالمدينة المنورة، (بدون تاريخ أو رقم للطبعة)
– ابن بدران: عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم، (المتوفى: 1346هـ).
(المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) مؤسسة الرسالة – بيروت، ط الثانية 1401، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي.
– ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد، تقي الدين أبو العباس الحراني الحنبلي الدمشقي، (المتوفى: 728هـ).
(مجموع الفتاوى)، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 1416هـ/1995م.
– ابن حجر: أحمد بن علي، أبو الفضل العسقلاني الشافعي.
(فتح الباري شرح صحيح البخاري) دار المعرفة – بيروت، 1379، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
– ابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد، الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: 456هـ).
(الإحكام في أصول الأحكام) دار الآفاق الجديدة، بيروت، تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر، قدم له: الأستاذ الدكتور إحسان عباس.
(الفِصَل في الملل والأهواء والنحل) مكتبة الخانجي – القاهرة. (بدون تاريخ أو رقم للطبعة).
– ابن حنبل: أبو عبد الله أحمد بن محمد الشيباني، (المتوفى: 241هـ).
(مسند الإمام أحمد بن حنبل) المحقق: شعيب الأرنؤوط – عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة، الأولى، 1421 هـ – 2001 م، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي.
– ابن عاشور: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر، التونسي (المتوفى: 1393هـ).
التحرير والتنوير (تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد)، الدار التونسية للنشر – تونس، 1984هـ.
– ابن عبد البر: يوسف بن عبد الله بن محمد، أبو عمر النمري القرطبي، (المتوفى: 463هـ).
(التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد) وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية – المغرب، عام النشر: 1387 هـ، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري.
– ابن كثير: إسماعيل بن عمر، أبو الفداء القرشي البصري ثم الدمشقي، (المتوفى: 774هـ).
(تفسير القرآن العظيم) دار طيبة للنشر والتوزيع، ط الثانية 1420هـ – 1999 م، تحقيق: سامي بن محمد سلامة.
(البداية والنهاية) دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط الأولى، 1418 هـ – 1997 م، سنة النشر: 1424هـ / 2003م، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي.
– ابن ماجه: محمد بن يزيد، أبو عبد الله القزويني، (المتوفى: 273هـ).
(سنن ابن ماجه) دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى البابي الحلبي، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.
– ابن مفلح: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد، أبو إسحاق، برهان الدين (المتوفى: 884هـ).
(المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد) مكتبة الرشد – الرياض – السعودية، الطبعة: الأولى، 1410هـ – 1990م، تحقيق: د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين.
– أبو داود: سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو، الأزدي السِّجِسْتاني، (المتوفى: 275هـ).
(سنن أبي داود) دار الرسالة العالمية، الأولى 1430 هـ – 2009 م، شعَيب الأرنؤوط – محَمَّد كامِل قره بللي.
– البخاري: محمد بن إسماعيل، أبو عبد الله الجعفي (المتوفي سنة 256هـ)
صحيح البخاري وهو (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه) دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الأولى 1422هـ، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر.
– أبو يوسف مؤسس جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد المعروفة ب (بوكو حرام)
هذه عقيدتنا ومنهج دعوتنا https://justpaste.it/kw1z
– الجصّاص: أحمد بن علي، أبو بكر الرازي الحنفي (المتوفى: 370هـ).
(أحكام القرآن) طبعة دار إحياء التراث العربي – بيروت، 1405 هـ، تحقيق: محمد صادق القمحاوي – عضو لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر الشريف.
– الذهبي: محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز، شمس الدين أبو عبد الله الذهبي (المتوفى: 748هـ).
(سير أعلام النبلاء) مؤسسة الرسالة، الثالثة، 1405 هـ / 1985 م، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط.
– الشافعي: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف، أبو عبد الله المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 204هـ).
(الأم) دار المعرفة – بيروت، 1410هـ/1990م.
– الشوكاني: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله، اليمني (المتوفى: 1250هـ).
(السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار) دار ابن حزم، الأولى. (بدون تاريخ أو رقم للطبعة).
– الليبي: عطية الله.
الأجوبة الشاملة للقاء الحسبة: https://archive.org/details/leqaa_al7esba.
حكم أعوان الطواغيت: http://www.twitlonger.com/show/n_1rjnk6e.
– النيسابوري: مسلم بن الحجاج، أبو الحسن القشيري النيسابوري، (المتوفى: 261هـ).
(المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) وهو (صحيح مسلم)، دار إحياء التراث العربي – بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. (بدون تاريخ أو رقم للطبعة).
– الندوة العالمية للشباب الإسلامي.
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة.
– الشريف: سيد إمام الشريف المعروف بعبد القادربن عبد العزيز، وبالدكتور فضل.
(الجامع في طلب العلم الشريف) http://www.almeshkat.net/book/1222.
– تنظيم الدولة الإسلامية
سرايا الدفاع عن بنغازي.. واقع وتأصيل http://www.almlf.com/kg1uefq82m24.html.
تعميم رقم ن7-21 صادر عن تنظيم الدولة الإسلامية بتاريخ 20 /12/ 2015.
بيان رقم 125 صادر بتاريخ 1/6/2016 صادر عن تنظيم الدولة الإسلامية (المكتب المركزي لمتابعة الدواوين الشرعية).
مقال (الإخوان المرتدون) في مجلة (دابق) الألكترونية التابعة لتنظيم الدولة https://justpaste.it/tcgw.
الإحالات
(1) جمهرة اللغة لابن دريد (غلو).
(2) أحكام القرآن للجصاص (3/282).
(3) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (1/49).
(4) مجموع الفتاوى لابن تيمة (12/ 335).
(5) انظر فيض الباري على صحيح البخاري للكشميري (1/120).
(6) مفتاح دار السعادة لابن القيم (1/94).
(7) البخاري (رقم 121) ومسلم (رقم 118 – (65)
(8) مسند أحمد (رقم 9536)، وأبو داود (رقم 3904).
(9) البخاري (رقم 6103) ومسلم (رقم 60)
(10) البخاري (رقم 48) ومسلم (رقم 64)
(11) الصلاة وأحكام تاركها (ص 58)
(12) لنقول السابقة كلها من كتاب (الصلاة وأحكام تاركها) لابن القيم ص58 وما بعدها)
(13) مجموع الفتاوى لابن تيمية (23/346).
(14) البخاري (رقم 6104) ومسلم (رقم 60).
(15) تفسير ابن كثير (2/ 382)
(16) البخاري (6045) ومسلم (112 – 61)
(17) فتح الباري لابن حجر (10/466).
(18) شرح المقاصد في علم الكلام للتفتازاني (2/269).
(19) سبق تخريجه.
(20) سبق تخريجه.
(21) سبق تخريجه.
(22) البخاري (6768) ومسلم (62).
(23) التمهيد لابن عبد البر (17/15).
(24) الأم للشافعي (6/222)
(25) المقصد الارشد لابن مفلح (3/26) وما بعدها.
(26) سير أعلام النبلاء (15/88).
(27) أخرجه ابن ماجه في سننه من حديث ثوبان (277) وصححه الألباني، وأخرجه الإمام أحمد في المسند (22486) وصححه شعيب الأرنؤوط.
(28) سير أعلام النبلاء، المرجع السابق.
(29) سبق تخريج هذه الأحاديث.
(30) السيل الجرار للشوكاني (4/577) وما بعدها.
(31) بعض هذه الأسباب تعرضنا له بشيء من التفصيل في ورقة مستقلة تحت عنوان (فصل المقال فيما بين الأربعة من اتصال.. الغزاة، والطغاة، والجفاة، والغلاة) ولذلك لم نتوسع فيها هنا وأحلنا عليها هناك.
(32) البخاري (3610) ومسلم (148 – 1064)
(33) وقد حاورت بعد ذلك أحد هؤلاء في السودان وكان قدم إليها في زيارة، فلما ذكر أنهم يعتقدون كفر كل من يحمل وثيقة شخصية، أو يتعامل بالعملات الرسمية، قلت له: كيف سافرت من البلاد التي كنت فيها، ووصلت إلينا في السودان؟ ألم تستعمل عملات لشراء التذكرة، وتستخدم جواز سفر للسفر؟ قال بلى: ولكني مضطر لذلك!! فقلت له: وما هي الضرورة التي تقتضي منك أن ترتكب مكفرَين يُخرج كلُّ واحد منهما مرتكبَه من الملة حسب اعتقادك؟! وعلى افتراض أن الضرورة تبيح ذلك، فهذه ضرورة عامة في حق كل الناس، فمن من الناس يستغني اليوم عن أوراقه الشخصية التي يحتاجها لإثبات نسبه، ولدراسته، وعلاجه، وعمله، وسفره، وإقامته، وحياته، وحتى موته، أو يستغني عن التعامل بالعملات الرسمية؟ الحقيقة أنه ليس في التعامل بالأوراق الرسمية أي محذور شرعي، فضلا عن أن يكون كفرا، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده يتعاملون بالدنانير والدراهم الرومانية والفارسية، ويتبادلون مع ملوكهم وأمرائهم الرسائل الرسمية المختومة بأختامهم.
(34) كتاب (هذه عقيدتنا ومنهج دعوتنا) للشيخ أبي يوسف مؤسس جماعة بوكو حرام (ص58) وما بعدها. (نسخة الكترونية)
(35) التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور (3/217)
(36) من أشهر الجماعات المعاصرة التي تكفر عموم الأمة تقريبا (جماعة المسلمين) المعروفة بجماعة التكفير والهجرة، فهم يكفرون مرتكب الكبيرة المصر عليها، والحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله، والمحكومين لأنهم رضوا بحكمهم وتابعوهم، والعلماء لأنهم لم يكفروا الحكام ولا المحكومين. ويكفرون كل من بلغته دعوتهم فلم يبايعهم، وكل من بايعهم ثم خرج عنهم. كما يكفرون أتباع المذاهب وجميع المقلدين. (راجع الموسوعة الميسرة في المذاهب والأديان المعاصرة (1/333)
(37) الجامع في طلب العلم الشريف لسيد إمام الشريف ص687 (نسخة إلكترونية)
(38) المرجع السابق
(39) حوار شبكة الحسبة الإلكترونية مع الشيخ عطية الله الليبي (306)
(40) رسالة للشيخ عطية الله الليبي في حكم أعوان الطواغيت منشورة على الشبكة العنكبوتية (ص1).
(41) تنظر في موضوع تكفير الأعوان فتوى ابن تيمية في التتار وجنودهم (مجموع الفتاوى 3/542)، حيث فصل فيهم.
(42) مجموع الفتاوى (7/70)
(43) مجموع الفتاوى (20/57).
(44) مجموع الفتاوى (12/501).
(45) الجامع في طلب العلم (ص 492).
(46) يراجع للتفصيل بيان رقم 125 صادر بتاريخ 1/6/2016 عن تنظيم الدولة الإسلامية. (المكتب المركزي لمتابعة الدواوين الشرعية.)
(47) منشور على الإنترنت بعنوان: (سرايا الدفاع عن بنغازي.. واقع وتأصيل) صادر عن تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا.
(48) من مقال (الإخوان المرتدون) منشور في مجلة دابق الإلكترونية التابعة لتنظيم الدولة.
(49) مجموع الفتاوى (20/217).
(50) الفِصَل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (3/139).
(51) تعميم رقم ن7-21 صادر عن الدولة الإسلامية بتاريخ 20 /12/ 2015.
(52) قد سبق معنا الكلام على موضوع الديمقراطية هذا عند كلامنا على التكفير بالمحتمل.
(53) انظر من المطلب الثاني: (الفرق بين كفر النوع وكفر العين).
(54) البخاري (2942).
(55) انظر: البداية والنهاية لابن كثير (12/665).