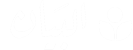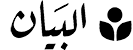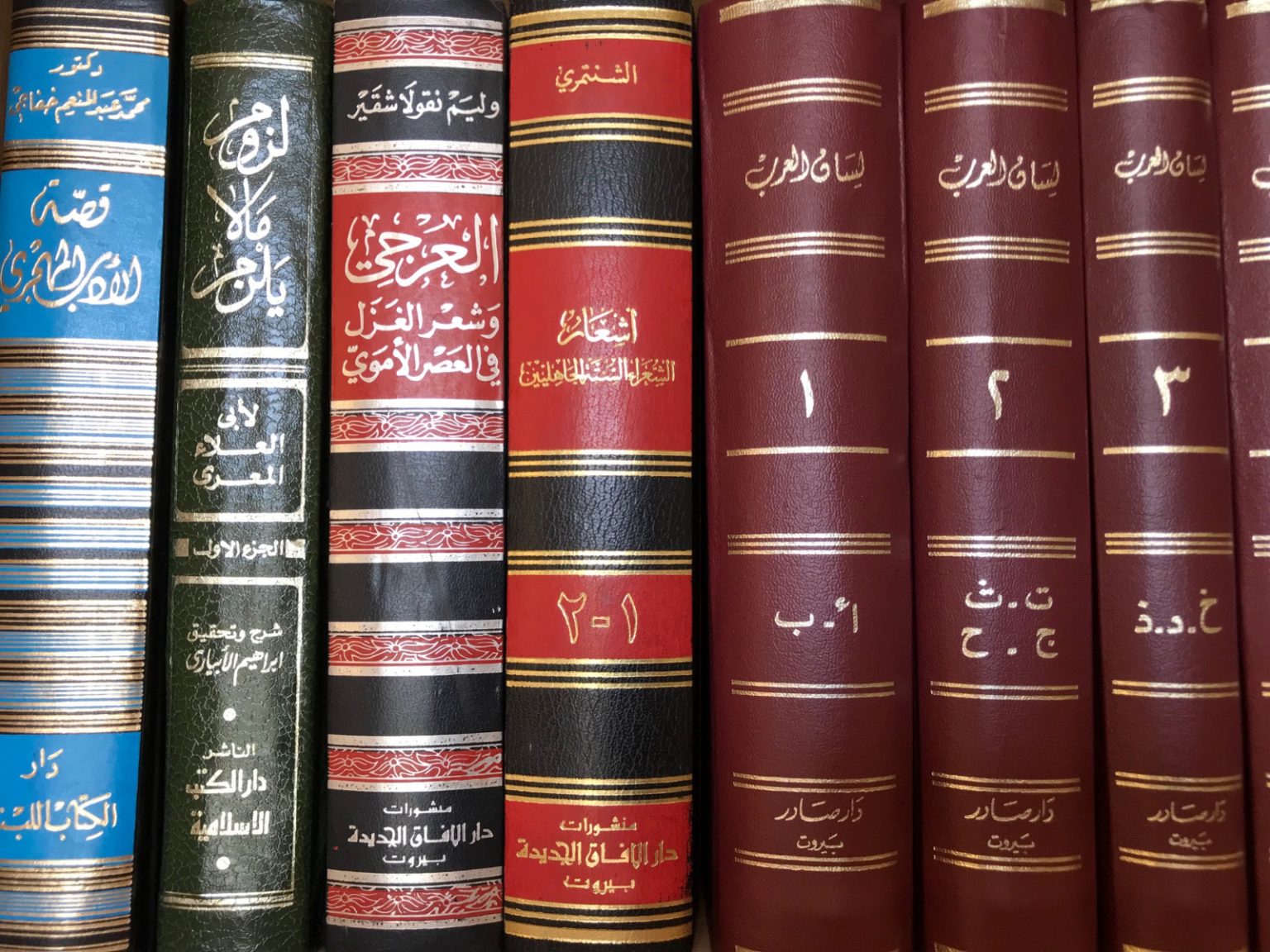لا تزال ظاهرة العنف المتسربل بعباءة الإسلام تمثل واحدة من أكبر التحديات أمام قدرة العالم العربي والإسلامي على تأسيس مشروع نهضوي يجمع بين الإسلام كمرجعية عقائدية وفكرية وحضارية وبين تعقيدات وتركيبات الدولة القومية الحديثة بمؤسساتها المختلفة. وقد ظن البعض أن ثورات الربيع قد تحد من الظاهرة ومن قدرة جماعات العنف على جذب الشباب المسلم مما يمكن أن يؤدى إلى انحسار الظاهرة، غير أن ما اعترى ثورات الربيع العربي من انكسارات من جهة وتجذر الظاهرة في العقل الإسلامي من جهة أخرى أدى إلى عكس ما ظن هذا البعض فإذا بجماعات العنف تزداد على المستوى الأفقي من حيث القدرة على جذب المزيد من الشباب الذى تجاوز العالم العربي والإسلامي إلى مسلمي أوروبا وأمريكا؛ وعلى المستوى الرأسي من حيث مزيد من التطرف على المستوى الفكري والولوغ في ممارسة العنف على المستوى العملي والذى جسده بوضوح تنظيم “داعش” بقيادة أبى بكر البغدادي المتخصص في “التفسير”، الأمر الذى يجب معه الوقوف مع الظاهرة ليس كظاهرة طارئة علي المجتمعات الإسلامية ولا كمجرد رد فعل لاستبداد أنظمة حاكمة سدَت شرايين العمل السياسي بل والفكري وإن كان ذلك صحيحاً؛ ولكن كظاهرة لها جذورها الفكرية والتربوية وإن كانت كأي ظاهرة إنسانية أو اجتماعية تتصف بالتعقيد والتركيب الذى لا يمكن معه ردها إلى سبب واحد أو سببين.
ولأن للظاهرة جذورها الفكرية بل ولأن هذه الجذور الفكرية أحد أهم أسباب الظاهرة لزم التعرض لها ومناقشتها ليس فحسب رغبة في فهم الظاهرة وتحليلها وإن كان ذلك بالطبع سبباً وجيهاً ولكن ولأن مجرد الدراسة والتحليل أصبح في واقعنا الأليم يعده البعض –للأسف – ضربا من الترف الفكري، وإنما لأن الظاهرة تنال بوضوح من الطاقات الفاعلة في العالم الإسلامي لا سيما طاقات الشباب ليس فقط بإهدارها وإنما بتوجيهها نحو السبيل الذى يدمر ولا يبنى ويعطل ولا يسيّر ويزيد الأمة تخلفاً على تخلفها وبدلاً من أن يكون الإسلام كما كان منذ بزوغ وحيه قوة روحية وعقلية هادرة تحيل العرب إلى هذه الأمة الواعية المنطلقة كالسهم في مسيرة التاريخ ، وفي كتاب الحضارة تسطر أعظم الصفحات وتشيد واحدة من أرقي الحضارات بدلاً من ذلك يتحول الإسلام – للأسف- في عقول وقلوب بعض المنتسبين إليه إلى آلة هدم وإلى عدو للإنسانية وللحضارة البشرية.
لهذا لزم الوقوف والدراسة والتحليل وسنكتفى هنا لاعتبارات المساحة على التركيز على الجذور الفكرية لظاهرة العنف لدى جماعات الإسلام السياسي آملين أن نوفق في إلقاء الضوء عليها وسبر أغوارها من جهة وراجين أن تتاح الفرصة لدراستها من كافة جوانبها من جهة أخرى. والله سبحانه ولى التوفيق والسداد. ولتحليل ظاهرة العنف عند الجماعات الاسلامية يلزمنا أن نتعرض:
أولاً: لتوصيف الظاهرة بشكل صحيح.
ثانياً: للجذور الفكرية للظاهرة والتي ترى هذه الجماعات أنها تمثل مرجعيتها في التغيير بالقوة.
ثالثاً: لواقع التربية داخل الجماعات الاسلامية وتأثير ذلك على لجوء هذه الجماعات للعنف.
أولاً: توصيف الظاهرة
استُخدِمت مصطلحات كثيرة للتعبير عن الظاهرة – وإحدى أهم مشكلات الحوار في مجتمعاتنا فوضى المصطلحات- فاستخدم اصطلاح: الإرهاب والتطرف والعنف والخروج على الشرعية، وبالنسبة للجماعات الاسلامية استخدم: الجهاد والخروج على الحاكم الظالم وتغيير المنكر إلى غير ذلك من مصطلحات لم تتضح مدلولات أكثرها كما ينبغي، وكي ننطلق من تصور صحيح فإننا نحاول وصف الظاهرة بشكل تحليلي، فنحن أمام:
1- أناس ينطلقون من فهم معين للإسلام وقد جمعهم هذا الفهم في جماعات بعينها.
2-هذه الجماعات ترى أن الواقع الذي تعيشه المجتمعات في البلاد الاسلامية واقع بعيد عن الاسلام كما تتصوره.
3- هذه الجماعات ترى أن تغيير هذا الواقع الفاسد من أهم وظائف المسلم- إن لم يكن أهمها- في هذه الحياة وأن السكوت على هذا الفساد دون محاولة لتغييره يعتبر خيانة لله ورسوله ومشاركة لأهل المنكر بعدم الإنكار عليهم.
4- هذه الجماعات ترى أن تغيير هذا الواقع لن يكون بمجرد الدعوة باللسان أو الكتابة وإنما لا بد من اعتماد القوة والسلاح كأداة من أهم أدوات التغيير لأنه ما دام أهل الفساد لديهم أدواتهم فيتحتم أن يواجهوا بمثل هذه الأدوات، “والسيف أصدق أنباءً من الكتب”.
5- هذه الجماعات ترى أن تغيير الأنظمة خطوة رئيسية في سبيل الوصول للمجتمع والدولة الإسلامية ثم الخلافة الإسلامية وأنه بغير هذه الخطوة لن يتحقق للإسلام تمكين، وتغيير الأنظمة لن يتحقق بغير إقصائها بالقوة والإحلال محلها.
وفي ضوء هذه النقاط يمكننا أن نقف على العناصر المكونة للظاهرة المسماة بالعنف عند الجماعات الاسلامية. هذا العنف الذي هو ليس مجرد رد فعل كما يحلو للبعض أن يصفه ولكنه مؤسس على ركائز فكرية يتحتم مناقشتها وتحليلها للوقوف على جذور هذه الظاهرة ومن ثم معالجة الأسباب بدلاً من التوجه مباشرة للنتائج.
ثانياً: الجذور الفكرية للعنف عند بعض فصائل الحركة الإسلامية
نستطيع أن نحصر الجذور الفكرية لظاهرة العنف عند بعض الجماعات الإسلامية في أصولٍ ثلاثة:
1- الجهاد كفريضة من فرائض الاسلام.
2- تغيير المنكر باليد.
3- الخروج على الحاكم لفسقه وعدم إقامته أحكام الإسلام.
وسنحاول أن نتعرض لهذه الأفكار كلٍ على حدة.. ثم نتعرض لبعض الأخطاء المنهجية في طريقة التفكير والاستدلال لدى جماعات العنف.
1. الجهاد
الجهاد فريضة من فرائض الاسلام لا يجادل في ذلك من له أدنى معرفة بأحكام الاسلام “كُتِبَ عليكم القتال وهو كُرْهٌ لكم” (البقرة، 216) وهو فريضة ماضية إلى يوم القيامة لا ناسخ لها مصداقا لحديث النبي- صلى الله عليه وسلم- “الجهادُ ماضٍ إلى يوم القيامة” (1) وقد ذهب جمهور فقهاء المسلمين إلى أنه فرضُ كفاية على الأمة إلا في أحوال بعينها يتحول إلى فرض عين, وذلك في ثلاثة مواضع: أحدها: إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان حرم على من حضر الانصراف وتعين عليه المقام لقول الله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبُتُوا واذكروا الله كثيراً” (الأنفال، 45) وقوله: “واصبروا إن الله مع الصابرين” (الأنفال، 46) وقوله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار ومن يُولِّهم يومئذ دُبُرَه إلا متحرفاً لقتالٍ أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله و مأواه جهنم وبئس المصير” (الأنفال، 15-16). الثاني: إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالُهم ودفعُهم. والثالث: إذا استنفر الإمام قوماً لزمهم النفير معه لقول الله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض” الآية والتي بعدها من سورة التوبة (39-38)؛ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: “إذا استُنفِرتُم فانفروا”. (2)
وأحكام الجهاد مبسوطة في كتب الفقه بإسهاب، كما تم تناولها في مبحث الشيخ مزيد البوني فليرجع إليه؛ ونكتفي هنا بالإشارة إلى مسألتين مهمتين:
الأولى: أن مفهوم الجهاد في الاسلام أوسع من حمل السلاح في ميدان القتال، وإن كان حمل السلاح بلا شك من أشرف أنواع الجهاد إلا أن الأمر أوسع كثيرا من مجرد القتال في ساحة معركة، وربما يكون من الأدق أن يطلق على هذا النوع من الجهاد: القتال “كتب عليكم القتال” (البقرة، 216). أما الجهاد فهو أوسع مفهوماً ومضمونًا، ولعل ذلك الحديث الرائع يبين هذا المعنى بوضوح، فقد روى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: “أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر”. (3) إن هذا الحديث لا يُدخل في مسمى الجهادِ الجهادَ بالكلمة فحسب، وإنما يجعله في ذروة أنواع الجهاد، بل هو أفضل الجهاد على الاطلاق وإن كان لا يتضمن جهادا بالسيف ولكنه جهاد باللسان، بل إن الذي يمارس هذا النوع من الجهاد فيقتل في سبيله يقف من الشهداء في المقدمة والسيادة فـ”سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله”. (4) هذان الحديثان يوسعان مفهوم الجهاد فإذا جهاد الكلمة والحجة والبيان لا يقل –إن لم يزد- عن جهاد السيف والسنان. وما لنا نذهب بعيدا وهذا كتاب الله ينطق بالحق فيفرض على المسلمين الجهاد في مرحلة لم يكن فيها للسيف محل في جهادهم وهي المرحلة المكية حيث لم يؤذن لهم بمجرد رد العدوان أو الدفاع عن أنفسهم ومع ذلك يقول الله تعالى: “وجاهدهم به جهاداً كبيراً” (الفرقان،52)، والآية من سورة الفرقان وهي مكية والمعنى جاهدهم بالقرآن وماذا يكون الجهاد بالقرآن؟ إنه جهاد البيان والحجة والمناقشة والبرهان والدعوة، كل هذا يدخل في مسمى الجهاد في مفهوم القرآن والسنة فإذا ما انتهينا من هذه النقطة وهي أن مفهوم الجهاد أوسع من مجرد حمل السلاح في ميدان القتال انتقلنا إلى نقطة أخرى وهي:
الثانية: أن هناك فارقاً بين القتال في ظل نظام يدافع عن الاسلام ويذود عن بَنيه، وبين الخروج على النظام وإن كان في إسلامه دَخَنٌ. لقد قال علماؤنا بالجهاد مع الحاكم الفاسق لأن الجهاد حينئذ ليس لتثبيت أركان حكمه بقدر ما هو للدفاع عن عقيدة الامة وأرضها، وإن كان هناك ظالم يقف على رأس القيادة في هذه الأمة. وإذا استعرضنا تاريخ كثير من الخلفاء الامويين أو العباسيين سنجد أن الفسق كان سمة كثير منهم ولكن لم يقل فقهاؤنا الذين عاصروهم بأنه لا يجاهد معهم وتحت قيادتهم للدفاع عن حياض الاسلام أو لفتح مزيد من البلدان.
هناك فارق بين الجهاد في ظل دولة للدفاع عنها أو لنشر الرسالة التي تحملها وبين الخروج على الحاكم الفاسق في هذه الدولة، وفي الحالة الأولى نحن أمام صورة واضحة للجهاد في الاسلام تحت راية دولة وإمام. في الحالة الثانية يحتاج الأمر إلى كثير من التفصيل ووزن الأمور فنحن لسنا أمام كفر واضح متميز بأهله وذويه يواجهه إيمان واضح، وإنما الامر أعقد من ذلك كثيرا. نحن أمام مجتمع يُكَوِّن الإسلام ثوابته ومسلماته وقيمه في الاغلب الأعم، وأهله وذووه يعتزون بالإسلام عقيدةً وهويةً ومنهاجاً، ومن يحكم لا يجرؤ بحال على أن يعلن رفضه الإسلام في أي من عقيدته أو قيمه أو تشريعاته. وإزاء كل هذا هل يكون الخروج بالسلاح على النظام الحاكم لهذا المجتمع والذي يمثل الاسلام أهم روافده أمراً واضحاً جلياً كما يكون القتال في ظل دولة تتصدى لأعداء الإسلام وتذود عن أرضه وحياضه؟ لا شك أن الصورتين مختلفتان وأن الجهاد تحت راية نظام واضح ودولة مستقرة ليس كحمل السلاح للقضاء على النظام الحاكم والذي بالطبع لن يستسلم هكذا وانما سيواجه بكل عنف وبكل ما يترتب على ذلك من إسالة دماء مسلمة أو مسالمة في كل الاحوال.
وهل هذا يعنى أن يستسلم العاملون للإسلام لكل ما يصيبهم ويحل بهم من عسف الظالمين من حكامهم؟ وأن يتذرعوا فحسب بالصبر دون أن يتحلوا بالقوة اللازمة للردع؟ وإذا سلمنا بهذا هل يظل العاملون لأجل التمكين للإسلام ينتظرون حتى تتغير الأمور وتتبدل الأنظمة دون ان تكون لهم مشاركتهم الفعالة في إقصاء الأنظمة الغاشمة؟ وهل يظل الجهاد ركناً معطلاً وفريضة غائبة لأن الأنظمة الحاكمة لم تعد تخوض معركة لأجل استرداد ما ضاع وتحرير ما اغتصب؟
لا شك عندي أن الإجابة على هذه الأسئلة بالنفي ولكن من قال إن السعي الدائب لدعوة الناس لصحيح الإسلام وتصحيح ما شاب فهمه من أغاليط وتغيير أنماط سلوكياتهم المتعارضة مع أخلاق الإسلام وتغيير القيم المتعارضة مع قيم الإسلام، من قال إن ذلك العمل المضنى لا يدخل في مسمى الجهاد ولا يكون طريقا واضحا نحو تغيير الأنظمة التي ترفض أن يكون الاسلام مرجعية الأمة. ثم هل الوقوف أمام هذه الأنظمة لممارسة أعظم أنواع الجهاد بكلمة الحق تقال وتكتب وتذاع بين الناس وإن أدى الأمر إلى التنكيل والقتل، لا يعد عملا على تغيير هذه الأنظمة الفاسدة وتجييش الجماهير ضدها فإما أن تستجيب لمطلبهم وهو “احترام الإسلام كمرجعية للأمة” وإما سيزداد الضغط الجماهيري عليها حتى تنتهي.
وإذا فشل دعاة “الحل الإسلامي” في أن تصل فكرتهم للناس وفى أن يغيروا من مفاهيم المجتمع وقيمه وأعرافه حتى يصلوا به لأن يكون مؤهلا للقيام بالإسلام والتضحية في سبيله والضغط على النظام الحاكم لينصاع لإرادة المجتمع الذي لا يقبل غير الاسلام عقيدة ومنهاجا وتشريعا، إذا فشل “الإسلاميون” في ذلك فلا أعتقد ان لُجُوءَهم للعنف يُمكِنُ أن يُمكِّنَ لهم في المجتمع، لأن المجتمع نفسه غير مؤهل لا لاستقبالهم ولا لأن يكون تربة لأنموذج مجتمع مسلم. ولأنهم عندما يفشلون فيما أسلفناه سيعني هذا أنهم ليسوا أهلا للقيام بالإسلام لأن الاسلام فكرة أقنعت العقول ثم عقيدة تغلغلت في القلوب ثم تغيير لأنماط السلوك ثم مجتمع ودولة، هكذا كان في بدايته وهكذا ينبغي أن يكون دائما الطريق الصحيح لإقامته.
2. تغيير المنكر
من أكثر الأفكار إثارة للجدل في أفهام العاملين للإسلام وأدبياتهم فكرة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وإنما كانت مثيرة للجدل ومظنَة سوء الفهم والوقوع في الخطأ لأنها من ناحيةٍ أصلٌ عظيمٌ من أصول الاسلام وقطبٌ من أعظم أقطابه بل –وعلى حد تعبير أبى حامد الغزالي- ” القطب الأعظم في الدين وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين، ولو طوى بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وعمت الفترة وفشت الضلالة وشاعت الجهالة واستشرى الفساد واتسع الخرق وخربت البلاد وهلك العباد”. (5) وهذا الذي قاله الغزالي ولم يجاوز فيه الحقيقة يصور خطورة هذا الأمر ومكانته من الدين، والآيات والأحاديث في ذلك كُثْرٌ ليس المقام مقام استعراضها وحسبنا أن نقف مع هذين النصين: الأول قول الله تعالى: “ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون” (آل عمران، 104)، والثاني: قول النبي- صلى الله عليه وسلم-:” لتأمُرُنَّ بالمعروف ولتَنْهَوُنَّ عن المنكر أو ليُسَلِّطَنَّ الله عليكم شراركم ثم يدعوه خيارُكم فلا يستجاب لهم”. (6) هذا من ناحية أهمية الفريضة, ولكن من ناحية أخرى فإن ممارسة النهى عن المنكر دون معرفة فقهه وآدابه قد يجر على الفرد بل على الأمة أعظم الكوارث وأشد المصائب, وقد يتسبب في فتن عارمة لا يعلم مداها إلا الله, وعلى حد تعبير ابن القيم:” من تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر, فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه فقد كان رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها بل لما فتح الله عليه مكة وصارت دار إسلامٍ عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم ومنعه من ذلك –مع قدرته عليه- خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديثي عهد بكفر, ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه كما وجد سواء”. (7)
فالنهى عن المنكر فريضة لا ينبغي أن يجهلها مسلم ولكن ممارسته دون فقه ووعى وإدراك لما يمكن أن يؤدى إليه يتعارض تماما وحكمة هذه الفريضة والمقصود منها وهو إزالة المنكر كلية أو التخفيف منه، وإشعار كل مسلم أنه منوط به القيام بهذا الدين وأنه لا يحل له أن يدير ظهره لمشكلات مجتمعه وأمته وإلا فقد أخل بأصل من أصول إسلامه. وللنهى عن المنكر أركان أربعة: الفعل ذاته- أي فعل النهي- وهو ما يسميه الغزالي “نفس الاحتساب”، والمنكر الذي ينهى عنه، والقائم بالفعل أي الذي يقوم بالنهى أو”المحتسب”، والذي يفعل المنكر أو “المحتسب عليه” أو بتعبير آخر: 1- المُحتَسَب فيه, 2- والمُحتَسَب عليه, 3- والمُحتَسِب، 4- ونفس الاحتساب. فهذه أركان أربعة سنقف معها تفصيلاً لما يترتب على سوء فهمها من أخطاء عظيمة يرتكبها العاملون في الحركة الاسلامية – أو في بعض فصائلها التي تمارس العنف، وسنبدأ بالفعل الذي يوجب التغيير أو المنكر الموجب للحسبة.
أما الركن الأول: وهو المنكر الواجب تغييره فيقال فيه:
1. المنكر: وأصل المنكر ما أنكره الله ورآه أهل الايمان قبيحاً. وشرعاً: اختلف العلماء في حده ولعل تعريف أبى حامد الغزالي من أفضل التعريفات وأيسرها وهو أنه “كل محظور الوقوع في الشرع”، (8) والمنكر أعمُّ من المعصية لأن “من رأى صبياً أو مجنوناً يشرب الخمر فعليه أن يريق خمره ويمنعه وكذا إن رأى مجنوناً يزنى بمجنونة أو بهيمة فعليه أن يمنعه منه وليس ذلك لتفاحش صورة الفعل وظهوره بين الناس بل لو صادف هذا المنكر في خلوة لوجب المنع منه وهذا لا يسمى معصية في حق المجنون إذ معصية لا عاصي بها محال”، (9) فالتلازم بين المنكر والمعصية غير حتمي “فقد يرتكب الشخص منكراً ولا يعد مع ذلك عاصياً، وقد يأتي المعصية دون أن يقع منه منكر، وعلة ذلك أن المنكر سلوك يخالف الأمر أو النهي، أما المعصية فاعتقاد وقت السلوك بأنه يخالف الأمر أو النهى سواء كان ذلك في واقع الحال أم لم يكن، فليس من لوازم المنكر- إذاً- أن يكون فاعله عالماً بوجه المخالفة؛ وليس من لوازم المعصية أن يكون السلوك فيها منطوياً على مخالفة. (10)
2. ليس كل منكر يوجب الحسبة بل المنكر الموجب للحسبة له شروط إذا لم يستكملها لم يجب الإنكار فيه؛ وهذه الشروط ثلاثة:
أ) أن يكون حالَّاً أي موجوداً في الحال.
ب) أن يكون ظاهراً بغير تجسس.
ج) أن يكون معلوماً كونه منكراً من غير اجتهاد.
فأما الشرط الأول: وهو حلول المنكر أي كونه موجوداً في الحال فلاستبعاد الإنكار في حالين هما:
– الأولى: أن يكون فاعل المنكر قد فرغ منه فلا ينكر عليه وإن خشي العود لأن النهى إنما هو “لرفع المنكر أي لمنع استمراره لا للوقاية من تكراره فالوقاية من التكرار سبيلها العقاب وليس الاحتساب ولا يعنى ذلك حظر وعظ الفاعل” (11)
– الثانية: أن يكون المنكرُ متوقعاً وهنا لا يجوز الاحتساب وإن وجدت قرائن تدل على العزم على فعل المنكر فهنا- أيضا- لا يجوز إلا الوعظ “وإن أنكر عزمه عليه لم يجز وعظه أيضا فإن فيه إساءة ظن بالمسلم” (12)
وأما الشرط الثاني: وهو أن يكون المنكر ظاهراً غير مستترٍ ولا يحتاج إلى تجسس لاكتشافه؛ وليس المراد بالظهور ذيوعه وانتشاره وافتضاح أمره للكافة بل “المراد تمكن الغير من شهوده ولو كان الغير واحدا”، (13) “ومناط الظهور هو إدراك الغير للمنكر إدراكاً مباشراً ولا يتخصص هذا الإدراك بطريق معينة بل كل ما يؤدى إليه معتبر وتتسع طرائق الإدراك للحواس الخمس”. (14) أما إذا فعل المنكر فاعله مستتراً غالقاً عليه داره فلا يجوز انتهاك حرمة الحياة الخاصة للكشف عن المنكر ذلك أن انتهاك حرمة الحياة الخاصة أشد ضرراً وأعظم مفسدةً من اكتشاف المنكر والنهى عنه؛ ولذا “فكل من ستر معصية في داره وأغلق بابه لا يجوز أن يتجسس عليه وقد نهى الله تعالى عنه”، (15) فإن قلت فما حد الظهور والاستتار: فاعلم أن من أغلق باب داره وتستر بحيطانه فلا يجوز الدخول عليه بغير إذنه لتعرف المعصية إلا أن يظهر الدار ظهوراً يعرفه من هو خارج الدار”. (16)
أما الشرط الثالث من شروط المنكر الموجب للحسبة والنهى: فهو أن يكون هذا المنكر معلوماً كونه منكراً بغير اجتهاد أي” فكل ما هو في محل الاجتهاد فلا حسبة فيه؛ فليس للحنفي أن ينكر على الشافعي أكله الضب والضبع ومتروك التسمية؛ ولا للشافعي أن ينكر على الحنفي شربه النبيذ الذي ليس بمسكر وتناوله ميراث ذوي الأرحام وجلوسه في دار أخذها بشفعة الجوار إلى غير ذلك من مجاري الاجتهاد”. (17)
الركن الثاني: من أركان النهى عن المنكر أو الاحتساب: هو عملية التغيير ذاتها أو نفس الاحتساب- على حد تعبير الغزالي- وهو أيضا له شروطه وآدابه ودرجاته وليس كل منكرٍ حالٍّ وظاهر ومعلوم كونه منكراً بغير اجتهاد يجب تغييره في الحال لأن عملية التغيير لها فقهها وقد يوجد المنكر بالشروط السابق بيانها ومع ذلك لا يجب تغييره بل وربما يحرم تغييره في بعض الأحوال.
وأهم شروط الإنكار: ألا يترتب على إنكار المنكر منكرٌ أشدُ منه، ذلكم أن غاية عملية الانكار إزالة المنكر بالكلية أو التخفيف منه فإن لم يتحقق هذا ولا ذاك خرج النهى عن المنكر عن الوجوب والندب بل وربما أصبح حراماً إذا ترتب على الإنكار منكرٌ أشدُ ويُفَصِّلُ ابنُ القيِّم ذلك فيقول ” فإنكار المنكر أربع درجات: الأولى أن يزول ويخلفه ضده والثانية أن يقل وإن لم يزل بجملته والثالثة أن يخلفه ما هو مثله والرابعة أن يخلفه ما هو شر منه؛ فالدرجتان الأوليان مشروعتان والثالثة موضع اجتهاد والرابعة محرمة”. (18)
ويضرب أمثلة للدرجة الرابعة هذه فيقول: “وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر وقد استأذن الصحابة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ فقال: لا؛ ما أقاموا الصلاة؛ وقال: من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر ولا يَنْزِعنَّ يداً من طاعته.
ومَن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار يراها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه؛ فقد كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها ؛ بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلامٍ عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم ومنعه من ذلك – مع قدرته عليه- خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديثي عهد بكفر ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه”. (19)
ويضرب ابن القيم مثالاً آخر على عدم الإنكار وإن وُجِد المنكرُ بشروطه فيقول:” كما إذا كان الرجل مشتغلاً بكتب المجون ونحوها وخفت من نقله عنها انتقالَه إلى كتب البدع والضلال والسحر فدعه وكتبه الأولى”. (20) ومن أمثلة ذلك أيضا أن النبي – صلى الله عليه وسلم- نهى عن قطع الأيدي في الغزو مع أنه حد من حدود الله تعالى ولكنه نهى عن إقامته في الغزو “خشية أن يترتب عليه ما هو أبغض إلى الله – من تعطيله أو تأخيره- من لحوق صاحبه بالمشركين حميةً وغضباً”. (21)
وننتقل الآن للركن الثالث من أركان الحسبة أو “الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر” وهو الركن الثالث: المُغَيِّرُ للمنكر أو المُحتَسِبُ وهذا أيضا له شروطٌ وآدابٌ؛ فأما الشروط فثلاثة: الإسلام والتكليف وأن يكون عالماً بما يأمر به وما ينهى عنه وهناك شرط رابع اشترطه البعض وهو العدالة كما يشترط إذن الحاكم عند بعض الفقهاء في بعض مراتب التغيير.
فأما شرط الإسلام: فواضحٌ بينٌ إذ لا يطلب من غير المسلم أن ينفعل ويغضب لفعل يعده الإسلام منكراً كما أن النهى عن المنكر واجبٌ شرعيٌ إسلاميٌ ككل الواجبات الشرعية تجب بالإسلام والبلوغ والعقل. وأما شرط التكليف: فلا يخفى وجه اشتراطه لأن غير المكلف لا يلزمه أمر والمقصود هنا شرط الوجوب لا الجواز لأن شرط الجواز لا يستلزم البلوغ فلو أن الصبي قام بالنهى عن المنكر لأُثِيبَ على ذلك واستُحسِن منه في الدنيا كما في سائر القربات. أما شرط العدالة: فقد اشترطه البعض ولكن عند التحقيق نجد أنه لا صحة لاشتراطه لأن النهى عن المنكر واجب شرعي لا يشترط لمباشرته عدالة المسلم بل هو مطلوب من المؤمن التقى والفاسق على السواء؛ نعم إن نهى الفاسق عن المنكر قد لا يؤثر في فاعل المنكر ولكن يظل النهى عن المنكر واجباً عليه وإن كان للمنكر فاعلاً؛ ففعل المنكر معصية وترك النهى عنه معصية أخرى ولا يلزم من الوقوع في إحداهما ارتكاب الأخرى ولذا يقول سعيد بن جبير:” إن لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن المنكر إلا من لا يكون فيه شيء لم يأمر أحد بشيء فأعجب مالكاً ذلك من سعيد بن جبير”. (22)
أما شرط إذن الإمام فعلى إطلاقه غير صحيح لأن الأخبار والآيات التي تأمر بالقيام بهذا الواجب لم تقيد بإذن الإمام بل يُفهم منها عكسُ ذلك؛ فقوله صلى الله عليه وسلم “من رأى منكم منكرا فليغيره” رواه مسلم , دليلٌ على أن كل من يرى المنكر مطالبٌ بتغييره سواء أذن له الإمام أو لم يأذن؛ بل إنه دليل على عدم وجوب الاستئذان لأنه لا يعقل أن يطالب المسلم إذا رأى منكراً أن يسعى لاستئذان الإمام ثم يأتي لتغييره إذ الأمر منوط بلحظة رؤية المنكر والحديث يُحمِّل كل مسلم يرى منكراً أن يسعى لتغييره في الحال حسب قدرته واستطاعته؛ ثم كيف يكون الأمر مرهوناً بإذن الحاكم والحاكمُ نفسه قد يقع في منكرٍ يجب نهيُه عنه فهل يُستأذن حتى ينهى عن المنكر الواقع فيه؟!
لا شك أن شرط إذن الحاكم لا دليل عليه من كتابٍ ولا سنةٍ بل الأدلة على ضده وحسبنا هنا ما رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي من حديث أبى سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:” أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر” فهذا دليل على أن نهى الأمراء عن المنكر من أعظم أنواع الجهاد بل أعظمها ولم يكن كذلك إلا لما يترتب عليه – غالبا- من مصائب تصيب من يقوم به. على أن عدم اشتراط إذن الإمام ليس في كل درجات التغيير ولكن في النهى باللسان واليد في حدود إزالة عين المنكر لا التعرض لفاعله بضرب قد يحتاج شهر السلاح وجمع الأعوان فذلك يحتاج إذن الحاكم على ما بيناه لما يترتب عليه من خطرٍ عظيم ؛ ويشترط كذلك في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عالماً بما ينهى عنه وكون ذلك منكراً متفقا بين العلماء على حرمته والناس يختلفون في ذلك فهناك أمور لا يسع مسلماً الجهلُ بها كوجوب الصلاة وحرمة الزنا وهناك من المحرمات ما يخفى على غير العلماء فلا ينبغي أن ينهى عنه إلا من كان عالماً به؛ وفى ذلك يقول النووي :”ثم إنه إنما يأمر وينهى من كان عالماً بما يأمر به وينهى عنه وذلك يختلف باختلاف الشيء فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها فكل المسلمين علماء بها و إن كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره بل ذلك للعلماء”. (23) ويقول الغزالي: ” العامِّي ينبغي له ألا يحتسب إلا في الجليات المعلومة كشُرب الخمر والزنا وترك الصلاة فأما ما يعلم كونه منكراً بالإضافة إلى ما يطيف به من أفعال ويفتقر فيه إلى اجتهاد فالعامي إن خاض فيه كان ما يفسده أكثر مما يصلحه”.
هذه شروط الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ثم إن له آداباً ينبغي عليه مراعاتها والتزامها وإلا خرج عن النهج القرآني الحكيمِ الآمرِ الداعيةَ إلى الله أن يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة, وخرج كذلك عن النهج النبوي العظيم والذى رسم المنهاج واضحا لمن يتصدى للنهى عن المنكر وكيف ينبغي مراعاة أحوال الناس ومقاماتهم ولعل حديث الأعرابي الذى بال في المسجد خير مثال على ما نقول, فقد روى ابن ماجة في كتاب الطهارة باب الأرض يصيبها البول كيف تغسل, عن أبى هريرة قال: دخل أعرابي المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقال: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: “لقد احتظرت واسعاً (24) ثم ولَّى حتى إذا كان في ناحية المسجد فشج يبول فقال الأعرابي بعد أن فَقِه فقام إلىَّ بأبي وأمي فلم يُؤنب ولم يسُب فقال: “إن هذا المسجد لا يُبال فيه و إنما بُنِى لذكر الله وللصلاة” ثم أمر بسَجْل من ماء فأفرغ على بوله: وفى رواية أنس: فوثب إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا تزرموه” ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه. (25)
فانظر عظم رفق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في النهى عن المنكر الذي ارتكبه الأعرابي ومدى مراعاته حال الرجل. إن “ما اقترفه الأعرابي منكر لا شك فيه من وجوه كثيرة أعلاها حرمة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وحضرته ذلك الفعل وما اقترفه الأعرابي لا يحتاج العلم بأنه منكر إلى معرفة خاصة فالفطرة تأباه وبرغم ذلك ما أنّبَهُ النبي صلى الله عليه وسلم وما سبَّهُ بل وما غضب بل كان الرفيق الرحيم”. (26)
ومن أهم ما ينبغي مراعاته من آداب وزنُ الأمور وما يمكن أن يترتب على نهيه فإذا كان نهيه سيؤدى لمصلحةٍ راجحة فهو ما يريده الشرع, وإن علم أن نهيه سوف لا يؤدى لزوال المنكر ولا التقليل منه وسيترتب عليه أذى شديد يصيبه وقد يصيب ذويه فهو خارج عن حدود ما شرعه الله, بل يقول الغزالي: “إن علم أنه لو أنكر عليه لشرب القدح وضرب رقبته فهذا مما لا أرى للحسبة فيه وجهاً وهو عين الهلاك فإن المطلوب أن يؤثر في الدين أثراً ويفديه بنفسه فأما تعريض النفس للهلاك من غير أثر فلا وجه له بل ينبغي أن يكون حراماً وإنما يستحب له الإنكار إذا قدر على إبطال المنكر أو ظهر لفعله فائدة وذلك بشرط أن يقتصر المكروه عليه فإن علم أنه يضرب معه غيره من أصحابه أو أقاربه أو رفقائه فلا تجوز له الحسبة بل تحرم لأنه عجز عن دفع المنكر إلا بأن يفضي ذلك إلى منكر أخر وليس ذلك من القدرة في شيء”. (27)
ومن الآداب التي يجب مراعاتها من المُحتسِب مراعاة حال من يحتسب عليه من حيث علمه وجهله ودرجة فهمه وفقهه ومقامه وسنه وعلاقته به كأن يكون له أب أو ذو سلطان عليه؛ فأما مراعاة درجة علمه و فقهه فلعل حديث الأعرابي الذى بال في المسجد يدل عليه كما يجب أن يكون المحتسب حكيماً حليماً رفيقاً ذا خبرة بنفسيات الناس وحاجاتهم يدل على ذلك ما رواه أبو أمامة قال :إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه، مه، فقال: “ادنه” فدنا منه قريب ، قال: فجلس, قال: “أتحبه لأمك” قال: لا والله جعلنى الله فداءك، قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم، قال أتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم، قال: أتحبه لأختك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك، قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم، قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك، قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك، قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم، قال: فوضع يده عليه وقال: “اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه” فلم يكن بعد ذلك الفتى يلفت إلى شيء”. (28)
فأي منكرٍ أشد من الزنا وها هو الشاب يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعله ؛ ولو كانت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم تعنيفاً وتوبيخاً لما عالج ذلك شهوةً عارمةً تستبد بذلك الشاب؛ لكن النبي – صلى الله عليه وسلم- العالم بنفوس الناس وكيف يعالجها عالج الأمر بحكمة بالغة معلماً ذلك الشاب أن أعراض الناس كأعراضه وأن ما يزعجه من الاعتداء على عرضه يزعج الناس كذلك وأن تلك التي سيزنى بها هي بالضرورة أم أو أخت أو ابنة أو عمة أو خالة وما يسيئه يسيئ غيره؛ ثم ها هو – صلى الله عليه وسلم- يقربه منه و يدعو له بالصلاح و بأن يُحصِّن الله فرجه. لقد أدرك- صلى الله عليه وسلم- بعظيم حكمته وإحاطته بالنفوس البشرية أن ذلك الشاب ليس بالمتجرئ على المعاصي بلا حياءٍ ولا وجلٍ ولا تعظيمٍ لله تعالى وليس بالمدافع عن الفاحشة دفاع من يتبناها وينشرها ولكنها شهوةٌ عارمةٌ غلبته في عنفوان شبابه فعجز عن كبح جماحها والتحكم فيها فعالجه النبي الكريم – صلى الله عليه وسلم- أنفع العلاج وأنجعه. وهكذا ينبغي أن يكون من يتصدى للنهى عن المنكر عالماً بالنفس البشرية وحاجاتها ونزواتها عالماً بمن ينهاه عن المنكر سالكاً أفضل الطرق للوصول إلى مفتاح شخصيته لأنه ليس من يفعل الشر مجادلاً عنه متبنياً نشره في المجتمع كمن تزل به قدمه أو تضعف في لحظةٍ نفسُه أو تتمكن منه شهوة من شهواته فيباشر المعصية غير محب لها ولا مجادلاً عنها ولكن لضعفٍ اعتور نفسه البشرية. يدل على ذلك أيضا ما رواه البخاري عن عمر بن الخطاب: أن رجلاً في عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كان اسمه عبد الله وكان يلقب حماراً وكان يُضحِكُ رسولَ الله- صلى الله عليه وسلم- أحياناً وكان نبي الله- صلى الله عليه وسلم- قد جلده في الشراب فأُتى به يوماً فأمر به فجُلد فقال رجلٌ من القوم: اللهم العنه ما أكثر ما يُؤتى به؛ فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: لا تلعنوه فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله”. فهذا شارب للخمر ويتكرر ذلك منه ولكنه مع ذلك يحب الله ورسوله كما أخبر النبي – صلى الله عليه وسلم. لقد ضعف الرجل أمام إدمان استبد به ولكنه مع ذلك لم يفتر حب الله في قلبه ولذا ينهى النبي – صلى الله عليه وسلم- عن لعنه إذ الأولى بهذا أن يُدعى له بالهداية وبأن ينصره الله على نفسه وعلى ذلك الداء الوبيل الذى ضعفت نفسه أمامه؛ والأمثلة كثيرة على ذلك الأدب المهم من آداب الاحتساب وهو ضرورة أن يكون المحتسب رفيقاً عالماً بحال المحتسَب عليه و بأصلح الطرق للاحتساب عليه؛ وقد كان علماء الأمة يسيرون على هذا النهج: قال محمد بن زكريا الغلابي: شهدت عبد الله بن محمد بن عائشة ليلة وقد خرج من المسجد بعد المغرب يريد منزله وإذا في طريقه غلامٌ من قريش سكران وقد قبض على امرأة فجذبها فاستغاثت فاجتمع الناس يضربونه فنظر إليه ابن عائشة فعرفه فقال للناس: تنحوا عن ابن أخي؛ ثم قال: إلىَّ يا ابن أخي فاستحى الغلام فجاء إليه فضمه إلي نفسه ثم قال له: امض معي فمضى معه حتى صار إلى منزله فأدخله الدار وقال لبعض غلمانه: بيِّته عندك فإذا أفاق من سكره فأعلمه بما كان منه ولا تدعه ينصرف حتي تأتيني به فلما أفاق ذكر له ما جرى فاستحيا منه وبكى وهم بالانصراف؛ فقال الغلام: قد أمر أن تأتيه فأدخله عليه فقال له: أما استحييت لنفسك؟ أما استحييت لشرفك؟ أما ترى من ولدك؟ فاتق الله وانزع عما أنت فيه؛ فبكى الغلام منكسا رأسه ثم رفع رأسه وقال: عاهدت الله تعالى عهداً يسألني عنه يوم القيامة أنى لا أعود لشرب النبيذ ولا لشيء مما كنت فيه وأنا تائب؛ فقال: ادن منى فقبل رأسه وقال: أحسنت يا بنى؛ فكان الغلام بعد ذلك يلزمه ويكتب عنه الحديث وكان ذلك ببركة رفقه ثم قال: إن الناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويكون معروفهم منكرا فعليكم بالرفق في جميع أموركم تنالون به ما تطلبون”. (29)
ومن آداب الاحتساب كذلك التي يجب مراعاتها أنه لا يجوز ممارسة النهى عن المنكر مع بعض الناس إلا في حدود التعريف والوعظ بالكلام اللطيف وذلك كنهي الولدِ والدَه عن المنكر فلا يجوز له أن يتعدى حدود التعريف والنصيحة بالرفق واللين؛ واختلفوا: هل يجوز أن يمارس إزالة المنكر ذاته كإراقة الخمر مثلاً؟ فقال الغزالي: “الأظهر في القياس أنه يثبت للولد ذلك” (30) لأن إزالة المنكر هنا ليس فيها تعرض لفاعله ولكن ليحذر أن يؤدى ذلك إلى منكرٍ أشد فحينئذ لا تكون إزالته مطلوبة شرعاً: وكذلك في نهي الحكام والسلاطين فقد قال فيه الغزالي: “وأما الرعية مع السلطان فالأمر فيه أشد من الولد- أي مع والده- فليس لها معه إلا التعريف والنصح فأما الرتبة الثالثة ففيها نظر من حيث إن الهجوم على أخذ الأموال من خزانته وردها إلى الملاك وعلى تحليل الخيوط من ثيابه الحرير وكسر آنية الخمور في بيته يكاد يفضى إلى خرق هيبته وإسقاط حشمته وذلك محظور ورد النهى عنه”. (31)
ولكن هناك نصوص تدل على جهاد الأمراء باليد ومن ذلك ما رواه مسلم من حديث ابن مسعود رضى الله عنه عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: “ما من نبي بعثه اللهُ في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل” قال ابن رجب الحنبلي: “وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد وقد استنكر الإمام أحمد هذا الحديث في رواية أبى داود وقال هو خلاف الأحاديث التي أمر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فيها بالصبر على جور الأئمة وقد يجاب عن ذلك بأن التغيير باليد لا يستلزم القتال وقد نص على ذلك أحمد أيضاً في رواية صالح فقال: “التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح فحينئذ جهاد الأمراء باليد أن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات مثل أن يريق خمورهم أو يكسر آلات الملاهي التي لهم ونحو ذلك أو يبطل بيده ما أمروا به من الظلم إن كان له قدرة على ذلك وكل ذلك جائز؛ وليس هو من باب قتالهم ولا من الخروج عليهم الذى ورد النهى عنه؛ فإن هذا أكثر ما يخشى منه أن يُقتل الآمر وحده؛ وأما الخروج عليهم بالسيف فيخشى منه الفتن التي تؤدى إلى سفك دماء المسلمين”. (32)
وقد قسم باحثٌ معاصرٌ (33) علاقة من يقوم بتغيير المنكر بمن يقع منه المنكر إلى خمسة أحوال الرابع والخامس منها تدور حول الوالد والسلطان؛ وهذه الأحوال هي:
1- أن يكون للمُغيِّر ولايةٌ خاصةٌ على ذي المنكر كولاية الوالد على ولده والزوج على زوجته وهذه لا إشكال في أن الراعي أو المسئول يجب عليه تغيير المنكر بكل الوسائل المناسبة حسب الحالة.
2- أن يكون للمُغيِّر ولايةٌ عامةٌ على ذي المنكر كولاية السلطان على الرعية وأمته وهذه كسابقتها وربما أشد لأن السلطان بحكم مكانه واختصاصاته مسئول عن إزالة المنكرات وإقامة الشرع بكل السبل الشرعية.
3- ألا يكون لأي من المُغيِّر وذي المنكر ولايةٌ عامةٌ أو خاصةٌ كما بين أفراد الرعية وجعل هذه ذات شقين هما:
– أن يكون ولى الأمر الأعلى يقيم شرع الله وينكر المنكر ويغيره حين يعلم به.
– ألا يكون كذلك.
ورأى أنه في الحالة الأولى ليس للعامة أن تغير باليد بل عليهم إبلاغ ولى الأمر وقد سبق لنا مناقشة هذه المسألة في درجات تغيير المنكر فليرجع إليها؛ وفى الحالة الثانية وهي عدم إقامة الولي لشرع الله يرى أنه على العامة مناصرة العلماء للقيام في وجه السلطان لإجباره على التصدي للمنكر.
4- أن يكون لذى المنكر ولايةٌ خاصةٌ على من يقوم بالتغيير كأن يكون والداً أو زوجاً فإن كان كذلك فتغيير المنكر باليد حينئذ يرجع إلى نوع المنكر ودرجته فثم منكر يغير باليد دون أن يلحق صاحب المنكر إيذاءٌ في نفسه فللولد والزوجة في مثل هذا تغيير المنكر باليد إذا لم يترتب على ذلك ما هو أشد ضرراً؛ وللولد أن يمنع أباه والزوجةُ زوجَها من الإقدام على ما يتعلق به حق الآخرين كمثل قتل أو سرقة أو إحراق مال….فذلك مما لا يحتمل تأخيراً في تغييره بالصبر عنه؛ فإن كان كفراً بواحاً فليرفعْه إلى السلطان المقيم شرع الله تعالى ليغيره بما يستحق.
5- أن يكون ذو المنكر ذا ولاية عامة على من يقوم بتغيير منكره كأن يكون ذو المنكر هو السلطان وولي الأمر الأعلى؛ وهذا إن كان منكره خاصاً لا يتعلق بحق الرعية فعلى من يراه أن يغيره ما لم يترتب عليه منكرٌ أشد وإن كان منكره مما يجهر به فعلى علماء الأمة تعريفه وتعليمه وعلى العامة مناصرة العلماء ما دام المنكر ليس كفراً بواحاً.” (34)
وبعد، فهذه بعض آداب من يقوم بواجب التغيير؛ وننتقل الآن إلى الركن الرابع من أركان الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر:
الركن الرابع: وهو الفاعل للمنكر أو المحتَسَب عليه ولا يشترط فيه سوى أن يكون إنسانا فلا يشترط أن يكون مسلماً ولا عاقلاً ولا مميزاً ولا عالماً بكون الفعل منكراً؛ فيحتسب على الصبي والمجنون فلو شرب الصبي الخمر يُحتسب عليه وكذا لو زنى مجنون بمجنونة أو بهيمة لوجب الاحتساب عليه.
وبعد استعراض فريضة “النهى عن المنكر” من الناحية الفقهية وآداب ممارستها من الناحية العملية نرى أن الفصائل التي تنتهج العنف قد أغفلت الكثير من هذا الفقه وهذه الآداب:
1- فهُم يبدأون من حيث ينبغي أن ينتهوا؛ فالبداية بالوعظ والنصح والإرشاد والتوجيه، وأما النهى باليد فهو المرحلة الأخيرة بعد ثبوت عدم جدوى كل المراحل السابقة لها، وهي كما أسلفنا – منوطة بضوابط وشروطٍ قلَّ من ينتبه لها ويأخذ بها ويقف عند فقهها وآدابها.
2- وهُم لا يوازنون بين المنافع المتحققة من النهى عن المنكر والمضار المتوقعة منها فيتسببون بذلك في الإضرار الواضح بالمجتمع والأمة بل وبأنفسهم.
3- وهُم لا يتفهمون حال المُحتسَب عليه أو من يتم نهيُه عن المنكر من حيث علمه ومقامه ومكانته وأنسب السُبُل للوصول لمفاتيح شخصيته فيتسببون في تنفير الناس بدلاً من الأخذ بأيديهم إلى سعة الإسلام ورحابة الطاعة.
4- وهُم يلجأون – أحياناً- للدرجة الأخيرة التي اتفق جمهور الفقهاء على عدم جواز لجوء الأفراد لها وهي جمع الأعوان وشهر السلاح؛ الأمر الذي ينتهي بأضرارٍ بالغةٍ بالدعوة وبتجاربٍ فاشلةٍ تُهدر فيها الدماء وتُسلب فيها الأموال وتُدنَّس فيها الأعراض في معارك غير متكافئة ولا متوازنة، مع أن الله سبحانه لا يكلف نفساً إلا وُسعها؛ ولو تفهمت جماعات العنف فقه النهى عن المنكر وآدابه لوفَّرت الكثير من الجهد والمال والدم ولجعلت كل هذا في ميدان أو ميادين تعود على الأمة بالنفع وعلى الأفراد بالهدى والرشاد.
وبذلك نكون قد استعرضنا فكرة النهى عن المنكر كأحد الجذور الفكرية للظاهرة لننتقل إلى الأصل الثالث وهو فكرة الخروج على الحاكم.
3. الخروج على الحاكم
من أكثر الأفكار إثارة للجدل في تاريخ الفكر الإسلامي بمختلف تياراته وفرقه مسألة الخروج على الحاكم؛ ذلكم أن شرخاً من أعظم الشروخ في تاريخ المسلمين كان لهذا السبب و إن كانت الفئة الخارجة متأولة نعنى خروج معاوية ومن معه على الخليفة الشرعي على بن أبى طالب رضى الله عنه؛ ومهما قلنا في إنجازات بنى أمية فقد كان علىٌ – رضى الله عنه- خليفةً مختاراً من الأمة بطريق شرعي صحيح؛ وكان حكمُ بنى أمية بدايةَ القضاء علي الطريق الشورى في تنصيب الإمام وجعله ملكاً وراثياً أتى بالصالح كما أتى بالطالح وتولى في ظله عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين كما تولى أغيلمة من قريش بنص الحديث الشريف؛ وقبل ذلك كله عطَّل مبدأً من أهم مبادئ الحكم في الإسلام وهو حق الأمة في اختيار من يحكمها.
وظلت مسألة الخروج على الحاكم مثيرةً للجدل على امتداد تاريخ الأمة الإسلامية على المستوى التنظيري والتطبيقي على السواء وظهر أكثرُ من اتجاه في فقهنا الإسلامي إزاء هذه المسألة بين ثوري يحض على الخروج ما دام الظلم شائعاً والهوى غالباً وبين محافظٍ يرى المعارضة بشكل سلمى أكثر تحقيقاً لمصالح الأمة وصوناً لدماء بنيها التي سال منها الكثير في قتال إسلامي إسلامي. وبين اتجاه “وسطي أو عملي” يؤمن بالخروج والثورة ولكنه يرى أن الصبر حتي تمكن هذه الثورة لنفسها على مستوى القاعدة الشعبية ثم على مستوي القدرة القتالية لا بد منه كي لا تكون نهاية هذه الثورة نهاية مأساوية تنتهى “باستشهاد” دعاتها ومزيد من التمكين لنظام فاسد؛ والحق أن كلاً من هذه الاتجاهات وجَدَ له ما يؤصل به فكره سواء كان ذلك على مستوى النظرية أو على مستوى التطبيق؛ على مستوى النص أو على مستوى التجربة؛ فعلى مستوى النص نجد أن الأحاديث النبوية الواردة في هذه المسألة بعضها يدعو للصبر والطاعة في حدود المعروف وعدم الخروج ما لم يصل الأمر إلى الكفر البواح البين وبعضها يحث على التصدي لسلاطين الظلم باليد واللسان حتى وإن أدى الأمر إلى القتل إذ إنه يعنى هنا الشهادة بل أعلى درجات الشهادة ؛ وبعضها يربط السمع والطاعة بإقامة القرآن في الأمة أو بقيادة الأمة به بما يعنى بمفهوم المخالفة أنه مالم يُقِم الحاكمُ القرآنَ ويقود الأمة به فلا سمع له عليها ولا طاعة.
فأما النصوص الواردة في وجوب الطاعة وعدم الخروج على الحاكم وإن ظلم وبغى فكثيرة نذكر منها قول الرسول الكريم- صلى الله عليه وسلم:
1- “من كره من أميره شيئاً فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبراً مات ميتة جاهلية”. (35)
2- “دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان”. (36)
فهذه بعض النصوص الصحيحة التي تأمر المسلم أن يسمع ويطيع وألا يخلع يداً من طاعة وإن رأى ظلماً وأثرة وخروجاً على المعروف ما لم يصل الأمر إلى الكفر البواح أو ترك الصلاة. وهناك نصوصٌ أخرى قد يُفهم منها أنها حضٌ على الخروج على الحكام إذا ظلموا أو فسقوا أو قصروا بعض الشيء في إقامة الشرع الحنيف وإن لم يصل لحد الكفر؛ فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم:
1- “اسمعوا وأطيعوا وإن استُعمل عليكم عبدٌ حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله” (37)
2- “إن أُمِّر عليكم عبدٌ مجدعٌ- حسبتها قالت أسود- يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا” (38)
ويفهم من الحديثين أنه ما لم يقم كتاب الله ويقود الأمة به فلا طاعة له واجبة. فهذه بعض النصوص التي يُفهم منها جواز الخروج بل وجعل ذلك فضيلة إذا لم يلتزم الحاكم بالشرع الحنيف ويقيمه في الأمة. ولأن النصوص كما نرى ظاهرها التعارض فقد اختلف الفقهاء في حكم الخروج على الحاكم إذا ظلم وفسق فآثر بعضهم الصبر على جور الحكام ومنعوا الخروج عليهم مع الالتزام بواجب النهى عن المنكر؛ وفي مقدمة هؤلاء أحمد بن حنبل والحسن البصري رضى الله عنهما. ومال آخرون إلى “الفكر الثوري” والخروج على الحاكم إذا جار وظلم واعتدى على حرمات الله تعالى؛ وفى مقدمة هؤلاء الخوارجُ وبعض فرق الشيعة وقد يكون ابن حزم ممثلا لهذه المدرسة من أهل السنة. وهناك فريق ثالث توسط: فحض على الخروج إذا وُجدت أسبابُه وهي وجود طائفة قوية من الأمة والمقصود بالقوة هنا القوة العسكرية التي تواجه الحاكم بما يملكه من وسائل قوة، والقوة الشعبية بأن يكون لها مصداقية عالية عند عامة الناس بحيث يجدون من ينصرهم ويقف بجانبهم؛ وعلى رأس هذا الاتجاه أبو حنيفة رضى الله عنه.
فأما الاتجاه الأول:
وهو الداعي لعدم الخروج على الحاكم وإن ظلم وفسق فهو اتجاه جمهور أهل السنة والثابت نظرياً في اجتهادات الفقهاء وعملياً في عدم خروجهم على من عاصرهم من حكام اتصف أكثرهم بالفسق والظلم، وهو أيضا الثابت بالأحاديث السابقة الصحيحة الصريحة والتي تعلق أمر الخروج على الحاكم بالسيف وخلع اليد من طاعته بكفره أو بتركه الصلاة: “إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان”، “قيل أفلا ننابذهم يا رسول الله؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة”، “قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلّوا”.
فالأمر كله منوط بعدم الكفر أو بإقامة الصلاة التي هي دليل الإسلام العملي؛ ثم إن القول بالخروج على الحاكم لفسقٍ طرأ عليه يحمل ضمناً أن الحاكم ينبغي أن يكون في أعلى درجات التقوى وأن يستمر أمره على ذلك دوماً. وهذا عند التحقيق أصبح وجوده متعذراً ، و نحسب أن الخلفاء الذين حكموا أمة الإسلام بعد الأئمة الأربعة الراشدين واتصفوا بهذا يعدون على أصابع اليد؛ ولذا يقول إمام الحرمين أبو المعالى الجويني (18 محرم 419 هجرية -25 ربيع ثان 478 هجرية): “والمصير إلى أن الفسق يتضمن الانعزال والانخلاع بعيدٌ عن التحصيل فإن التعرض لما يتضمن الفسق في حق من لا يجب عصمته ظاهر الكون سراً أو علناً عام الوقوع’ وإنما التقوى ومجانبة الهوى ومخالفة مسالك المُنى والاستمرار على امتثال الأوامر والانزجار عن المناهي والمزاجر والارعواء عن الوطر المفقود وإنحاء الثواب الموعود هو البديع’ والتحقيق أنه لا يسير على التقوى إلا مؤيَّدٌ بالتوفيق؛ والجبلاتُ داعيةٌ إلى اتباع اللذات والطباعُ مستحثةٌ على الشهواتِ والتكاليفُ معظمها كلفٌ وعناءٌ ، ووساوس الشيطان وهواجس نفس الانسان متضافرة على حب العاجل واستنجاد الحاصل، والجبلة بالسوء أمارة، والمرء على أرجوحة الهوى تارة وتارة ….” (39) إلى أخر كلامه الذي دلل به على أن دوام الاتصاف بالتقوى من الأمور المتعذرة إلا في حق فئة قليلة يعصمها الله من الزلل، والإمام أكثر تعرضاً لذلك لكثرة اختصاصاته واهتماماته حتى انتهى الجويني لقوله: “فلا يبقى لدى بصيرةٍ إشكالٌ في استحالة استمرار مقاصد الإمام مع المصير إلى أن الفسق يوجب انخلاع الإمام أو يسلط خلعه على الاطلاق، والذي يجب القطع به أن الفسق الصادر من الإمام لا يقطع نظره ومن الممكن أن يتوب ويسترجع ويؤوب، وقد قررنا بكل عبرة أن في الذهاب إلى خلعه وانخلاعه بكل عثرةٍ رفضُ الإمامة ونقضُها واستئصالُ فائدتها ورفعُ عائداتها وإسقاطُ الثقة بها واستحثاثُ الناس على نزع الأيدي عن ربقة الطاعة”. (40)
إذا كان جمهور فقهاء أهل السنة قد آثروا الصبر على جور الحكام مع القيام بواجب النصيحة والنهى عن المنكر، ورأوا عدم جواز الخروج على الحاكم ما لم يكفر كفراً بواحاً، وما دام للصلاة مقيماً؛ فإن من فقهاء أهل السنة كذلك من رجح مذهب الخروج على الحكام إذا جاروا وظلموا.
والاتجاه الثاني جواز الخروج:
وهؤلاء انقسموا فريقين: أولهما يرى الخروجَ على الحاكم إذا ظلم وجار فريضةً لا ينبغي الاستنكاف عن القيام بها في كل الأحوال؛ وثانيهما وهو الأكثر رأى الخروج غير جائز ما لم توجد أدلة قوية على إمكانية نجاحه. وقد يفهم من كلام ابن حزم الفقيه الأندلسي العظيم (384-456 هجرية) تأييده للرأي الثاني وذلك لأنه يرى أنه “إذا كان أهل الحق في عصابة يمكنهم الدفع ولا ييأسون من الظفر ففرض عليهم ذلك وإذا كانوا في عدد لا يرجون لقلتهم وضعفهم بظفر كانوا في سعة من ترك التغيير باليد وهذا قول على بن أبى طالب رضى الله عنه وكل من معه من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين وهو قول عبد الله بن الزبير ومحمد والحسن بن على وبقية الصحابة من المهاجرين والأنصار القائمين يوم الحرة رضى الله عن جميعهم أجمعين”. (41)
ولكننا نجد أن ابن حزم في موضع آخر يصرح بوجوب الخروج على الحاكم إذا لم يُقِم حدود الله تعالى ووالى أعداء الله من اليهود والنصارى وكُلِّم في ذلك فلم يرجع ولم يرتدع فهنا يجب خلعه وإقامة غيره مكانه ، وذلك واضحٌ بيَنَه في قوله رحمه الله “والواجب إن وقع شيء من الجور وإن قل أن يُكلَّم الإمام في ذلك ويُمنع منه فإن امتنع وراجع الحق وأذعن للقود من البشرة أو من الأعضاء ولإقامة حد الزنا والقذف والخمر عليه فلا سبيل إلى خلعه وهو إمام كما كان لا يحل خلعه، فإن امتنع عن إنفاذ شيء من هذه الواجبات عليه ولم يراجع وجب خلعه وإقامة غيره ممن يقوم بالحق لقوله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) (سورة آل عمران) ولا يجوز تضييع شيء من واجبات الشرع”. (42)
وهو في سبيل رده على الذين يقولون بعدم جواز الخروج على الحاكم ما لم يكفر كفراً بواحاً أو يترك إقامة الصلاة يورد مثالاً صارخاً ليدلل به على مدى تهافت هذا الرأي من وجهة نظره فيقول “ويقال لهم ما تقولون في سلطان جعل اليهود أصحاب أمره والنصارى جنده وألزم المسلمين الجزية وحمل السيف على أطفال المسلمين وأباح المسلمات للزنا وحمل السيف على كل من وُجد من المسلمين وملك نساءهم وأطفالهم وأعلن العبث بهم وهو في كل ذلك مُقرٌ بالإسلام مُعلنٌ به لا يدع الصلاة؟! فإن قالوا: لا يجوز القيام عليه، قيل لهم: إنه لا يدع مسلماً إلا قتله جملة وهذا إن ترك أوجب ضرورة ألا يبقى إلا هو وحده وأهل الكفر معه، فإن أجازوا الصبر على هذا خالفوا الإسلام جملة وانسلخوا منه، وإن قالوا: بل يقام عليه ويقاتل وهو قولهم- قلنا لهم: فإن قتل تسعة أعشار المسلمين أو جميعهم إلا واحداً منهم وسبى من نسائهم كذلك وأخذ من أموالهم كذلك؟! فإن منعوا من القيام عليه تناقضوا وإن أوجبوا سألناهم عن أقل من ذلك ولا نزال نحيطهم إلى أن نقف بهم على قتل مسلم واحد أو على امرأة واحدة أو على أخذ مال أو على انتهاك بشرة بظلم، فإن فرقوا بين شيء من ذلك تناقضوا وتحكموا بلا دليل وهذا ما لا يجوز وإن أوجبوا إنكار كل ذلك رجعوا إلى الحق ونسألهم عمن غصب سلطانه الجائر الفاجر زوجته وابنته وابنه ليفسق بهم أو ليفسق به بنفسه أهو في سعة من إسلام نفسه وامرأته وولده وابنته للفاحشة أم فرض عليه أن يدفع من أراد ذلك منهم فإن قالوا: فرض عليه إسلام نفسه وأهله أتوا بعظيمة لا يقولها مسلم وإن قالوا: بل فرض عليه أن يمتنع من ذلك ويقاتل رجعوا إلى الحق ولزم ذلك كل مسلم في كل مسلم وفى المال كذلك”. (43) وهكذا ينتهى ابن حزم إلى وجوب الإنكار على هذا الحاكم الذى يبلغ به الظلم وانتهاك حرمات المسلمين مداه وإن أظهر أنه مسلم وأقام الصلاة، بل ينتهى ابن حزم إلى عدم جواز الصبر ووجوب التصدي للدفاع عن الأهل والمال.
ويرد ابن حزم على الأدلة التي يسوقها القائلون بالصبر على جور الحكام ما داموا مسلمين مصلين بقوله “احتجت الطائفة المذكورة أولاً- وهم القائلون بالصبر وبأن النهى عن المنكر لا يكون على الحكام إلا باللسان والقلب – بأحاديث فيها: أنقاتلهم يا رسول الله؟ قال: لا ما صلّوا، وفى بعضها إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان وفى بعضها وجوب الصبر وإن ضرب ظهر أحدنا وأخذ ماله” إلى غير ذلك من الأدلة التي يردها ثم ينبري للرد عليها قائلاً ” كل هذا لا حجة فيه…أما أمره صلى الله عليه وسلم بالصبر على أخذ المال وضرب الظهر فإنما ذلك بلا شك إذا تولى الإمام ذلك بحق (44) وهذا ما لا شك في أنه فرض علينا الصبر له وإن امتنع من ذلك بل من ضرب رقبته إن وجب عليه فهو فاسق عاصٍ لله تعالى؛ وأما إن كان ذلك بباطلٍ فمعاذ الله أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر على ذلك ، برهان هذا قول الله عز وجل (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)”. (45)
“فإذا كان هذا كذلك فيقين لا شك فيه يدري كل مسلم أن أخذ مال مسلم أو ذمي بغير حق وضرب ظهره بغير حق إثم وعدوان وحرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم فإذ لا شك في هذا ولا اختلاف من أحد من المسلمين، فالمُسَلِّم ماله للأخذ ظلماَ وظهره للضرب ظلماً وهو يقدر على الامتناع من ذلك بأي وجه أمكنه معاونٌ لظالمه على الإثم والعدوان وهذا حرام بنص القرآن”. (46) هكذا ينتهي ابن حزم إلى أن السكوت على أخذ المال وضرب الظهر ليس صبراً محموداً على جور الحاكم وإنما هو معاونة على الإثم والعدوان يأثم به فاعله إذا كان قادراً على الامتناع منه. ويستطرد ابن حزم في الرد على سائر أدلة القائلين بالصبر ومنها الاستشهاد بقصة ابني آدم ومدح الله المقتول القائل لأخيه “لئن بسطتَ إلىَّ يدَكَ لتقتلني ما أنا بباسط يَدِىَ إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك” (المائدة، 28)، وكذا الأحاديث الآمرة بأن “كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل”.
يَرُدُّ ابنُ حزم على ذلك ويسرد أدلة المذهب الآخر الداعي إلى المواجهة والإنكار بقوله “وأما سائر الأحاديث التي ذكرنا وقصة ابنى آدم فلا حجة في شيء منها، أما قصة ابنى آدم فتلك شريعة أخرى غير شريعتنا قال الله عز وجل (لكلٍ جعلنا منكم شرعةً ومنهاجاً)، (47) وأما الأحاديث فقد صح عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده إن استطاع فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ليس وراء ذلك من الإيمان شيء) وصَحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا طاعة في معصية إنما الطاعة في الطاعة وعلى أحدكم السمع والطاعة مالم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة وأنه عليه السلام قال : من قتل دون ماله فهو شهيد والمقتول دون دينه شهيد والمقتول دون مظلمة شهيد وقال عليه السلام:” لَتَأمُرُنَّ بالمعروف ولتَنْهَوُنَّ عن المنكر أو ليعُمَّنَّكُم الله بعذابٍ من عنده”، فكان ظاهر هذه الأخبار معارضاً للأخر فصَحَّ أن إحدى هاتين الجملتين ناسخةٌ للأخرى لا يمكن غير ذلك فوجب النظر في أيهما هو الناسخ فوجدنا تلك الأحاديث التي منها النهى عن القتال موافقة لمعهود الأصل ولما كانت الحال عليه في أول الإسلام بلا شك ، وكانت هذه الأحاديث الأُخر واردة بشريعة زائدة وهى القتال، هذا مما لا شك فيه، فقد صحَّ نسْخُ معنى تلك الأحاديث ورفع حكمها حين نطقه عليه السلام بهذا الآخر بلا شك فمن المحال المحرم أن يؤخذ بالمنسوخ ويترك الناسخ وأن يؤخذ الشك ويترك اليقين”. (48)
ثم يدلل على أن الأخبار التي تأمر بالقتال هي الناسخة بقول الله تعالى (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله) ويُعَقَّبُ قائلاً “لم يختلف مسلمان في أن هذه الآية التي فيها فرض قتال الفئة الباغية محكمة غير منسوخة فَصَحَّ أنها الحاكمة في تلك الأحاديث فما كان موافقاً لهذه الآية فهو الناسخ الثابت وما كان مخالفاً لها فهو المنسوخ المرفوع”. (49) ثم يرد ادعاء من يدعى أن الآية والأحاديث التي فيها أمر بالقتال لا تسري في حق السلطان فيقول “وقد ادعى قوم أن هذه الآية وهذه الأحاديث في اللصوص دون السلطان وهذا باطل متيقن لأنه قول بلا برهان وما يعجز مدع أن يدعى في تلك الأحاديث أنها في قوم دون قوم وفى زمان دون زمان والدعوى دون برهان لا تصح، وتخصيص النصوص بالدعوى لا يجوز” (50) هكذا ينتهي ابن حزم بنصر مذهبه في التصدي لظلم السلطان وجوره وعدم الاستسلام والصبر على الظلم والجور.
وسواء وافقنا ابن حزم في دعوى النسخ التي ادعاها أو خالفناه باعتبار الجمع بين النصوص التي يراها متعارضة ممكناً، فلا يمكننا أن نغفل قوة أدلة ابن حزم وقوة منطقه في الرد على الخصوم؛ وهذا على أية حال أنموذج لرأى فقيه يميل إلى فكرة التصدي للحاكم ومواجهته بالقوة.
وثانيهما: “الخروج إذا وُجدت أسبابه وقوى احتمال نجاحه”. هذا المذهب في الحقيقة لا يبعد كثيراً عن المذهب السابق اللهم إلا في تحديد الظروف التي يكون الخروج فيها في مصلحة الأمة ، فهو كسابقه لا يميل إلى الصبر على جور الحكام لمجرد كونهم مسلمين مصلين كالمذهب الأول ، وإنما يرى أنه إذا قويت احتمالات نجاح “الثورة” في إزاحة نظام ظالم مستبد فيكون الخروج حينئذ مطلوباً من جهة الشارع ؛ والحق أن عدداً غير قليل من فقهاء أهل السنة رجحوا هذا المذهب، فهذا أبو حنيفة رضى الله عنه روى عنه أنه بايع لإبراهيم بن عبد الله بن الحسن وكان إبراهيم قد خرج هو وأخوه محمد بن عبد الله على خلافة العباسيين في عهد أبى جعفر المنصور؛ وإن كان أبو حنيفة لم يخرج مع من خرج إلا أنه روى عنه قوله لمن سأله عن حكم الخروج مع إبراهيم بن الحسن “إنه كالخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم بدر” أما لماذا لم يخرج أبو حنيفة نفسه ؛ فلأن مذهبه في مسألة الخروج يقوم على أنه لا يكون إلا عند رجحان احتمال التغيير وهو ما لم يكن بادياً للأعين في ثورة إبراهيم ومحمد التي قضى عليها أبو جعفر وانتهى الأمر باستشهاد الرجلين رحمهما الله تعالى.
ومذهب أبى حنيفة في هذه المسألة من جواز الثورة على الحاكم الظالم إذا وجد أعواناً وقوة مادية ترجح نجاح الثورة ثابتٌ في أكثر من قول مروي عنه ونقل عنه الجصاص “وكان مذهبه مشهوراً في قتال الظلمة وأئمة الجور، ولذلك قال الأوزاعى احتملنا أبا حنيفة على كل شيء حتى جاءنا بالسيف فلم نحتمله وكان من قوله وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فرضه بالقول فإن لم يؤتمر به فبالسيف”. (51)
أخطاء منهجية في طريقة التفكير والاستدلال
هذا وهناك بجانب هذه الجذور الفكرية للظاهرة بل وقبلها، هناك بعض الأخطاء المنهجية في طريقة التفكير والاستدلال تؤدى بهذه الجماعات إلى أن تنتهي إلى ما تنتهي إليه من أفكار تؤصِّل للعنف ومن ثم تتبناه كوسيلة بل كاستراتيجية للتغيير، وسنتعرض بما يسمح به المقام لبعض هذه الأخطاء المنهجية على أمل أن تخصص لها بحثاً مستقلاً، وسنكتفى هنا بذكر مثالين لهذه الأخطاء المنهجية:
1- الخلط بين التجربة التاريخية والأدلة الشرعية: فمن المتفق عليه بين مدارسنا الفقهية المعتمدة أن أدلة التشريع المعروفة هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ثم هناك أدلة مختلف حولها كالاستحسان والمصالح المرسلة والعرف وشرع من قبلنا …إلى آخر ما هو معلوم في علم الأصول، ما عدا ذلك فلا يصلح دليلاً شرعياً أي مستنداً لحكم شرعي فالدليل هو ما جعله الشارع أمارة على وجود الحكم وعليه فلا يصح اعتبار أي تجربة تاريخية أصلاً من أصول التشريع أو دليلاً من أدلته بحيث يحتج به على شرعية الفعل أو عدم شرعيته، بل إن السيرة النبوية ذاتها ليست دليلاً من أدلة التشريع ما لم يثبت صحة ما بها من أحداث وروايات وفقاً لمعايير “النقد” المعروفة عند أهل الحديث، وفى ذلك يروى عن الإمام أحمد قوله “ثلاث لا يصح فيهن شيء: التفسير والسير والمغازي”، بل إن الفقهاء اختلفوا في بعض أفعال وأقوال النبي الكريم – صلى الله عليه وسلم – خاصةً في أوقات الحروب، هل هي سننٌ تشريعية عامة للأمة أم أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قالها أو فعلها كقائد عسكري فهي حادثة عين مختصة بوقتها وظروفها وليست تشريعاً للأمة؛ مثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم “من قتل قتيلاً فله سلَبه” (52) وقوله “من أحيا أرضاً مواتاً فهي له”؛ (53) وإذا كان ذلك مع بعض أفعال وأقوال النبي الكريم الذى أجمعت الأمة على أن سُنتَّه الأصلُ الثاني للتشريع فكيف بأفعال وأقوال من هو عرضة للخطأ والصواب والالتزام بالجادة أو اتباع الهوى؟! نقول هذا لأننا نجد أغلب الجماعات التي تؤصل للعنف كوسيلة معتمدة للتغيير ترتكن إلى وقائع تاريخية وقعت في الدولة الإسلامية منذ الخلافة الراشدة وحتى سقوط الخلافة غير منتبهين إلى:
أولاً: لعدم حُجِّية هذه السوابق التاريخية كدليل شرعي يرتكن إليه.
وثانياً: لأن الحدث التاريخي حدث مُركَّب وليس “بسيطاً” ينتج عن عشرات الأسباب والدوافع وهو بلا شك رهن بالظرف التاريخي الذي وجد فيه وبالمؤثرات السياسية والاجتماعية والأنثروبولوجية والنفسية التي تسببت فيه.
وإسقاط الماضي على الحاضر ومحاولة استنساخ هذا الماضي أمرٌ محكوم عليه بالفشل لأنه ضد نواميس الكون التي خلقها الله وضد سنن التغيير المجتمعية وهذا – للأسف – أحد أبرز أمراض الأمة عامة والإسلاميين خاصة. فالتماهي مع الماضي والتأسف عليه والتباهي به والفشل الواضح في التعامل مع قضايا العصر، الأمر الذي انتهى بالأمة إلى ما انتهى إليه؛ وهذه ليست دعوة للقنوط ولكنها ضرب من نقد الذات التي أمرنا به النبي الكريم “الكيِّس من دان نفسه”. (54)
2- بناء يقينيات على ظنيات: عندما نفترض افتراضاً ثم نقيم عليه مجموعة من الاستنتاجات فهذا يمكن الحكم عليه من ناحيتين:
الأولى: من جهة كونه بناءً منطقياً خاصاً بهذا الفرض فقط ومن ثم يكون صحيحاً أو خاطئاً في ضوء تماسك هذا البناء لكنه لا يعنى عدم وجود أبنية أخرى أقيمت على فرضيات أخرى، ولعل أبرز الأمثلة العملية على هذا: هندسة إقليدس والهندسات الأخرى التي يعرفها أهل التخصص في علم “الطوبولوجى” ولكن هذا البناء المنطقي بالطبع لا دخل له بالأحكام الشرعية إلا من حيث كونه علماً نافعاً فحسب فيأخذ حكم طلب العلم الذي أمرنا به الشارع.
الثانية: أنه يجب أولاً أن نختبر هذا الفرض ومدى صحته فإن ثبتت صحته يقيناً شرعنا في التفريع عليه والاستنتاج منه ، وهذا الاستنتاج بدوره يخضع للصحة والخطأ في ضوء مدى التسلسل المنطقي وإن كان هذا الفرض صحيحاً ولكن بشكل ظني لا يقيني فكذلك تكون الاستنتاجات صحيحة ظنياً وليس يقينياً، أما إذا ثبت خطأ الفرض فإن كل ما يترتب عليه يأخذ حكمه ومنه كانت المقولة الفقهية والقانونية “ما بُنِىَ على باطل فهو باطل”؛ وبالرجوع لأدبيات جماعات العنف المسلح نجد أنهم يقعون كثيراً في هذا الخطأ، فيوردون قاعدة هي في أفضل الأحوال محل اختلاف وليست محل إجماع ومن ثم فالتفريع عليها سيكون كذلك بل لعله أوهى منها، لكنهم يفترضون صحتها يقيناً ثم يقيمون عليها بنياناً من الاستنتاجات فإذا به قد أقيم على جُرُفٍ هارٍ، وأمثلة ذلك كثيرة منها:
القول برِدَّة الحكام الذين لا يحكمون بالشريعة الغرَّاء ثم التفريع على ذلك برِدّة المجتمعات لأنها قبلت بذلك وسكتت عليه ومن رضى بالكفر فهو كافر “فالرضا بالكفر كفر” وهاهنا أخطاء متراكمة بعضها فوق بعض؛ الخطأ الأول والذى اعتُبر بمثابة القاعدة التي بنى عليها البنيان هو القول بكفر الحكام الذين لا يحكمون الشريعة أي يحكمون دولاً تستقى قوانينها من تشريعات وضعية؛ ونود ابتداءً أن نُبيِّن أن كون الإسلام عقيدة وشريعة هو مما أجمعت عليه الأمة وجاء به الكتاب والسنة قال تعالى:” وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم” (المائدة:49) وقال:” وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله” (الشورى:10) وقال: “فإن تنازعتم في شيء فرُدُّوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر” (النساء:59) والأمر أوضح من أن يُستدل عليه وقد عاشت الأمة الإسلامية أكثر من ألف عام لا تعرف مصدراً للأحكام والقوانين سوى الإسلام، وتبلورت المذاهب الفقهية العديدة على أساس فهم الكتاب والسنة وإعمال القياس والأخذ بالإجماع إلى غير ذلك من أدلة الشرع، ولا شك أيضاً أن ترك الأمة للإسلام كمصدر للتشريع وركونها إلى قوانين مستوردة مثَّل انحرافاً عن الإسلام من جهة وطمساً لمعلم من أهم المعالم التي قامت عليها حضارة الأمة من جهة أخرى.
لكنَّ هذا شيء والقولَ بكفر كل حاكم أو رئيس يحكم دولة لا تحتكم لأحكام الشريعة شيء آخرُ، ولبيان ذلك يلزمنا أن نقف مع أهم أدلة القائلين بكفر هذا الصنف من الحكام وهو قول الله تعالى: “ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون”؛ وقد يتصور البعض أن الآية واضحة الدلالة في الحكم على هذا الصنف من الحكام بالكفر بيد أن الأمر ليس كذلك؛ ولبيان هذا يلزمنا أن نؤسس لأن الإيمان والكفر في الأصل مسائل اعتقادية وليست عملية ما لم تكن الأعمال واضحة الدلالة في نقض هذا الإيمان كمن يسب الله أو رسوله أو يستهزئ بالقرآن أو بأحكامه، ولكن في الجملة الإيمان مسألة اعتقادية والكفر هو نقض لأحد أصول الإيمان وهو أيضاً مسألة اعتقادية، وإذا كان ذلك فماذا عن هذه الآية الصريحة؟ الحق أنه طبقاً لما أسَّسْنَاه فإن جمهور المفسرين والعلماء ذهبوا إلى أن الكفر هاهنا ليس كفر اعتقاد أو أنه ليس خاصاً بالمسلمين، فمن ذلك:
يقول ابن كثير في تفسيره للآية: وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس قوله “ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون” قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر ومن أقرَّ به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق رواه ابن جرير ثم اختار أن الآية المراد بها أهل الكتاب أو من جحد حكم الله المنزل في الكتاب.
وهكذا تتوالى الأخطاء المنهجية والاستدلالية، وما أسلفناه مجرد أمثلة لهذه الأخطاء المنهجية تبين أن الحاجة إلى إصلاح منهج التفكير والاستدلال هو الأساس الذي يجب أن يبني عليه التصدي لهذه الأفكار المغلوطة وما يترتب عليها من أفعال منحرفة عن جادة الصواب.
وبعد استعراض مذاهب الفقهاء في مسألة الخروج على الحاكم وبإنزال ذلك على الواقع المعيش يمكننا الإشارة للملاحظات التالية:
1- أن مسألة تداول السُلطة مثَّلت “إشكالية” كبيرة في تاريخ الأمة الإسلامية سالت فيها الدماء المُسلمة أنهاراً، وآلية التداول السلمي الديموقراطي لم تدم سوى سنوات قلائل حتى حلت محلها آلية الحاكم المتغلب والتداول الوراثي في عائلة بعينها، فكانت عروة الحكم – كما ورد بالحديث – أولَ ما نُقض من عُرى الإسلام.
2- أن الفقهاء الذين ذهبوا لعدم جواز الخروج على الحاكم إنما قصدوا بذلك الخروجَ بالقوة أو “بالسيف” على حد تعبيرهم، أما المعارضة والتوجيه بل والتصدي لما يرونه جوراً وظلماً، فهو من أوجب الواجبات على الأمة عامةً وعلى نُخبتها أو علمائها خاصة.
3- أن سُبُل الجهاد السلمي في الدولة المعاصرة سُبُلٌ عديدة وفيها من أوجه الجهاد والتغيير ما يمكن لو أحسن التخطيط والتوجيه أن يغير النظام بغير إهدار لدماء المسلمين ومصالحهم؛ ولعل في تجربة ما عُرف بثورات الربيع العربي مع ما اعتراها من عقبات و”ثورات مضادة” ما يدل على أن إمكانية تغيير الأنظمة لا تقف عند “الانقلابات العسكرية” أو “التغيير الفوقي” وإنما يمكن لحركة جماهيرية حاشدة أن تجبر الحاكم على الانصياع لرغبة الجماهير.
4- أن الدولة القومية المعاصرة تحكمها مؤسسات وتنظيمات “Organizations” حتى وإن بدا في السطح أن حُكَّامها مجردُ أشخاصٍ مستبدين، فمع هذا المستبد والديكتاتور مؤسسة و”دولة عميقة” تحميه وتحتمى به في الوقت ذاته، وعليه فإن “الجهاد المؤسسي” هو القادر على إحداث التغيير، والمسألة ليست مجرد تغيير حاكم شخص بل شبكة معقدة من العلاقات والمصالح تجمعها مؤسسة وتنظيم.
ولعَلَّ فيما أصاب ثورات الربيع العربي من انتكاسات ما يجعل من إعادة النظر في آلية المعارضة ومواجهة الأنظمة الحاكمة المستبدة واجب الوقت وفريضة الحال، والسعيد من اتَّعظ بغيره فما باله لا يتعظ بنفسه، والمؤمن لا يُلدغ من الجحر مرتين ونأمل ألا يموت في جحره.
ثالثا: التربية وأثرها كفلسفة ونظام على ظاهرة العنف
لا يصح التعرض للظاهرة دون التعرض للتربية وأثر ذلك على تنامى ظاهرة العنف لأن هذا يحول بيننا وبين فهم جذور الظاهرة فبالإضافة لكون التربية تتأثر بالقيم السائدة في المجتمع وتؤثر فيها بما لا مجال للتشكيك فيه أو لتجاوزه، إذ العلاقة بين التربية والمجتمع بقيمه ومفاهيمه وأعرافه ونظمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية هي علاقة تأثير وتأثُّر (التربية ↔ المجتمع). بالإضافة لذلك فإن تنامى هذه الظاهرة بصفة خاصة يحتاج إلى وقفة لأن الفلسفة التي تقوم عليها التربية في مجتمعنا من أشد المؤثرات على هذه الظاهرة، فالقيم التربوية السائدة هي المسئول الأول عن إفراز عقلية ترفض الحوار وترى الاختلاف خطيئة وتعتقد أن الحق هو ما انتهت إليه دون سواه وتنظر للأمور نظرة أحادية.
إن التربية هي المسئول الأول عن هذه العقليات الجامدة والمنغلقة وغير القادرة على أن تكون نظرتها للأمور أكثر تركيباً وتعقيداً. والحق أن نظرةً عُجْلى للتربية في مؤسساتنا التربوية مدرسة كانت أو جامعة أو أسرة ستزيل تماماً أي علامات استفهام عن استفحال ظاهرة العنف لأن انتظار غير ذلك من التربية السائدة في هذه المؤسسات يعتبر ضرباً من العبث، وانتظار نتائج من غير مقدماتها، و(من زرع الحنظل لا يرتجى…أن يجتنى السكر من غرسه).
وبعيداً عن مشكلات التعليم التي لا تخفى على بصير من حيث الكم والكيف حيث بلغت نسبة التسرب حسبما يذكر تقرير (استراتيجية تطوير التعليم في مصر 1987م) من 20% إلى 25% بينما تشير تقارير البنك الدولي إلى أنها تقدر ب 36%؛ أما عن مهارات القراءة والكتابة والحساب فإن نسبة كبيرة من خريجي المدرسة الابتدائية يفتقدونها بشكل كبير، ومؤخراً (2014 م) كان ترتيب مصر بالنسبة للتعليم الأساسي 148 وذلك ضمن 148 دولة خضعت للبحث، وبالنسبة للتعليم العام جاء ترتيبها 139 من 140 دولة خضعت للبحث. بعيداً عن هذه المشكلات التي لا تخفى على أحد فإن الاتجاهات والقيم التي يعمل نظامنا التعليمي على تأصيلها في العقول أبعد ما تكون عن الديموقراطية والحوار وقبول الآخر. أما المهارات التي تعمل على إكسابها للمتعلم فهي أيضاً أبعد ما تكون عن التحليل أو التفسير أو النقد أو التركيب أو التقويم.
إن نظامنا التعليمي لا يزال يتعامل مع العقل البشرى بمفهوم متخلف –على أنه صفحة بيضاء وأن وظيفة التعليم تخزين أكبر قدر من المعلومات على هذه الصفحة البيضاء؛ إنه نظام يعمد إلى تكوين بناء تراكمي من المعلومات دون اهتمام يذكر بالنسق الكلى الذي يتم تركيب هذه المعلومات بداخله.
وبغض النظر عن مدى أهمية هذه المعلومات ودقتها بعد عدد من السنوات فإن افتقار الرؤية الكلية يجعل العقل الإنساني غير قادر على التعامل مع ما يعرض له. إنه فحسب سيجتهد ما وسعه الاجتهاد لكي يقوم بدور الحاسب الآلي في تخزين المعلومات واستدعائها، وسيفتقد نعمة الله الكبرى عليه وهي بالطبع ليست التخزين وإنما التحليل والتركيب في إطار نظرة كلية وتصور شامل.
ونتيجة العملية التعليمية في بلادنا واضحة بينة إذ برغم العبء الضخم على المتعلم وبرغم الكم الهائل الذى يحصله من المعلومات فإنه لا يخرج بمنهج تفكير ولا بقدرة على التحليل والتركيب ولا بمهارة الحوار والمناقشة؛ وأنَى له ان يخرج بذلك من تعليم لا يعتمد إلا التلقين وسيلة مُثلَى وأنَى لمعلم يعتمد الحوار والمناقشة وهو نفسه يفتقد القدرة على الحوار والمناقشة، وهو نفسه نتاج هذا التعليم التلقيني التخزين التراكمي الذى يفرز عقليات إذا اختلفت معها عجزت عن استيعاب الخلاف وإذا حاورتها افتقدت أهلية الجدال وإذا وصلتها معلومات جديدة رصَتها رصَاَ بجانب كم المعلومات الهائل المختزن بداخلها.
ولا يمكن لنظامٍ كهذا إلا أن يفرز شخصيات سمتها “التعصب” ووسيلتها العنف ومنطقها التصدي للآخر ومحاربته لا قبوله بله التعاون معه؛ ولا يعتقد أن الأنظمة الحاكمة في عالمنا العربي يمكن أن تساهم بأي دور في إعادة النظر في فلسفتنا التربوية وقيمنا التعليمية لأنها من البداية لا تريد مواطناً يؤمن بقيمة الديموقراطية والحوار، فمثل هذا المواطن بعينه هو الخطر الأكبر على وجودها واستقرارها؛ إنها أنظمة تحرس التخلف وترعى التعصب والتقليد وتسقى بذور العنف من ماء استبدادها كل يوم وإن زعمت – كذباً- أنها تواجهه.
إن نقطة البداية الصحيحة لمواجهة “ظاهرة العنف” هي إعادة النظر في نظامنا التعليمي وفلسفتنا التربوية ليكون إفراز هذا النظام شخصية قادرة على الحوار والمناقشة بقوة المنطق لا بمنطق القوة ، وعلى قبول الآخر والتعايش معه بل والتعاون في غير مواطن الخلاف، وكل هذا لا يتأتى إلا من خلال تبنى قيم الديموقراطية في فلسفتنا التربوية في عالمنا العربي، فالشخصية المستقلة الحرة هي وحدها القادرة على البناء ومواجهة التحديات أما الذى يشعر بأنه عبد فإنه حتماً سيطلب من الآخرين أن يكونوا كذلك وهو في النهاية أبعد ما يكون عن القدرة على مواجهة التحديات لأن روح الإبداع قد قتلت بداخله.
إن التربية هي نقطة البداية وأي منهج إصلاحي يغفل أو يتغافل هذا فلا يمكن أن يكتب له النجاح؛ وإذا كان نظامنا التربوي لا يسمح بتخريج شخصيات ناقدة متبنية للحوار قادرة على التعامل مع الآخر فإن التربية السائدة داخل الجماعات الإسلامية كما سنرى تكمل منظومة التخلف وتساهم بدور عظيم في إفراز عقليات جامدة ترفض الآخر وتؤثر التعامل معه بمنطق “الإلغاء” الذي يتراوح بين التكفير والتعالي من الناحية النظرية وبين الإهمال والمصادرة – عند القدرة عليها- والتصدي من الناحية العملية وهو ما سنعرض له في النقطة التالية.
التربية داخل الجماعات الإسلامية وتأثير ذلك على ظاهرة العنف
في اعتقاد الباحث أن التربية السائدة داخل الجماعات الإسلامية من أهم أسباب شيوع ظاهرة العنف في العمل الإسلامي؛ وإنصافاً نقول إنه إذا كان المجتمع في صورة مؤسساته التربوية لا يعمل على تأصيل قيم الحرية والديموقراطية وحق الاختلاف واحترام الرأي الآخر، فإن الجماعات الإسلامية والتي هي جزء من نسيج المجتمع وإفراز من إفرازاته سارت على نفس النهج وتبنت نفس القيم التربوية التي تبنتها المؤسسات التربوية في المجتمع وإن كانت قد غلفتها بإطار شرعي فقهي. ولذا لم يكن غريباً ولا مستغرباً أن يكون التركيز في هذه الجماعات على تأصيل مفاهيم مثل: الطاعة والجندية والثقة، وذلك على حساب مفاهيم أخرى كالشورى واحترام الآخر وكالحرية وحق المعارضة والتقويم.
وإذا كانت أغلب الجماعات الإسلامية ليس لها تراث نظري مكتوب يتضح منه منهاجها التربوي ويمكن الحكم عليه من خلاله فإن بعض هذه الجماعات لها مثل هذا التراث كالإخوان المسلمين، والبعض الآخر وإن لم يكن لها إنتاج تربوي متخصص فيمكن استخراج قيمها التربوية من خلال أدبياتها الأخرى.
وبالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين فلدينا نموذج تربوي واضح بينته الجماعة وعملت على تربية الأفراد عليه وقد أتيح لها ذلك ومن ثم فنحن أمام فكر تربوي وتطبيقات لهذا الفكر؛ ولو أن الموضوع يحتاج إلى مبحث منفصل إلا أننا سنركز على الجزئية التي تفيدنا في بحثنا وهي مدى تأثير التربية الإخوانية على ظاهرة العنف في العمل الإسلامي. وفي هذا الإطار سنلاحظ أن التربية عند الإخوان المسلمين قد أولت اهتماماً كبيراً لقيم السمع والطاعة والجندية والثقة على حين لم نجد اهتماماً مشابهاً لتأصيل قيم حرية المعارضة ووجوب الشورى.
وقد جاءت التربية عند الإخوان مزيجاً من التربية الصوفية والتربية العسكرية ونحن نعرف مدي ما يتصف به كل منهما من تركيز شديد على مسألة السمع والطاعة.
فعند المتصوفة المريد بين يدي الشيخ كالميت بين يدي مُغَسِّلِه له أن يفعل به ما يشاء دون اعتراض يذكر لأن الاعتراض من المريد هنا قلة أدب مع شيخه وسيحول بينه وبين الترقي في درجات الوصول. أما التربية العسكرية – لا سيما في بلادنا – فمعلوم مدى ما يلزم الجندي فيها من طاعة لقائده ولو رأى في أمره الخطأ كل الخطأ فواجب عليه أن يطيع أولاً، لأن عدم الطاعة هنا قد يدخل في مصاف الجرائم الكبرى.
وحول هذين المحورين (التصوف والعسكرة) وصف الشيخ حسن البنَّا رحمه الله التربية في مرحلة “التكوين” وهي مرحلة التربية الحقيقية داخل الجماعة، فقال في رسالة التعاليم تلك التي وجهها في البداية إلى “الإخوان المجاهدين من الإخوان المسلمين”: إن “نظام الدعوة في هذه المرحلة: صوفي بحت من الناحية الروحية وعسكري بحت من الناحية العملية” (55)
ولا شك أن التركيز على مسألة السمع والطاعة واضحة بينة وقد أعاد البنَّا التركيز عليها بصورة أكثر وكأنه لم يكتف بوصف المرحلة بأنها مزجت بين الصوفية والعسكرية فقال: “وشعار هاتين الناحيتين دائماً (أمر وطاعة) من غير تردد ولا مراجعة ولا شك ولا حرج” (56) وأعتقد أن عبارة مثل من غير تردد ولا مراجعة …ليست في حاجة إلى بيان مدى ما تورثه في شخصية الفرد من تبعية شديدة للمربى تمنعه حتى من مراجعته إذ يعتبر ذلك خروجاَ عن حدود الأدب أو عدم ثقة بالمربَى. تلك الثقة التي وصفها حسن البنَّا –رحمه الله- فقال: “والثقة بالقيادة هي كل شيء في نجاح الدعوات” (57)
وفى مقابل هذا الإفراط في الحديث عن الطاعة وعن حقوق القيادة لم نجد اهتماماً ذا بال بتربية الأفراد على الحوار وتنمية ملكة المحاورة – دون تشنج أو عصبية – لديهم. و مع أنه يفترض في صاحب الدعوة أن يكون من أهم صفاته قدرته على محاورة الآخر ومجادلته دونما تعسف أو تسفيه؛ لم نجد اهتماماً ذا بال بتنمية قيمة الحرية وحق الاختلاف، ولا يخفى أن تبنى هذه التربية الصوفية العسكرية كان له أسوأ الأثر في بعض مراحل الجماعة لا سيما بعد أن بلغ “الجهاز الخاص” مرحلة من القوة جعلت قيادته بكل ما منحته من حقوقٍ أصَّلها الشيخ حسن البنَّا – كما أسلفنا – تنفرد باتخاذ القرار – وما كان أخطرها من قرارات – والأفراد أو لنقل الجنود، هؤلاء الجنود الذين تربوا على السمع والطاعة بغير تردد ولا مراجعة كانوا سراع الاستجابة لأوامر القيادة حتى وإن كانت بقتل وحتى إذا كان المقتول هو أحد أفراد الإخوان كما في حادث مقتل المهندس سيد فايز وحتى وإن استنكر الشيخ البنَّا – حال حياته- هذه الأحداث فالأفراد قد تربوا على الطاعة بغير مراجعة وهى تربية تمحق شخصية الفرد وتلغى ذاتيته ونعتقد أنها أبعد ما تكون عن التربية الإسلامية الصحيحة التي تغرس في النفوس أن العصمة للوحى فحسب وأن مراجعة القائد قد لا تقف عند حد المباح لكنها ترتفع لتبلغ درجة الواجب.
إن هذا النَّمط من أنماط التربية والذى ساد – للأسف- شتَّى التجمعات الإسلامية قد جرَ على الظاهرة الإسلامية ويلاتٍ كثيرةً وحمَّلَها متاعب جمة بل ولعله تسبب في تأخر تقدم مسيرة الحركة الإسلامية المعاصرة والتي كان المرجو فيها أن تعالج الأمراض التي فتكت بالعقلية الإسلامية قروناً عديدة والأفكار التي ما فتأت تؤصل معاني التقليد والطاعة المطلقة للحاكم وللشيخ وللمجتهد فتجمد العقل المسلم بعد أن ذهب وهج إبداعه وعطائه في قرونه الأولى لأن العقلية التي لا تحسن إلا الطاعة والانقياد وتفتقد معانى الحرية والمحاورة هي أبعد ما تكون عن القدرة على الإبداع والابتكار والتجديد، ونحن أبناء رسالة سبب خلودها ما منحه الله لها –في صورة علمائها- من حق الاجتهاد والتجديد في الشريعة الغرَاء.
وهذه العقليات والشخصيات التي تأصلت فيها معاني التبعية والانقياد ستكون بالطبع عاجزة عن إحداث التغيير الذي تنشده الأمة وتنشده أيضاً الحركة الإسلامية ممثلة في جماعاتها العاملة في الساحة. ولعله مما لم تدركه الحركة بشكل صحيح أن استلاب شخصيات الأفراد يتناقض تماماً مع ما تزعمه من كون رسالتها إحياء الأمة وإنهاضها وبث روح العزة والكرامة فيها.
لا نرى اختلافاً يذكر بين طاعة الحاكم هذه الطاعة المطلقة وبين طاعة أمير جماعة أو مسئول تنظيم بغير مراجعة ولا تردد؛ إن المنطق واحد في الأمرين وهو الثقة المطلقة في هذا المسئول والتي يترتب عليها شئنا أو أبينا أن الفرد سيجمد عقله ويريحه من التفكير ولماذا التفكير والجهد وهناك من هو أكثر منه علماً وفهماً وإدراكاً وهو يقوم عنه بهذه المهمة وليس من باب الثقة الاعتراض عليه ومراجعته كثيراً أو قليلاً.
وانظر في سؤال يوجهه الشيخ حسن البنا رحمه الله للفرد يختبر به مدى ثقته بقائده فيقول إن الأخ الصادق يجب أن يسأل نفسه هذه الأسئلة ليتعرف مدى ثقته بقيادته، ومن هذه الأسئلة: هل هو مستعد لاعتبار الأوامر التي تصدر إليه من القيادة –في غير معصية طبعاً- قاطعة لا مجال فيها للجدل ولا للتردد ولا للانتقاص ولا للتحوير؟ (58) وأحسب أن الجملة الاعتراضية “في غير معصية” سوف تتضاءل مع هذا المنطق الذي يفترض في القيادة الكفاية المطلقة والإخلاص فهل سيظن أن قيادة كهذه يمكن ان تأمر بمعصية؟! والذي رأيناه عملياً أن الأفراد عندما أمروا بسفك دماء استجابوا ولا أدرى هل اعتبروا ذلك معصية أم لا؟ ولكن الذي أتيقن منه أن منطق التربية هذا كان ولا بد أن يثمر هذه النتائج.
لست بهذا أقصد تحميل الإخوان كل ما ارتكبته الحركة الإسلامية من خطايا ولكن لا شك أن جماعة الإخوان بما لها من أسبقية تاريخية وثقل دعوى وجماهيري أصَّلت كثيراً من المفاهيم التي أخذت منها الجماعات بعد ذلك وسارت على دربها. وإن كان الأمر في حقيقته يتصل بخلل في تركيب العقلية المسلمة منذ قرون لا يتحمل الإخوان أو غيرهم وزره، وإن كنا جميعاً نشارك في تحمل إثم عدم تصحيح ما اعترى العقل المسلم من كبوات وقعد به عن رسالته الحقيقية في الاجتهاد والتجديد في حدود ما شرعه الله ووضعه من ضوابط وأصول وثوابت. ولكن تبقى الحركة الإسلامية بجماعاتها التي تحتوى عدداً هائلاً من الشباب المسلم المتحمس عليها مسئولية كبيرة تتمثل في إعادة النظر في قيمها التربوية التي تؤصلها في نفوس أفرادها وتكون عليها شخصياتهم ومفاهيمها التربوية كالطاعة والجندية وغيرها من المفاهيم التي تؤثر أكبر الأثر في تكوين العقليات الآلية الجامدة البعيدة كل البعد عن روح الحرية والتجديد والإبداع؛ وإلا فإن الدعوة التي تتبناها الحركة لتغيير المجتمعات والأنظمة ستكون كلاماً في الهواء لأن الإنسان المؤهل للتغيير لم يخرج بعد للوجود ولم تشارك الحركة في إخراجه وليس هناك فرق يذكر بين استبداد الحاكم واستبداد أمير جماعة، فروح الاستبداد وقهر الأشخاص واحدة أيا كانت الأسماء التي تندرج تحتها واللافتات التي تعلق فوقها.
إن العقل المسلم ليس في حاجة إلى من يُذكَّرُه بوجوب الطاعة لأولى الأمر بعد أن عاش قروناً طويلة لا يحسن غيرها وإنما هو في حاجة إلى من يطرق عليه بمطرقة من حديد ساخن ليُذَكِّرَه بأنه إنسان لأنه حر مختار وهذا هو سر تميزه ومناط تكليفه.
وما لم تركز الحركة الإسلامية في منظومتها الفكرية والتربوية على هذه القضية الكلية التي جاء بها الإسلام فلن نستطيع بحال من الأحوال أن نخرج هذه الشعوب من حالة العبودية والاستذلال التي نعيشها منذ قرون. إن الاستعمار – كما يقول مالك بن نبي- هو حالة عقلية تعيشها الأمة قبل أن يكون جيوشاً تحط بأرضها. ولا بد من أن نتخلص من هذه القابلية للاستذلال والاستعباد والقهر وهذا لن يكون أبداً بأن نستبدل بديكتاتورية حاكم ديكتاتورية أمير جماعة أو بطغيان أنظمة علمانية طغيان أنظمة أخرى تنتسب إلى الإسلام.
هذا تحدٍّ كبيرٌ يواجه الحركة ولا مناص من مواجهته وإعادة تقييم جميع المناهج والبرامج والنظم التربوية في ضوء فلسفة تربوية جديدة تقدم الإنسان على ما عداه وتُعلِى قيمة الحرية والمحاورة وحق الاختلاف على الطاعة والجندية والثقة. هذا في تقييمنا المتواضع موطن الداء ومنبع الدواء.
ولعَلّنا بعد هذا الاستعراض السريع للمسألة التربوية وأثرها على تنامى ظاهرة العنف في الحركة الإسلامية نقف عند النقاط التالية:
1- أن فلسفة التربية في مجتمعاتنا العربية تهدف إلى تكوين عقلية ناقلة لا عقلية ناقدة الأمر الذي يسهل معه تطويع الشخصية فتكون قابلةً للانقياد مما يسهل مهمة التجنيد على جماعات العنف.
2- أن المناهج التربوية لا تهدف لتكوين شخصية مستقلة مؤمنة بقيم الحوار والتنوع والاختلاف والإبداع؛ وإنما شخصية أحادية تابعة ليسهل على الأنظمة المستبدة حشدُ الجماهير وتغييبُ وعيِها وهو ما يصب في صالح جماعات العنف.
3- أن السلطوية هي القيمة الحاكمة في المجتمعات العربية وهي قيمة سائدة في المجتمع تنعكس في كل علاقة بين رئيس ومرؤوس مما يكرس صفات الانصياع والاستبداد وهي القيمة الحاكمة في الجماعات المنغلقة عامةً وجماعات العنف خاصةً.
4- أن قيم التربية داخل التنظيمات المختلفة سياسية أو اجتماعية هي نفس القيم السائدة في المجتمع وإن تسربلت أحياناً بلباسٍ وطني وأحياناً بلباسٍ فقهىٍ إسلامي.
5- أن التصدي لجماعات العنف ينبغي أن يتجه إلى السبب والمنبع لا إلى النتيجة وإلى الحل الفكري والسياسي لا إلى الحل الأمني والبوليسي.
6- أن إغلاق أفق التعددية السياسية وسدَّ سُبُل التداول السلمي للسلطة هو من أهم أسباب وروافد وجود جماعات العنف المسلح في المجتمعات العربية.
خاتمة
ويمكننا في آخر بحثنا أن نخرج بالنتائج التالية عسى الله أن ينفع بها:
• أن ظاهرة العنف ليست ظاهرة طارئة على الأمة الإسلامية ولكن لها جذورًا تاريخية وفكرية وفقهية، وأن التصدي لها ومعالجتها يتطلب الفهم الصحيح والعميق لهذه الجذور ومعالجة أسبابها.
• أن الظاهرة – ككل ظاهرة إنسانية- من التركيب والتعقيد بحيث لا يمكن إرجاعها لسبب واحد فكري أو اقتصادي أو نفسي، بل لجملة متشابكة ومركبة من الأسباب. ولهذا فالتصدي لجماعات العنف ينبغي أن يتجه إلى السبب والمنبع لا إلى النتيجة وإلى الحل الفكري والسياسي لا إلى الحل الأمني والبوليسي.
• أن الفهم السطحي وغير العميق والجهل بالفقه الإسلامي من أهم أسباب شيوع الظاهرة وتكرر ظهورها خلافاً لما اعتنقته بعض الأنظمة المستبدة من أن التديُّن هو بذرة التطرف وأن الحل في تجفيف الينابيع.
• أنه كلما ازداد أمر محاربة المظاهر الإسلامية وتجفيف ينابيع التديُّن والدعوة للتغريب، كلما وجد الفكرُ المتطرف وتياراتُ العنف مبرراً قوياً لوجودها وسهولةً في تجنيد الشباب المسلم.
• أن التعمُّق في فهم فقه الجهاد والنهى عن المنكر والتصدي لاستبداد الحُكَام هو السبيلُ الصحيحُ لمواجهة الأفكار المنحرفة وانتهاج سُبُل العنف في التغيير.
• أن المنظومة التربوية في العالم الإسلامي من أهم أسباب شيوع ظاهرة العنف والفكر المنحرف في العالم الإسلامي بما تُكَرِّسُه من قيمٍ تربويةٍ سلبية وتكوين عقلية ناقلة، وشخصية لا تؤمن بالتنوع والتعدد ولا تحترم سُنَّة الاختلاف التي فطر اللهُ الناسَ عليها “ولو شاء ربك لجعل الناس أمةً واحدة” (هود: 118).
• إن إغلاق أفق التعددية السياسية وسدَّ سُبُل التداول السلمي للسلطة هو من أهم أسباب وروافد وجود جماعات العنف المسلح في المجتمعات العربية.
هذا ونسأل الله تعالى الهداية والتوفيق وأن ينفع بما سطَّرنا ويجعله في ميزان حسناتنا، إنه بالإجابة جدير وهو نعم المولى ونعم النصير.
الإحالات
(1) رواه أبو داود بمعناه رقم 2352
(2) انظر: ابن قدامة: المغنى ج8 ص 346,347: القاهرة مكتبة الجمهورية العربية
(3) أبو داود وابن ماجة والترمذي.
(4) أخرجه البزار بلفظ مقارب بإسناد فيه جهالة عن أبى عبيدة بن الجراح.
(5) الغزالي: إحياء علوم الدين، جـ2 صـ 302، القاهرة: عيسى الحلبي د.ت
(6) قال العراقي: رواه البزار عن حديث عمر بن الخطاب؛ الطبراني في الأوسط من حديث أبى هريرة وكلاهما ضعيف وللترمذي من حديث حذيفة نحوه إلا أنه قال أو ليوشكن الله يبعث عليكم عقاباً منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم؛ قال هذا حديث حسن.
(7) ابن قيم الجوزية: إعلام الموقعين عن رب العالمين، جـ3صـ4، القاهرة: مكتبة عبد السلام بن محمد بن شقرون، 1388هـ- 1968م
(8) الغزالي: إحياء علوم الدين جـ2 صـ 320
(9) الغزالي: إحياء علوم الدين جـ2 صـ 320
(10) عوض محمد عوض: موجب الحسبة في الفقه الشرعي، مجلة المسلم المعاصر عدد 51 ،52 سـ 13 صـ26
(11) عوض محمد عوض المرجع السابق صـ 35
(12) أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين جـ2 صـ 320
(13) عوض محمد: موجب الحسبة في الفقه الشرعي صـ 38
(14) عوض محمد: موجب الحسبة في الفقه الشرعي صـ 38
(15) الغزالي: إحياء علوم الدين صـ 320 جـ2
(16) الغزالي: إحياء علوم الدين صـ 320 جـ2
(17) الغزالي: إحياء علوم الدين جـ2 صـ 321
(18) ابن القيم: إعلام الموقعين جـ3 صـ4
(19) ابن القيم: المرجع السابق صـ 4 و5 جـ3
(20) ابن القيم: المرجع السابق صـ 4 و5 جـ3
(21) ابن القيم: المرجع السابق صـ 4 و5 جـ3
(22) الغزالي: إحياء علوم الدين جـ2 صـ309
(23) شرح مسلم جـ2 ص 23.
(24) المرجع السابق جـ2 صـ316
(25) رواه البخاري مختصراً في كتاب الأدب، باب الرفق في الأمر كله.
(26) محمود توفيق محمد سعيد: فقه تغيير المنكر، كتاب الأمة ع41 صـ74 طـ1 1415هـ
(27) الغزالي: إحياء علوم الدين جـ2 صـ 316
(28) الحديث رواه أحمد بسند جيد قاله العراقي في تخريج أحاديث الإحياء.
(29) الغزالي إحياء علوم الدين الجزء الثاني صـ 330
(30) المصدر السابق جـ2 صـ 314
(31) المصدر السابق جـ2 صـ 314
(32) ابن رجب الحنبلي جامع العلوم والحكم صـ 434
(33) محمد توفيق سعيد: فقه تغيير المنكر مرجع سابق صـ 31
(34) محمد توفيق سعيد: فقه تغيير المنكر مرجع سابق صـ 32
(35) رواه البخاري عن عبد الله بن عباس في كتاب الفتنة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدى أموراً تنكرونها ومسلم في الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتنة وفى كل حال تحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة.
(36) رواه البخاري عن عبادة بن الصامت في كتاب الفتنة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدى أمورا تنكرونها
(37) البخاري عن أنس بن مالك في الأحكام باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية وفى الجماعة باب إمامة العبد والمولى وباب إمامة المفتون والمبتدع
(38) مسلم والترمذي والنسائي عن أم الحصين الأحمصية واللفظ لمسلم كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية
(39) غياث الأمم صـ 77
(40) المرجع السابق صـ 79
(41) ابن حزم: “الفِصَل في المِلَل والأهواء والنِّحَل” جـ4 صـ 132 القاهرة: مكتبة السلام العالمية
(42) السابق صـ 135
(43) السابق صـ 135
(44) أي إن كان أخذ ماله وضرب ظهره بحق لاستحقاقه هذه العقوبة.
(45) ابن حزم السابق صـ 133
(46) السابق صـ 133.
(47) ولكن الشاهد ليس في الآية بل في أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبى داود عن سعد بن أبى وقاص قال: قلت يا رسول الله أرأيت إن دخل علىَّ بيتي وبسط يده ليقتلني؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كُن كابن آدم وتَلَى يزيدُ “لئن بسطت إليَّ يدَكَ.. الآية” سُنَن أبى داود حديث رقم 4257
(48) ابن حزم السابق صـ 133، 134
(49) ابن حزم السابق صـ 133، 134
(50) ابن حزم السابق صـ 133، 134
(51) الجصاص أحكام القرآن القاهرة المطبعة البهية 1947 جـ1 صـ 81 وانظر نيفين عبد الخالق: المعارضة في الفكر السياسي الإسلامي، القاهرة مكتبة الملك فيصل الطبعة الأولى ص 391.
(52) رواه الترمذي عن أبى قتاده وقال حسن صحيح.
(53) رواه البخاري في كتاب المزارعة باب من أحيا أرضاً مواتاً.
(54) رواه الترمذي وقال حديث حسن
(55) الرسائل، ص 362.
(56) المرجع السابق، نفس الصفحة.
(57) المرجع السابق، ص 364.
(58) المرجع السابق، نفس الصفحة.